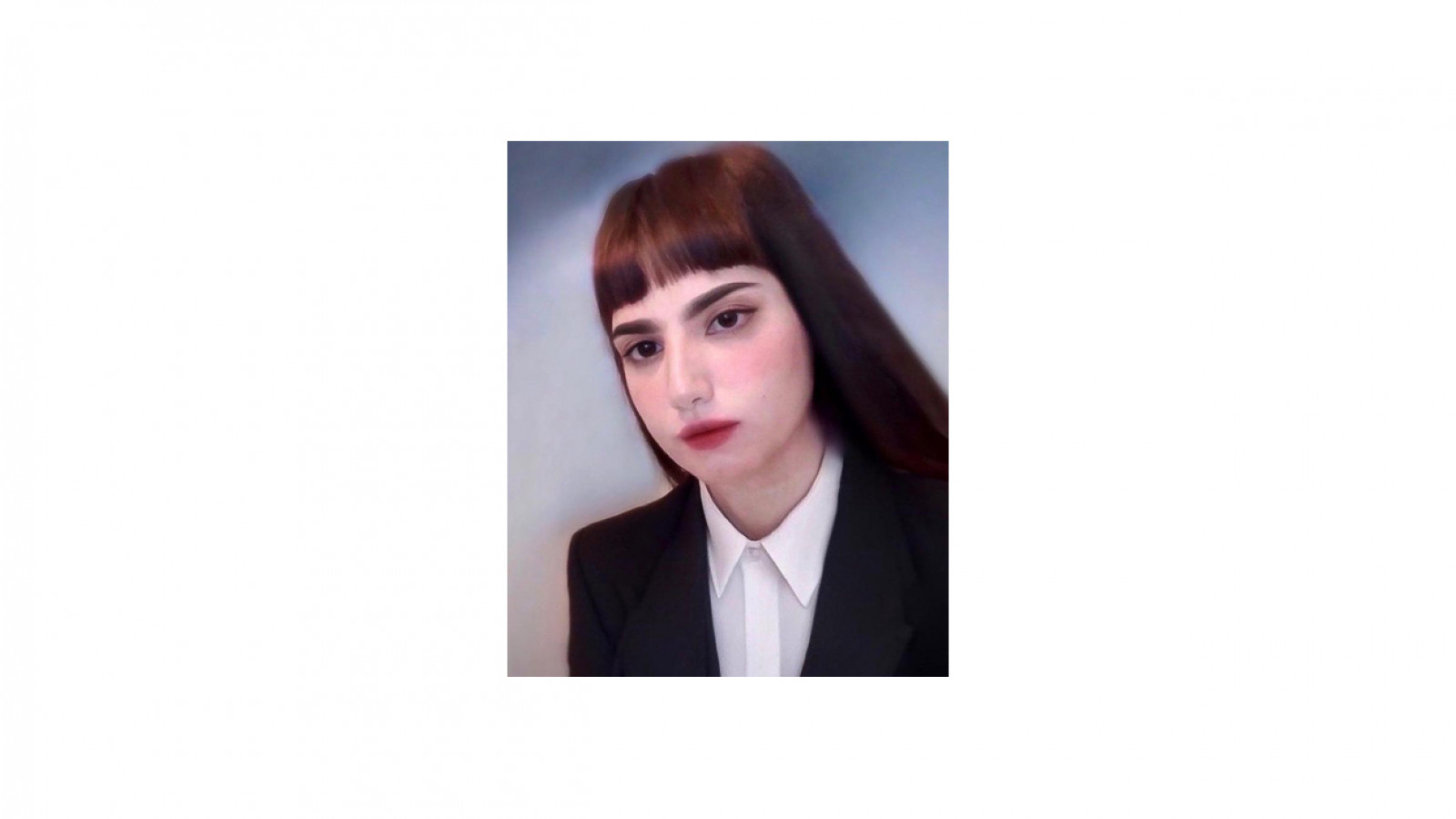
تتقدم هذه الدراسة المصغرة نحو قراءة جدلية للثيوصوفيا المسرحية من داخل المجال الجمالي ذاته من خلال تتبع لحظة انتقال المسرح إلى مستوى أدائي يرتكز على حضور ديني روحي وثقافي فلسفي مكثف داخل مشهد العرض ,تعمل القراءة النقدية هنا على تفكيك هذا التحول من زاوية تركز على طبيعة العلاقة بين الأداء والبعد الروحي ، وعلى الكيفية التي ينتج فيها العرض تأثيراَ ثقافياَ يتجاوز حدود التعبير الأدبي المركز و تتعاظم قيمة التجربة المسرحية حين تتحول الخشبة إلى مجال اجتماع إنساني تتفاعل فيه قيمة الفلسفة الروحية وتتكثف اللحظة المسرحية فيه عبر انتظام وحضور الطاقة الجمعية داخل المشهد الأدائي, فينهض هذا الاتجاه على وعي تاريخي بالمسرح كفعل إنساني سماوي تتداخل فيه الخبرة الطقسية مع الممارسة الأدائية، والذي كان يجعل العرض يكتسب طاقة فكرية تتكون ضمن سياق ثقافي يدفع التجربة نحو مستوى إدراكي أعلى. حين ظهر المسرح الثيوصوفي فهو ظهر في اللحظة التي فقدت فيها الخشبة ثقتها بالحكاية, كان شكل الحدث ليس كافياً و الشخصية تبتعد عن مركز الثقل , فبدأ المسرح يبحث عن صيغة أقدم . صيغة سبقت النص وسبقت الحوار وسبقت حتى التقسيم بين الممثل والمتفرج , وكأن هذه العودة قد لا تتحمل تفسير الحنين اكثر من كونها رداً على مأزق حضاري عاشه المسرح مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حين تحول إلى محاكاة اجتماعية محدودة التأثير. ومن خلال هذا المأزق نشأت الثيوصوفيا المسرحية داخل تاريخ المسرح الحديث نتيجة تحول جذري في فهم وظيفة العرض , وهذا التحول ارتبط بانسحاب المسرح من مركزية الحكاية ,واتجاهه نحو صياغة عرض يعتمد على ايقاع تنظيم الفضاء بتخصيص زمني موجه , لأن المسرح في هذا السياق يزيح مجال التمثيل للأحداث بطريقة متفاوتة , ويوجهها كممارسة فكرية تتعامل مع العرض من خلال تجربة كلية يعيشها الممثل والمتلقي ضمن زمن واحد. شهدت الفترة بين عامي 1970 و1980 حقبة بارزة تميزت بزيادة ملحوظة في الاهتمام بالفلسفة , فقد ظهرت العديد من المذاهب والحركات التي سعت إلى تنوير الناس وغرس منظورٍ معرفيٍ في أذهانهم, حتى أن معتقدات دينية جديدةً نشأت خلال هذه الفترة وأصبح وجود الله والروح، وفلسفة النيرفانا، وحماية الأرض من الكوارث الطبيعية مفاهيم شائعة في تلك الحقبة وبرز في كل بلد راهب او نبي مستعار أو ولي يُقدم مواعظ اخلاقية لإرشاد الناس إلى الصراط المستقيم وإرساء العدل والسلام من خلال منظوره الروحي , ومن خلال هذه الفلسفات والتعاليم أعلن كثيرون أن الهدف الأسمى للفلسفة هو نفع الإنسان, ولا بد لنا من الإقرار بأن للفلسفة قدرةً فائقة على غرس قوة التفكير، وسعة الحيلة وتجديد الأفكار في نفوس الناس, ويؤكد الدور المحوري الذي لعبه الفكر الفلسفي عبر القرون في مختلف ثقافات العالم على أهميته , فقد غيرت أنواع مختلفة من الفلسفات أنماط حياة الناس كلياً، وللأسف باتت هذه الأنماط تُهدد حياة الإنسان أيضاً . من خلال هذه التيارات تأسست جمعية فكرية للثيوصوفيا على يد هيلينا بلافاتسكي وهنري ستيل أولكوت , الشخصيتان التي بدأت كنقطة انطلاق لحركة روحية فلسفية عالمية يُعد فيها تأسيس الجمعية الثيوصوفية عام 1875 لحظة مفصلية في تاريخ الحركات الفكرية الحديثة التي سعت إلى إعادة وصل الإنسان بجذوره الدينية الروحية خارج الأطر الدينية التقليدية , وجاء هذا التأسيس نتيجة التقاء لشخصيتين مختلفتين في الخلفية والوظيفة الفكرية ، حيث تشكل من خلالهما مشروع يجمع بين الرؤية الفلسفية والتنظيم المؤسسي. قدمت بلافاتسكي الإطار الفكري للحركة انطلقت رؤيتها من فكرة وجود حكمة كونية مشتركة تتجلى في الأديان والثقافات عبر العصور واعتبرت أن هذه الحكمة تمثل مسار معرفي يفتح للإنسان إمكانية البحث في طبقات أعمق من الوجود , و جمعت في كتاباتها بين عناصر من التصوف الشرقي والفكر الفلسفي الغربي وطرحت تصورا يقوم على دراسة العالم المنظور والعالم الباطني كمسارين متكاملين لفهم الإنسان والمصير. أما أولكوت فمثل الجانب العملي والتنظيمي داخل المشروع , و جاء من خلفية قانونية وإعلامية اتجه فيه إلى تحويل الرؤية الفكرية إلى مؤسسة ثقافية قائمة لها بنية تنظيمية واضحة وبرنامج تعليمي فكري عمل على نشر أفكار الجمعية، وفتح لها مساراً عالمياً، خصوصاً مع انتقال مركزها إلى الهند حيث ارتبط نشاطها بالحوار بين الثقافات وإحياء الاهتمام بالفلسفات الشرقية في السياق الفكري الحديث. وانطلقت الجمعية الثيوصوفية من ثلاثة مبادئ تأسيسية أساسية ,اولها إرساء فكرة الأخوة الإنسانية العامة والبحث المقارن في الأديان والفلسفات والعلوم، ودراسة القوانين العميقة للطبيعة والوجود الإنساني , ومن خلال هذه المبادئ أخذت الحركة موقعها داخل الفكر الحديث كمشروع يسعى إلى ربط التجربة الروحية بالبحث المعرفي، وإلى إعادة فتح أسئلة خارج الحدود الديوماغئية. بهذا الاجتماع بين الرؤية الفكرية لبلافاتسكي والدور المؤسسي لأولكوت تشكل إطار ثيوصوفي ترك أثره في مجالات متعددة، من الدراسات الدينية المقارنة إلى الحركات الجماعية الثقافية والفنية التي استلهمت رؤيتهما في محاولة قراءة الإنسان والعالم من منظور روحي شامل في هذا السياق، ظهرت أعمال تعاملت مع العرض كفعل جماعي له أصالة رمزية طقسية ,فصار المسرح مجالا تُستدعى فيه أنماط قديمة من التجمع الإنساني وهذا التحول هو ما يمكن تسميته بالثيوصوفيا المسرحية، من خلال رمزية ( المذهب ) بممارسة تُحمل العرض طاقة فكرية تتجاوز الترفيه. هذا الاتجاه ارتبط بمفهوم أساسي داخل النظرية المسرحية الحديثة الذي يتعلق بدور الخشبة , الخشبة كانت منصة سرد وتحولت إلى فضاء يُعاد فيه ترتيب العلاقة بين الإنسان والمشهد والفلسلفة الدينية المذهبية, فلسفة تحررالحركة من النص , فأصبح عنصراً إنشائياً في تكوين العرض و من هذا المنطلق تشكلت الثيوصوفيا المسرحية كمسار يعيد المسرح إلى أصوله الاحتفالية السابقة على الدراما الكلاسيكية,في هذا النوع من المسرح يتحول الممثل إلى عنصر ضمن منظومة حركية وصوتية متكاملة,يكون الأداء يعتمد على التكرار والبطء، وإيقاعه الجسدي وبتنظيم الدخول والخروج من الفضاء , فأصبح هذا الأسلوب يتطلب تدريباً خاصاً يركز على التحكم الجسدي والانضباط الحركي، فركز النقد المسرحي عليه و تعامل مع هذا التحول كقطيعة مع المسرح القائم على الشخصية النفسية واتجاهاً نحو عرض يعتمد على الحضور الجسدي المحسوب. المسار النقدي النظري وجد تطبيقاته العملية للبعد الديني على المسرح , كانت مسرحية مأساة الحلاج للكاتب صلاح عبدالصبور تقدم هذا البعد الروحي كإمتداد بين الذات والوجود على خشبة المسرح وينتظم البنا المسرحي على أساس انفعال ديني يظهر فيه الحلاج كحالة تدخل المجال المسرحي من بوابة التجربة الصوفية تُستعاد فيه عبر الأداء الصوتي الإنشادي الشعري و تعبر من خلال الإشارات الرمزية للفناء والتطهر والتحول الداخلي, فمنح العرض عمقاً فلسفياً يقوم على العلاقة بين المعاناة بين المشاهد الروحية والقوة الأدائية للجسد المنطوق كوسيط بين لغة سماوية ولغة تطهير أرضي . لكن في المسرح الأوروبي نهاية القرن التاسع عشرعند موريس ميترلنك تراجع الفعل الخارجي لصالح مشاهد تقوم على الصمت والانتظار , مسرحيات مثل (الدخيل) و (الزرقاء) تقدم شخصيات محدودة الحركة، حيث يفرض الزمن البطيء نفسه على العرض وتحول الصمت إلى عنصر إنشائي ,فتعامل النقد الأوروبي و قرأ هذه الأعمال ضمن تحول المسرح من الفعل إلى الحالة ومن الصراع إلى الترقب , و تطور هذا المسار النقدي في القرن العشرين لهذا الاتجاه مع أنتونان أرتو الذي قدم تصوراً مسرحياً يعتمد على الصدمة الجسدية والصوتية في مشروعه المسرحي فأصبح العرض حدثاً طقسياً يعتمد على الصراخ والحركة العنيفة، الإضاءة القاسية، وتنظيم الفضاء المسرحي بطريقة تضغط على المتلقي , أرتو تعامل مع نصوص غير تقليدية و تصورات إخراجية أثرت في أجيال من المسرحيين، وقد درست أعماله ضمن بحوث المسرح الطقسي والمسرح الجسدي , وكأن مجيء أنتونان أرتو كان حضور ليكسر ما تبقى من مركزية النص في مشروعه خالياً أدبيًا، و كان هجوما على المسرح كمؤسسة ثقافية فقدت قدرتها على التأثير , ووصف المسرح من خلال وصف (المسرح وقرينه ) يطرح أرتو فيه تصوراً للمسرح يقوم على الصدمة و الضغط ، والانخراط الجسدي الكامل في التجرية الحقيقية , هذا التوجه أبعد لأن يكون نزوة فنية , هو أقرب لمحاولة لاستعادة وظيفة قديمة للعرض حيث يكون المسرح حدثاً يهز الجماعة بقصة تُروى لها من اساسها هي . لاحقاً قدم بيتر بروك نموذجاً تطبيقياً متقدماً لهذا الاتجاه في عرض (المهابهاراتا) العرض اعتمد على ملحمة هندية طويلة، وقدم ضمن فضاءات مفتوحة مع ممثلين من ثقافات متعددة , ركز فيه بروك على الاقتصاد في الديكور وعلى الحركة الجماعية، وعلى الصوت الحي , فتناول النقد المسرحي هذا العمل مثالا على المسرح العابر للثقافات الذي يتحول النص إلى مادة أدائية تخضع لمنطق العرض اكثر من منطق القراءة. تتأثر الحضارة بالمشهد الفكري السلوكي للديموغرافية العميقة للسكان , وهذه الأنماط المختلفة للبقاع البشرية تشكل محاور جديدة كلياً للثيوصوفيا المسرحية , في المسرح الروسي طور فسيفولود مايرهولد هذا المسار عبر نظام( البيوميكانيك) الذي يقوم على ضبط الحركة الجسدية وفق تسلسل دقيق ,هذا النظام حول جسد الممثل إلى أداة عمل دقيقة داخل العرض, و الدراسات المسرحية تناولت هذه التجربة ضمن التحولات الكبرى في الأداء المسرحي الصوفي التعبيري خلال القرن العشرين، خاصة في مقابل المسرح الطبيعي ومحاوره . وفي منظوري القرائي في جماليات المسرح أن احد ابداعات مسرح الثيوصوفيا العميقة كانت ما قدمته ايريس مردوخ في مسرحيتها الروائية (البحر.. البحر ) الحائزة على جائزة البوكر البريطانية, تأثرت في مواقع كثيرة للعلاقة بين حوارات اشبه باصطدام متفاوت تاريخياً ولكنه يعامل البحر كمرايا ضخمة تسلط المشهد على الوجود الذي شهد كل الحركة من حوله , قدمت عالماً إنسانياً يقوم على حركة داخلية تتجه نحو تطهير الذات عبر مواجهة الذاكرة والرغبة والسلطة الفردية على المصير, و تتخذ التجربة المسرحية مساراً يضع الشخصية الرئيسية داخل دائرة تأمل وجودي حيث يتحول البحر إلى مجال روحي مفتوح يختزن التحول الداخلي ويعبر عن انتقال الوعي الجمعي -الفردي من التملّك والسيطرة إلى إدراك هشاشة الرغبة وعمق التجربة الإنسانية , لأن حين يتشكل الفضاء الدرامي عبر علاقات تتداخل فيها الرغبة بالندم والحلم بالواقع تظهر الشخصيات ضمن مسار روحي يتجسد من خلال التوتر بين الداخل الإنساني والعالم الخارجي المحيط في هذا السياق , ويأخذ البحر دوراً رمزياً يحمل طاقة تطهيرية ويصبح مرآة للذات وهي تتقدم نحو إدراك يتأسس على المحاسبة الداخلية وعلى البحث عن فلسفة أخلاقية تنبع من التجربة الحييه وخالية من السلطة الفردية. تلتقي هذه البنية مع اتجاه الثيوصوفيا المسرحية من خلال حضور المسار الروحي داخل الأداء الذي تتراكم فيه الإشارات الوجودية في الجسد الفكري الروحي وتتحول الرحلة الدرامية إلى انتقال يشبه ارتقاء جمعي عبر تجربة مواجهة الذات أمام سطوة الرغبة وسؤال الخلاص الإنساني , ومن خلال هذا المسار التجريبي اكتسبت المسرحية طاقة فكرية عميقة تجعل البحر مجال تحول روحي ومعرفي لقضية الإنسان في آن واحد . تُظهر هذه الأمثلة أن الثيوصوفيا المسرحية ترتبك كتيار منعزل، وتشكلت عبر تراكم تجارب مسرحية سعت إلى إعادة تعريف الهوية الإنسانية بالتجربة, وحين تعامل النقد المسرحي المعاصر مع هذا المسار عبر تحليل عناصر الأداء وطبيعة الزمن اكدت هذه الدراسات النقدية أن هذا الاتجاه أسهم في نقل المسرح من وظيفة ترفيهية مفاهيمية نفسية إلى وظيفة التجربة الحقيقية , وأن الثيوصوفيا المسرحية بهذا الدور ليست منغلقة اكثر من كونها استجابة تاريخية لأزمة المسرح حين عجز عن الاستمرار بوظيفته التقليدية للكلمة والتأثير , و كل تجربة حملت هذا التوجه تعاملت مع الخشبة كحيز اجتماع إنساني كمنصة عرض , لهذا السبب ظل هذا المسار حاضرا في المسرح التجريبي، وفي العروض التي ترفض السوق الترفيهي وتعمل على استعادة أثر العرض الإنساني داخل الجماعة , والنقد الجاد لم يكن يعامل مسرح الثيوصوفيا من زاوية التحول اكثر من زاوية النجاح والفشل , ولماذا اختار هذا الشكل تحديداً , الثيوصوفيا تطرح هذا السؤال بقسوة في تجربتها المسرحية وكأنها ثورتها الكلامية التنورية وتضع المسرح أمام تاريخه الطويل كممارسة أجتماعية من خلال الحدث الجمعي قبل أن يكون فناً. *كاتبة ومترجمة. الرياض
