اختارت عنوان «شاعرة الوطن والإنسان» لكتاب حياتها ..
سعاد الصباح: حضور المرأة الكاتبة هو عنوان لعدالة المجتمعات.
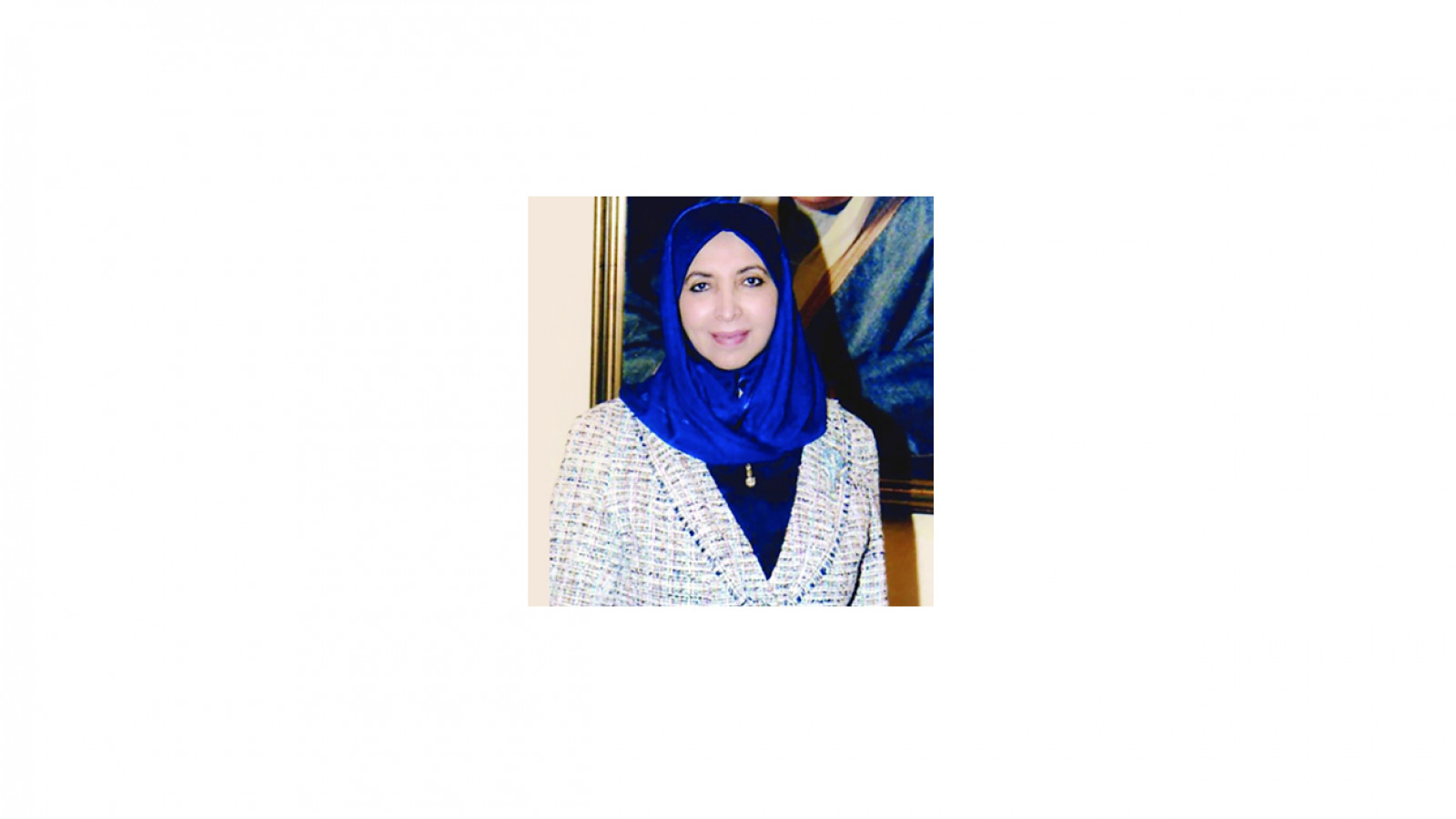
حين يكون الضيف سموّ الشيخة الدكتورة سعاد الصباح، فإنّ اللقاء لا يكون مجرّد لقاء صحافي، بل وقفة أمام تجربة عربية استثنائية، جمعت بين الشعر والفكر، بين الاقتصاد والإنسان، وبين الذاكرة الخاصة وذاكرة الدولة. سعاد الصباح ليست صوتاً شعرياً عابراً، بل مشروعاً ثقافياً متكاملاً، امتدّ أثره من القصيدة إلى المؤسسة، ومن الكتاب إلى الموقف، ومن الجمال إلى الدفاع الصريح عن الإنسان والحرية والكرامة. في هذا الحوار، نقترب من سعاد الصباح وهي تعيد فتح دفاتر الذاكرة عبر كتاب «الشيخان»، لا بوصفه سرداً شخصياً، بل بوصفه شهادة على زمن التأسيس، وعلى معنى الدولة حين تُبنى بالأخلاق قبل السلطة. نقرأ معها الشعر بوصفه موقفاً، والمرأة بوصفها فاعلة لا ظلّاً، والثقافة باعتبارها مسؤولية تاريخية لا ترفاً نخبويّاً. إنه حوار مع امرأة صنعت لنفسها مكانة لا تستند إلى اللقب، بل إلى الكلمة، ولا إلى الامتياز، بل إلى الوفاء للإنسان والوطن معاً، كما يتجلّى بوضوح في هذا النص الحواريّ العميق: •لنبدأ من «الشيخان» بوصفه كتاب ذاكرة وحياة ودولة في آنٍ واحد؛ متى شعرتِ أن الوقت حان لتكتبي هذا الكتاب، وأن الصمت تجاه تلك المرحلة لم يعد ممكناً؟ زمن الكتاب يحين عندما تطلب الذاكرة نفسها الخروج، تطرق باب الحياة بعنف لتعلن نفسها مثل جنين حانت ولادته. هناك لحظات في حياة الإنسان لا يعود الصمت فيها حياداً، حيث الذاكرة لم تعد شأناً شخصياً، بل جزءاً من ذاكرة دولة. اللحظة التي يصير فيها الصمتُ نقصاً في الرواية، وحضوراً غائباً في سرد التاريخ، هي اللحظة نفسها التي ينعقد فيها قرار الكتابة. خفت على ملامح تلك المرحلة من الغياب في ضجيج حاضرٍ سريع، وأدركتُ أن من الوفاء -ومن الواجب أيضاً- أن أدوّن ما عايشته مع رجلين شكّلا وجدان الدولة وملامحها الأولى. كتبتُ لأني خشيت أن يكون السكوت خيانةً للتاريخ، وخيانةً لرجال رحلوا وظلّ نورهم حيّاً بيننا. • أحد الشيخين هو رفيقُ عمرك الشيخ عبد الله المبارك الصباح؛ كيف واجهتِ حساسيات الكتابة عن زوجٍ هو في الوقت نفسه شخصيةٌ مفصلية في تاريخ الكويت السياسي والعسكري؟ واجهتُ هذا التداخل كما يواجه المرء مرآةً تعكس وجهين يعرفهما جيداً: وجه الإنسان العزيز الكبير في القلب، ووجه القائد الذي حمل هموم وطن كامل، كنتُ أضع قلبي في كفّ، وضميري في كفّ، فلا أسمح للعاطفة أن تُجمّل، ولا للتاريخ أن يقسو. كنتُ أستعيد صوته، وأحاول أن أكون عادلة، لأن الكتابة عنه ليست كتابة عن رجل فقط، بل عن عصر كامل، وعن قيمٍ تعلمتُ منها معنى العطاء والصدق والتضحية. وصعوبة الكتابة عن شخصية بحجم الشيخ عبد الله المبارك الصباح تنبع من تداخل الخاص والعام؛ فهو زوجٌ في الذاكرة، ورمزٌ في التاريخ، والتعامل مع هذه الازدواجية يحتاج مسافة وجدانية تحافظ على صدق العاطفة دون أن تخلّ بواجب التوثيق. •عند إعادة بناء صورة الشيخين في الكتاب، ما الحدّ الفاصل الذي حرصتِ على عدم تجاوزه بين عاطفة الزوجة والوفاء للأسرة من جهة، ومسؤولية المؤرِّخة أمام التاريخ من جهة أخرى؟ الحدّ كان رقيقاً كشعاع وهو واضح بشدة.. أيضاً كشعاع.. من واجبي أن أكون وفيّة للحقّ مثلما أكون وفيّة للعاطفة. لم أسمح للحبّ أن يزخرف الوقائع، ولا للوفاء والإعجاب أن يطغى على صدق النسخة التي يجب أن تُسلَّم للأجيال. التاريخ ليس مائدة نضع عليها ما نشتهي؛ فهو أمانة، والذي يخون الأمانة يخذل نفسه قبل أن يخذل الآخرين. والحد الفاصل كان احترام الحقيقة؛ ألا تنحاز العاطفة إلى بهرجة الصورة، وألا تُجمِّد المسؤولية التاريخية حرارة التجربة الإنسانية. المعادلة هي الوفاء للأسرة دون الإخلال بنزاهة السرد. •ما اللحظة أو الواقعة التي شعرتِ فيها، وأنتِ تكتبين «الشيخان»، بأنك تعيدين الاعتبار لا لشخصيتين فقط، بل لـ»روح دولة» وُلدت في زمن مختلف عن زمننا؟ كانت اللحظة حين حمّلني عبدالله المبارك أمانة كتابة تاريخ حكام الكويت، وأكّد لي ذلك قبل رحيله، ووعدته أن أفعل.. وكنت شاهدة على وطن يُولَد من شجاعة رجالٍ عاشوا بلا أجندات سياسية، وبلا ترفٍ إداري. شعرتُ حينها بأنني أستعيد ملامح وطن صغيرٍ بحجمه، كبيرٍ بأخلاق رجاله، كأنني أوقظ في الذاكرة روحاً تمهّلت طويلاً قبل أن تنهض من جديد. أثناء تأليف الكتاب ومراجعته مرات ومرات، بدت بعض الوقائع أشبه بإعادة تنشيط لجذوة تأسيس الدولة نفسها، فالأمر لم يكن احتفاءً بشخصيتين، بل استدعاء لروح مرحلةٍ كان فيها بناء الدولة عملاً يومياً، وحلماً جماعياً. •إلى أيّ مدى ترين أن قراءة الجيل الجديد لـ»الشيخان» يمكن أن تعيد تشكيل وعيه بمعنى الدولة، والقيادة، والولاء، بعيداً عن الصور السريعة وذاكرة «السوشيال ميديا» القصيرة؟ القراءة العميقة هي فعل مقاومة ضد النسيان، والجيل الجديد بحاجة إلى أن يرى أن الدولة ليست شعاراً، ولا صورةً عابرة في هاتف، بل فكرة بنيت بتضحيات جيل كامل. «الشيخان» ليس كتاباً عن الماضي فقط، بل درس في معنى «الولاء الواعي» الذي لا يتغذّى من عاطفة، بل من معرفة. حين يفهم الجيل الجديد كيف تُبنى الدول، سيعرف أن الولاء ليس هتافاً.. بل مسؤولية. الكتاب يتيح لهم فهم معنى القيادة قبل أن تصبح «ترند»، ومعنى الولاء قبل أن يتحول إلى شعارات. •وُصفتِ في دراسات عديدة بأنك واحدة من أبرز الأصوات الشعرية النسائية في العالم العربي، تجمعين بين الرومانسية وحسٍّ تمرديّ نسويّ ووطنيّ في الوقت نفسه. كيف تشكّل هذا المزيج داخل قصيدتك عبر العقود؟ تشكل كما تتشكل المرأة نفسها؛ قلبٌ يحبّ ولا يعتذر عن عاطفته، ولا يخجل من الحب، وضميرٌ يرفض أن ينام أمام الظلم، وروحٌ تعرف أن الثقافة هي السؤال. لم أتعامل مع الشعر ترفاً، بل ضرورة. ومع كل عقدٍ من الزمن، كانت التجربة تضيف طبقة جديدة إلى صوتي؛ رقة الأنثى، حكمة الأم، عناد المناضلة، وجرأة الشاعرة التي لا تقبل أن تكون ظلاً لصوتٍ آخر. المزيج بين الرومانسية والتمرد والبعد الوطني تشكّل من تراكم التجارب؛ وعي امرأة تُصارع الأنماط الجامدة، وشاعرة تتحرك بين الحلم والواقع، وإنسانة ترى في شعرها امتداداً لحلمها. •في حواراتٍ سابقة تحدّثتِ عن تأثرك بالتراث العربي، وبالمدرسة المهجرية، وبالمتنبي ونزار قباني، لكن قصيدتكِ ظلّت تحمل توقيعكِ الخاص. ما العناصر التي شعرتِ بأنكِ تحرّرتِ فيها من أساتذتكِ لتؤسسي «صوت سعاد»؟ يتحرر من يدرك أن التأثر لا يعني الإقامة الدائمة في بيوت الآخرين. نأخذ من التراث جذوره، ومن المهجريين نزعتهم للتجريب، ومن المتنبي اعتداده بنفسه وحكمته العظيمة، ومن نزار شجاعته العاطفية.. هكذا فعلت ثم مشيتُ في طريقي. «صوت سعاد» وُلد حين وجدت القصيدة تكتبني؛ حين تركتُ للوجدان أن يصوغ إيقاعه الخاص بلا قيود؛ لغة حبّ تتكئ على تجربة امرأة لا تستعير صوتها من أحد. •لو سألناك عن ثلاث كلمات تلخّص مشروعكِ الشعري كلّه، ما الكلمات التي تختارينها؟ ولماذا؟ الحرية.. لأنه لا شعر بلا أجنحة حرة. الإنسان.. لأن الكتابة خارج معنى الإنسان تتحول إلى مشاعر بلاستيكية. الوفاء.. لأنه القيمة التي تمنح الكلمات روحها وتاريخها. ويمكنني إضافة كلمة رابعة هي الوطن، لأنه أفق القصيدة، وجدلها الأعمق. وكل هذا يستند على جبل من الكبرياء حماني، وساندني، وحملني على أهداب عينيه. •المرأة في شعرك ليست ضحية فقط، بل ذات فاعلة ومحبّة ومقاتلة أحياناً؛ كيف تنظرين إلى حضور «المرأة الكاتبة» اليوم مقارنةً ببداياتك، وهل تشعرين بأن شيئاً جوهرياً تغيّر في موقعها داخل المشهد الثقافي العربي؟ المرأة اليوم أكثر جرأة، وأكثر قدرة على تسمية الأشياء بأسمائها. في بداياتي كان على المرأة أن تقاتل مرتين: مرة لتكتب، ومرة لتُسمِع صوتها. اليوم تملك مساحة، لكن التحدي لم يختفِ؛ فقط تغيّر شكله. لا أزال أرى أن حضور المرأة الكاتبة هو مرآة لعدالة المجتمعات، وكلما كانت صورتها واضحة، كان المستقبل أوضح وأعدل. المرأة الكاتبة اليوم تغيّر موقعها لأنها لم تعد تنتظر الاعتراف، بل تصنعه. ومع ذلك يبقى الطريق غير ممهد بالكامل، لكنه أقل وعورة مما كان في بداياتها. وأكثر ما أخافه على المرأة هو أن تتحول إلى سلعة دون أن تشعر.. •في كثير من قصائدك، يتجاور الحبّ والوطن، والذات والجماعة، والأنوثة والحرية.. هل تكتبين هذه الثنائيات بوصفها توتراً لا يُحلّ، أم محاولة دائمة لخلق مصالحة بين أضداد لا تتصالح؟ أكتب التوتر، والمصالحة، لأصنع الحالة الممتدة بينهما، فالكاتب ليس أحاديّاً، بل باحث في تناقضات هذه النفس الإنسانية العجيبة. الحب والوطن ليسا ضدين؛ كلاهما حالة انتماء. والحرية والأنوثة ليستا صراعاً؛ بل اكتمال. أكتبُ لأصالح العالم في داخلي، ولو للحظة شعرية. وما الشعر إلا محاولة توقيع اتفاقية سلام ولو مؤقتة بين الأضداد. •وُلدتِ في الزبير، وتلقّيتِ تعليمك بين البصرة والكويت، ثم في القاهرة ولندن؛ كيف أثّر هذا الترحال المبكر بين جغرافياتٍ مختلفة على إحساسكِ بالهوية والانتماء؟ منذ بدايات المعرفة التي شكلها والدي، علمني في أساسياتها أن أتعامل مع الوطن العربي كله كهويّة واحدة.. وعبدالله المبارك علّمني أن الهوية ليست جغرافيا الأرض والمسطحات المائية، بل هي الإنسان: لغته، أحلامه، إنسانيته. وكل مدينة رحلت إليها زرعت في روحي لَوناً من الفهم: من الزبير أخذتُ حرارة التآلف الإنساني، ومن البصرة نكهة الماء، ومن الكويت جذور الانتماء، ومن بيروت الحرية، ومن القاهرة قوة العقل، ومن لندن حسّ النظام والبحث. أصبحتُ ابنة الأمكنة المتعددة، وهذا منحني رؤى واسعة ترى العالم دون حدود ضيقة. •درستِ الاقتصاد والعلوم السياسية حتى درجة الدكتوراه، وفي الوقت نفسه واصلتِ كتابة الشعر.. كيف أثّر «العقل الاقتصادي» على «القلب الشاعر» داخل سعاد الصباح؟ وهل تظنين أن هذه الازدواجية منحتك زاويةً مختلفة في فهم العالم؟ العقل الاقتصادي علّمني أن العاطفة وحدها لا تكفي، وأن وراء كل حركة في العالم معادلة. أما الشعر فكان يذكّرني بأن وراء كل معادلة قلباً نابضاً. الازدواجية لم تكن صراعاً، بل كانت بوصلة. العقل يوازن، والقلب يضيء. وربما لهذا جاء شعري مزيجاً من الحسّ والوعي، لا من الانفعال وحده. قلت دائماً إنني جعلت المال خادماً للقصيدة.. ومثل نادل مطيع يقف متحفزاً ينتظر أوامر سيده «الشعر» وطلباته، وهذا ما منح قصيدتي القدرة على رؤية العالم بصورته الحقيقية لتعيد صياغتها بشكلها المفترض: العاطفة من منظور المعرفة، والمعرفة من منظور القلب. •شاركتِ في لجان وهيئات عربية ودولية، ولعبتِ دوراً في التعبئة ضد غزو الكويت.. كيف تقرئين اليوم دور المثقف والمبدع في لحظات الأزمات الكبرى، بعيداً عن الشعارات؟ دور المثقف هو أن يكون ضميراً لا ينام، وصوتاً لا يخاف. في لحظات الأزمات، لا يطلب التاريخ من الشاعر أن يكون قائداً عسكرياً، ولكن يريد له أن يكون ضميراً يوقظ العدالة، ويذكّر الناس بقيمهم حين يهددها الظلم. المثقف ليس صدى للأحداث، بل أحد صانعي اتجاهها الأخلاقي. ومشاركتي في التعبئة لتحرير وطني مثال على أن الكلمة، حين تتجذر في الموقف، تصبح جزءاً من الفعل. •من موقعك شاعرة واقتصادية وعضواً في أسرة حاكمة، كيف تنظرين إلى العلاقة بين السلطة والمعرفة في العالم العربي؟ هل هما متعاونتان أم متنافرتان في أغلب الأحيان؟ العلاقة بين السلطة والمعرفة علاقة حرجة، تتأرجح بين التعاون والتصادم. حين تكون السلطة واعية، فإنها تطلب من المعرفة أن تنير الطريق. وحين تخاف، فإنها تغلق النوافذ. أنا أؤمن بأن مستقبلنا يبدأ حين تعترف السلطة بأن الكتاب ليس خصماً، بل هو شريك في البناء، وأن المعرفة لا تزدهر إلا حين تُفسَح لها مساحة للنقد والإبداع. •أسّستِ دار «سعاد الصباح للثقافة والإبداع»، وأعدتم نشر مجلة «الرسالة» العريقة، واهتممتم بطباعة الأعمال الكلاسيكية.. ما الرؤية الثقافية التي تقود اختياراتك في النشر؟ رؤيتنا أن تبقى الذاكرة الثقافية حيّة، وأن يجد القارئ العربي جذوره وروحه، وأن نعيد للأدب العربي صفاءه.. رؤيتنا تقوم على حماية الذاكرة العربية، وعلى ترسيخ قيمة الجمال في الأدب، وعلى إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة كي تدخل ساحة الثقافة عبر أبواب تليق بها.. وأن تكون الثقافة عملاً إنسانياً.. لا مشروعاً تجارياً.. •في سيرتك الثقافية، أنتِ لا تكتفين بكتابة الكتب، بل تبنين مؤسسات وجوائز ومبادرات.. ما الذي يمكن أن تفعله المؤسسات الثقافية ولا يقدر عليه الأفراد، والعكس؟ المؤسسة قادرة على تحويل الجهد الفردي إلى حركة، وعلى حماية المشروع من الموت البطيء، لكنها تحتاج دائماً إلى روح الفرد التي تشعل الفكرة الأولى. المؤسسات تبني المكان.. والأفراد يشعلون المصابيح. وقد أثبتت دار سعاد الصباح على مدى أكثر من أربعين عاماً من العمل أنها كانت ضرورة للشباب العربي.. وبخاصة أولئك الذين فازوا بجوائزها في بدايات شبابهم.. وهم اليوم وزراء وعمداء كليات ورؤساء أقسام طبية. •جوائز الإبداع العلمي والأدبي للشباب، ومبادرات الطفل الخليجي، وغيرها من الجوائز التي ترعينها.. ما الفكرة الأساسية التي تريدين تثبيتها في وعي الأجيال الجديدة من خلال هذه الجوائز؟ أريدهم أن يعرفوا أن الموهبة مسؤولية، وأن الإبداع ليس رفاهية، بل طريقٌ لتغيير الذات والعالم. الجوائز رسالة تقول للشاب: «أنت أولوية، وأحلامك تستحق أن تُصان». أريد جيلاً يؤمن بأن المعرفة قوة، وأن المستقبل يُكتب بأقلامهم، وأن الإبداع مسؤولية، وأن المستقبل يُبنى حين يشعر الشاب بأن جهده مقدَّر. إنها محاولة لتأسيس ثقافة الاحتفاء بالمنجز. •في تجربتك، أيّهما أصعب: أن تؤسسي دار نشر وتصمد وسط تحولات سوق الكتاب العربي، أم أن تصمد قصيدتك في وجدان القرّاء أمام التحولات الجمالية واللغوية الجديدة؟ كلاهما صعب.. وكلاهما جميل. صمود الدار يحتاج إلى إدارة، وصمود القصيدة يحتاج إلى روح. صمود الدار تحدّ معرفي، أما صمود القصيدة فتحدٍّ جمالي وروحي. الأول يحتاج إلى ثبات فكري في سوق الكلمة، الثاني يحتاج إلى استقرار دائم في الوجدان.. وعمق الذاكرة. قد تتغيّر الأسواق وذائقة الأجيال، لكن ما يأتي من القلب يصل إلى القلب، وهذا ما أراهن عليه دائماً. •لو عدنا إلى البدايات.. متى شعرتِ أول مرة بأن قصيدة كتبتِها ليست مجرد بوح شخصي، بل هي نصٌّ يخصّ قارئاً آخر سيأتي من مكانٍ بعيد وزمنٍ آخر؟ حين بدأ القرّاء يخبرونني بأنهم وجدوا أنفسهم في كلماتي، أدركتُ حينها أن القصيدة ليست ملكاً لنبضها الأول، ولليد الأولى التي كتبتها، بل هي جسر يمتدّ من ذاتي إلى الآخرين. الشعر يولد منّي.. لكنه يعيش فيهم. هكذا تخرج القصيدة من خصوصية الذات إلى فضاء القارئ، وهكذا ندرك أن النص، إذا صدق، يتحول إلى ملكية عامة.. إلى مرآة يرى فيها الآخرون وجوههم. •هل شعرتِ في مرحلةٍ (ما) بأن اسمك الاجتماعي ومكانتك العائلية قد شكّلا عبئاً عليك بوصفك شاعرة تريد أن تُقرأ بعيداً عن الألقاب والأنساب؟ وكيف تعاملتِ مع هذا العبء؟ الاسم الاجتماعي قد يكون عبئاً لأنه يفرض توقعات مسبقة على النص، لكنني تعاملت مع ذلك بتكثيف العمل على جودة القصيدة بحيث ينافس النصُّ اسمَ كاتبه، لا العكس. الاسم أمانة ومسؤولية مثل سمعة الأب، ومثل قلب الأم.. ومثل المعتقدات النبيلة، لكني قررتُ منذ البداية أن أترك للقصيدة أن تعرّفني.. وأن تكون الكلمة هويتي، فمن يقرأ ما أكتب فسيجد المعنى لا اللقب، ومن يبحث عن اللقب فلن يجد نفسه في نصّي.. ومن يعش الشعر الذي أكتبه فسيعرف أن الكلمة لا تحمل لقباً، بل روحاً. •في مقالاتٍ وكتاباتٍ عنك، كثيراً ما يُشار إلى حضورك النسويّ والإنساني في آن: الدفاع عن المرأة، والاهتمام بالطفل، والانشغال بالقضايا العربية الكبرى كفلسطين.. كيف تنسّقين بين «الإنسانية العامة» و»الهمّ الوطني والنسويّ» في خطابك؟ هو الخطاب الذي يحاول التوفيق بين الإنسان قيمة، والمرأة قضية، والوطن هوية، ولا تناقض بينها في تجربتي لأن جذورها الثلاثة تنبع من الإيمان بالكرامة.. وفلسطين قضية إنسان. خذها قاعدة: الكتابة عندي تبدأ من الجوهر الإنساني، ثم تكبر دوائرها لتشمل الأوطان والحقوق والوجود. الإنسانية هي الجذر.. وكل ما عداها فروع.. تشرح الفكرة الأساس. •خلال مسيرتك الطويلة، هل شعرتِ يوماً أن قصيدة بعينها سبّبت لك مشكلة سياسية أو اجتماعية، أو جعلتك تدفعين ثمناً (ما)؟ وهل تندمين على أي نصّ نشرتِه؟ بعض النصوص قد تثير حساسيات، وهذا طبيعي في خريطة عربية شديدة التعقيد، وربما كانت بعض القصائد شجاعة أكثر مما يحتمله الواقع. نعم، دفعتُ أثماناً أحياناً، لكني لم أندم.. الندم لا يصنع شاعراً. ما كتبتُه كتبتُه بضميرٍ واضح، ومن يكتب بصدق لا يخاف مراجعة نفسه. فالكتابة موقفٌ بحد ذاتها. •في حوارٍ قديم لك أوضحت أنك سبحت في التراث وتأثّرت بالمدرسة المهجرية، لكن العالم اليوم مختلف، والقرّاء مختلفون.. كيف تتعاملين مع ذائقة جيل جديد يقرأ الشعر على شاشة هاتف، لا في ديوان مطبوع؟ التعامل مع ذائقة الجيل الجديد يتم عبر احترام طريقته في القراءة، مع الحفاظ على جوهر الشعر، وأنا أتعامل بالحبّ لا بالخوف. أؤمن بالتواصل والتفاعل مع الحياة، وأؤمن بأن لكل جيل لغته وإيقاعه ووقته. المهم أن تظل القصيدة قادرة على ملامسة القلب. سواء قرأني الشاب على شاشة موبايل أو في كتاب مدرسي أو في ورق جريدة، فالمعيار واحد: هل جعلَتْه القصيدة أكثر إنسانية؟ إن حدث هذا.. فلا تشغلني الوسيلة. •تقول بعض الدراسات النقدية عن شعرك إنك تشتغلين على ثنائيات الحضور والغياب، الحياة والموت، الخيانة والوفاء.. هل ترين نفسكِ أقرب إلى «شاعرة السؤال» أم «شاعرة الجواب»؟ أحب أن أكون شاعرة الإنسان، لكن الأسئلة هي التي تفتح النوافذ، أما الأجوبة فتغلقها أحياناً. الشعر ليس امتحاناً نبحث فيه عن الإجابات، بل رحلة نبحث فيها عن المعنى. القصيدة حالة قلق تبحث عن إجابة.. والسؤال في تجربتي ليس جهلاً، بل وسيلة لإبقاء المعنى في حالة تحفّز. •في كتاب «كلمات حب» الذي اعتبره بعض النقاد سيرة ذاتية غير مباشرة، كتبتِ عن الحياة والحبّ والذات بلغة قريبة جداً من القارئ. هل يمكن أن نقول إنك تكتبين سيرتك الذاتية «مجزّأة» عبر كتب متفرقة، بدل كتاب واحد مباشر؟ الحياة لا تُروى دفعة واحدة؛ هي لحن يتشكل من مقاطع متعددة. ومع ذلك.. هناك أشياء متراكمة في الذاكرة لا تصلح إلا أن توضع في كتاب مذكرات خاص.. وهذا ما سيحدث قريباً إن شاء الله.. •هل تفكرين جدياً في كتابة سيرة ذاتية صريحة، تتحدثين فيها عن الإنسانة سعاد، والزوجة، والأم، والاقتصادية، والشاعرة، بعيداً عن (الحُجُب) التي تفرضها بعض الاعتبارات العائلية والسياسية؟ الصراحة الواعية والمسؤولة لن تجرح أحداً، ولن تظلم أحداً. •ما اللحظة التي في حياتك تشعرين بأنها فصلٌ روائيّ لم يُكتب بعد كما يستحق: هل هي الطفولة بين البصرة والكويت، أم سنوات الدراسة في القاهرة ولندن، أم تجربة الغزو والتحرير، أم زمن «الشيخان»؟ لكل مرحلة سحرها، لكن ربما تبقى أحداث الاعتداء السافر على غزة هي الفصل الروائي الأكثر كثافة وإمكاناً سردياً، لأنها مرحلة أعادت تعريف الذات والذاكرة، لأنها لحظة انكسار ونهضة معاً، لحظةٌ اختُبرت فيها معادن البشر، وتغير فيها شكل العالم داخلنا. •عندما تنظرين اليوم إلى خريطة الثقافة العربية.. ما أكثر ما يقلقك؟ تراجع القراءة، أم هشاشة المؤسسات الثقافية، أم هجرة العقول، أم أشياء أخرى لا نلتفت إليها بما يكفي؟ يقلقني ضياع البوصلة؛ أن نقرأ كثيراً أو قليلاً ليس هو جوهر القضية، بل: هل نعرف لماذا نقرأ؟ هشاشة المؤسسات ليست خطراً بذاتها، بل هي خطر لأنها تجعل الثقافة بلا سند. أما هجرة العقول فهي جرحٌ في جسد الأمة. أخاف أن نفقد القدرة على الحلم.. قبل أن نفقد القراءة. •لو طلبنا منكِ أن توجّهي رسالة خاصة إلى الشاعرات العربيات الشابات اللواتي يدخلن اليوم إلى عالم الكتابة من أبواب رقمية ومنصات جديدة، ماذا تقولين لهنّ عن الحرية، وعن الجرأة، وعن المسؤولية؟ أقول لكل شاعرة: اكتبي كما لو أن العالم كله يستمع لك.. كما لو أن ضميرك شاهِدٌ عليك. اكتبي صوتك كما لو أنك تصنعين بداية جديدة للشعر. الحرية التزام، والجرأة موقف، والمسؤولية هي القلب الذي يقود الاثنين. لا تسمحي للضجيج بأن يهزم صوتك، ولا للشهرة السريعة بأن تخدعك. أقول للشاعرات: اكتبن لتكبر قلوبكنّ.. لا لأجل التصفيق. •في ضوء الاحتفاء الذي خصّك به مهرجان الناظور الدولي، وما وثّقته مجلة اليمامة من هذا التكريم بوصفك شاعرة ومفكّرة ومناضلة، كيف تنظرين اليوم إلى دور الشعر في الدفاع عن الإنسان؟ وهل ما زلتِ تؤمنين بأن القصيدة قادرة على كتابة العدل والرحمة، لا الاكتفاء برفع الشعارات؟ بالتأكيد، أؤمن، أكثر من أي وقت مضى، أن الشعر ليس ترفًا لغويًا ولا زينة ثقافية، هو موقف أخلاقي قبل أن يكون فنًا. الشعر، في جوهره، انحيازٌ للإنسان حين يُترك وحيدًا، وحين يسلب منه وحقه في الحلم. لم أكتب القصيدة يومًا لأرفع شعارًا يعيش بقدر عمر الهتاف ثم تموت. أريد لقصيدتي أن تكون حقيقية.. تسكن الضمير وتعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان ونفسه، وبين القوة والعدل، وبين السلطة والرحمة. القصيدة التي تصرخ وتُحاسب، وتُذكّر، وتفتح نافذة للوعي حين تُغلق الأبواب. أؤمن أن القصيدة قادرة على الانتصار للعدل، بوصفها سؤالًا دائمًا يقلق الظلم ويحرجه. وقادرة على أن تُنقذ العالم من وحشيته. الشعر الذي لا يدافع عن الإنسان، يفقد أحد أسبابه العميقة في الوجود. والقصيدة التي لا تُنصت لوجع البشر، لا تستحق أن تُكتب. لهذا كنت، وسأظل، أؤمن بأن الكلمة الصادقة هي شكل من أشكال المقاومة الهادئة، وأن الشعر، حين يكون نزيهًا، يملك قدرة نادرة على أن يقول ما تعجز عنه الخطب والبيانات: أن الإنسان هو القضية الأولى والأخيرة. •أخيراً.. إذا طُلب منك أن تختاري عنواناً واحداً يُلخّص رحلتك في الشعر والفكر والإنسان، فما العنوان الذي تضعينه على غلاف «كتاب حياتك»؟ ولماذا؟ أختار عنواناً بسيطاً.. لكنه يشبهني: «شاعرة الوطن والإنسان». حياتي كانت رحلة بحث عن الإنسان؛ إنسان تصنعه المعرفة، تكتبه الحرية، وكل ما كتبته في سطر واحد طويل كان محاولة صغيرة لإبقاء هذا الضوء مشتعلاً.. في القلب، وفي الوطن، وفي العالم.
