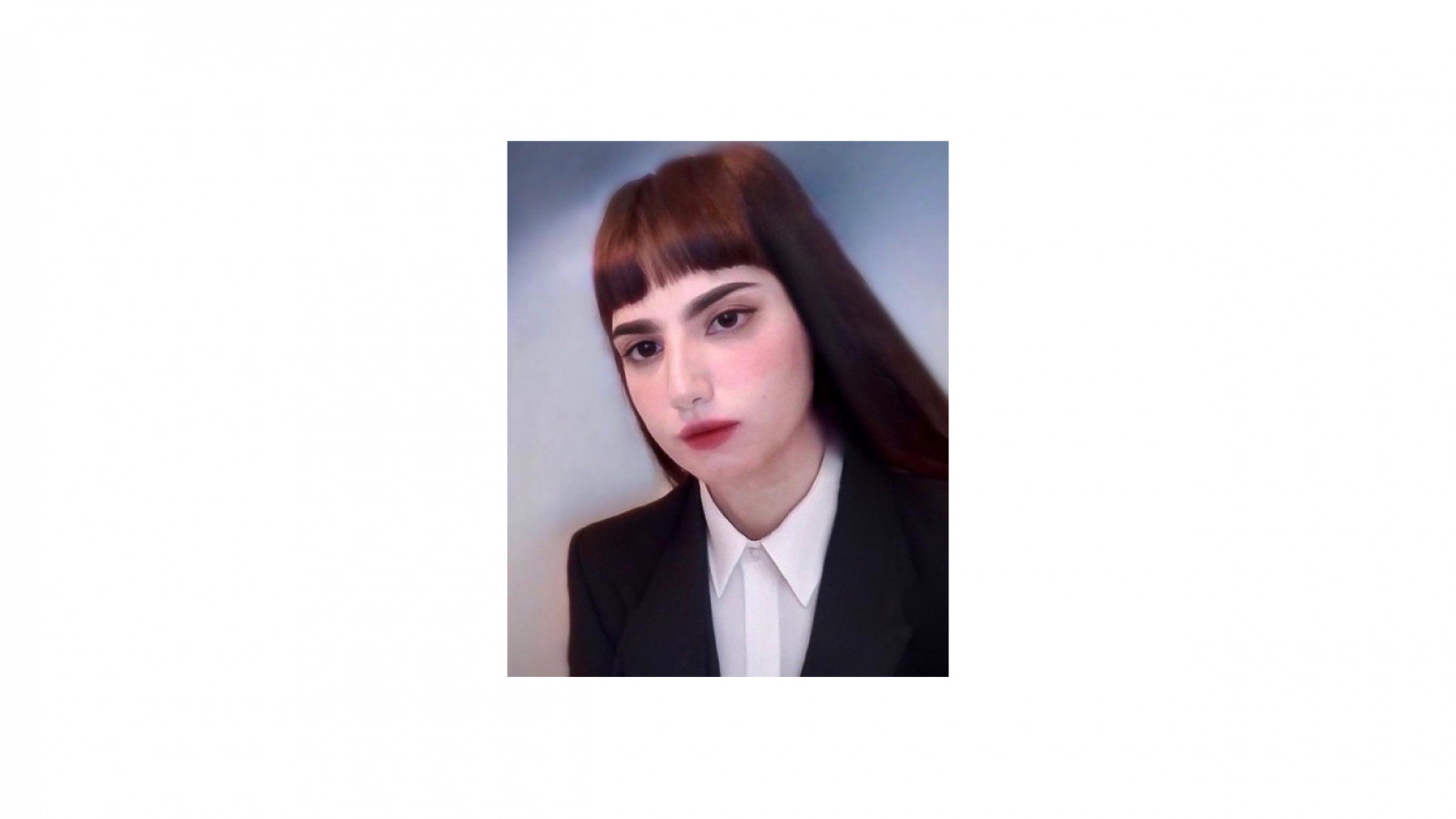
الترجمة مجال يعكس أعمق أشكال الاحتكاك بين اللغات والثقافات, لأن النص حين ينتقل من لسان إلى آخر يدخل في فضاء جديد يغير إيقاعه وبنيته ومعناه وهذه الحركة تفكك المفردات من خلال الشعور الثقافي الاجتماعي و تكشف عن صراع بين ذاكرة النص الأصلية ومتطلبات اللغة التي تستقبله, في هذا الصراع يتكون إدراك مختلف للغة نفسها حيث تتجلى حدودها وقدرتها على احتواء فكر يتشكل في مصدرها الأول و لأن التعدد اللغوي يفتح بدوره مجالاً واسعاً لتعدد الأصوات ويعمق المشهد اللغوي, فالنص الذي يجمع أكثر من لسان يتحول إلى مساحة تداخل وتنتج معاني إضافية وتكشف عن طاقة جديدة للكتابة, و هذا الامتداد يجعل الترجمة والتعدد معاً عنصرين أساسيين في تشكيل الوعي المعاصر باللغة وعمق الفلسفة الإثنية للكلام الخام وفي توسيع قدرتها على إنتاج معرفة تتجاوز حدودها الأولى, وحين ندرك أن اللغة وعاء للمعرفة وامتداد للتاريخ فكل كلمة تتشكل داخل بيئتها الثقافية, وتحمل أثر العادات والرموز والمجازات التي صاغتها حين تنتقل عبر الترجمة إلى لغة أخرى تفقد جزء من طاقتها الأولى، وتظهر داخل بناء جديد يختلف في الصوت والإيقاع والمصدر. الترجمة الفلسفية تكشف هذا الاختلاف بشكل مباشر فمثلا عند هايدغر الشعور اللغوي يمثل شبكة كاملة من العلاقات الفكرية التي نسجتها الثقافة الألمانية من خلال ارتباطه بكلمة محورية منشقة من الشعور الكلامي الخاص جداً لمصطلح ( dasei) وكونها في العربية تستقر في كلمة (كينونة) هنا يتحول المصطلح إلى علامة معجمية محدودة الطاقة من الأصل وفقدت جوهر الإرث اللغوي، لأن النص في أصله مشروع متكامل لكن النسخة المترجمة تقدم طبقة سطحية منه والأدب يقدم صورة أخرى لهذه الفجوة. قصيدة إليوت الأرض اليباب عندما تُرجمت إلى العربية لم تحتفظ إلا بجزء من بنيتها الشعورية لكون الإيقاع الذي صنع التجربة الأصلية غاب عن النص المترجم والرموز الأسطورية ظهرت مبتورة، فكان القارئ في العربية يواجه أثراً شعرياً مختلف لا يطابق التجربة التي عاشها القارئ الإنجليزي، وهذا الإشكال ظهر بشكل كبير في الترجمات العربية الأولى لروايات دوستويفسكي حيث واجهت تحدياً مشابهاً تحولت فيه الشخصيات ذات الأبعاد النفسية المعقدة إلى شخوص مسطحة بسبب ضياع التفاصيل الدقيقة التي صاغها النص الروسي للطبقة الشعورية بين الباردة والعميقة جداً والتي تظهر بشكل جلي على سلوك المواطن الروسي من خلال هذه الطبيعة الغرائبية المتجمدة ظاهرياً وذات عوالم فضفاضة من التجرية الإنسانية الفريدة من نوعها . من هذا الفراغ ظهرت ممارسة جديدة تتجلى في (التظاهر بالتعدد اللغوي) داخل الخطاب اليومي في أشكال التواصل المترجم، إذا يتعمد كثير من المستخدمين إدخال كلمات أجنبية في النص العربي ليبدو النص أكثر انفتاحاً وتقارباً, والنتيجة خطاب هجين لا يكتمل في أي من اللغتين ويمنح القارئ صورة عن التباس أكثر مما يمنحه وضوحاً متكامل، ولم ينجو الخطاب الأكاديمي العربي والذي شهد هذه الظاهرة نفسها في بحوث العلوم الإنسانية أجمع ، فكثير من النصوص كانت ذات ابعاد غريبة للقارئ ولم يلمسها القارئ كما لو كانت نسخة مشوهة للمعلومة, حين تدرج كلمات مثل (Identity ) داخل جملة عربية دون أي دمج حقيقي فالقارئ يجد أمامه نصاً يميل إلى الاستعراض المصفوف أكثر من البناء المعرفي الممنهج لأن المفردة الأجنبية تبقى جسداً غريباً داخل النص وتفقد القدرة على التفاعل مع السياق العربي, والشعر العربي الحديث لم يكن بعيداً عن هذه الممارسات لأن بعض الشعراء أدخلوا مقاطع فرنسية أو إنجليزية في قصائدهم لتأكيد حداثة الشكل, والنتيجة أن القصيدة فقدت انسجامها الداخلي وتحولت اللغة الثانية إلى عنصر زخرفة ولا يضيف إلى التجربة الشعرية الا شكل مشوه للشعور للقارئ مع النص, وهذا ما يعمل به خلايا الدماغ في معنى الفقد كترجمة لحظية حين يُفقد الارتباط العصبي شعورياً بين الفكرة الحاضرة والشعور بها . هناك نصوص ومفاهيم تنغلق داخل لغتها الأصلية وتقاوم الانتقال إلى لغة أخرى والكلمة في هذه الحالة تحمل فرادة تاريخية طويلة من المشاعر والرموز التي يصعب اختزالها في نمط معين، وحين نصور كمثال تجربة الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا وكوني قارئة متتبعة له جوهرياً من خلال الأصالة اللغوية الشعرية استخدم سياق كلمة (saudade) في البرتغالية في قصائدة بشكل مترابط وإن اختلف المشهد والزمكان، وهي كلمة تعني إحساس بالغياب والحنين والفقد مجتمعة في لحظة واحدة معاً، وهذه الموضوعية المقصودة كانت من بيئته الاجتماعية المختلفة كفرد وجماعة داخل بوتقة تجمع مشاهد متعددة داخل كلمة واحدة، هي ما تسمى شفرة المكان، و هذا ينطبق على كلمات خاصة في التركية تشير إلى حزن جماعي يغمر مدينة بأكملها، وهو شعور يختلف عن الحزن الفردي في قوته وامتداده،و لا توجد كلمة عربية قادرة على احتواء هذا المزيج الدقيق من اللغات الأخرى، هنا اللغة تتحول إلى فضاء كامل محدد جغرافياً بالطبيعة الإنسانية واشتباكاتها الداخلية والفكرية أكثر من كونها مجرد وسيلة تواصل، ومهما كان المترجم يستطيع أن يشرح ويضيف ويطيل الجملة لكنه لا يمنح القارئ التجربة نفسها التي يعيشها المتحدث الأصلي، خصوصاً في الشعر يظهر هذا التحدي بوضوح، فقصيدة الهايكو اليابانية التي ترتكز على تكثيف شديد يجعل من لحظة طبيعية بسيطة كوناً كامل من الإيحاء، و حين تنتقل إلى العربية تتحول إلى نص جديد يحمل معناها الظاهر لكنه لا يعيد إنتاج الإيقاع ولا الأفق الروحي الذي ولدت فيه. ما لا يمكن ترجمته يظل علامة على أن اللغة كيان يحمل ذاكرة أمة ورؤيتها، وعند هذه النقطة يدرك القارئ أن الترجمة مهما بلغت دقتها تظل فعل إعادة كتابة لكونها فعل ثقافي يفتح للنص حياة ثانية و كل نص يعبر إلى لغة أخرى يحتفظ بجذوره الأولى ويكتسب في الوقت نفسه ملامح جديدة من البيئة التي تستقبله، هذا العبور يمنح القارئ فرصة لمعايشة فكر عالمي داخل لغته الخاصة ويكشف له أثر التباين بين الأصل والنسخ وتفكيكه، ومهما حاولنا التقارب فالنص المترجم يحمل هوية مزدوجة, فهو ابن الثقافة التي وُلد فيها وضيف على الثقافة التي تبنته و تعمل هذه الازدواجية على منح النص عمقاً إضافيا تجعل الترجمة مجالاً لتأسيس معرفة تتشكل في المسافة بين لغتين، لكن في هذه المسافة يولد خطاب جديد يوسع أفق القارئ ويعيد تعريف حدود اللغة نفسها،ومع ذلك الضياع في الترجمة يكشف حدود الممكن والتقارب والتظاهر بالتعدد اللغوي و يكشف حدود الصورة، وبين هذين المسارين يتشكل وعي جديد باللغة حيث تتحول الترجمة إلى ممارسة معرفية قادرة على إعادة إنتاج النصوص داخل سياقات جديدة ويتحول التعدد اللغوي إلى تجربة تُظهر تنوع الأصوات وتداخلها، من هذا العبور يولد فضاء خصب للفكر ويجد القارئ نفسه أمام نص يفتح أكثر من أفق ويجمع بين ثقافتين في حضور واحد، ويظهر الضياع في الترجمة كأثر ثقافي يعكس حدود اللغة في انتقالها، وهذا التظاهر بالتعدد اللغوي يتشكل كأثر اجتماعي يعكس رغبة الكاتب في استعارة سلطة لا يملكها لكن المساران يكشفان أزمة معاصرة في التعامل مع اللغة، الأولى أزمة حضور النص في سياق جديد، والثانية أزمة صورة يسعى الكاتب إلى صناعتها, والنص يحقق قيمته عندما يتمكن من بناء خطاب متماسك داخل لغته وعندما ينجح في إعادة إنتاج الأفكار بصورة حية تتجاوز الزخرفة، تبقى الترجمة الناجحة قادرة على أن تعيد كتابة النص في روح جديدة، والتعدد الحقيقي يمنح النص أكثر من منظور دون أن يضحي بوحدته اذا استخدمت في شكل يظهر اللغة ولا يزيفها او يشوهها، عند هذه النقطة يتحول العبور بين اللغات إلى مساحة إنتاج للمعرفة أكثر من كونها واجهة شكلية خالية من جماليات الشعور اللغوي. *كاتبة ومترجمة- الرياض
