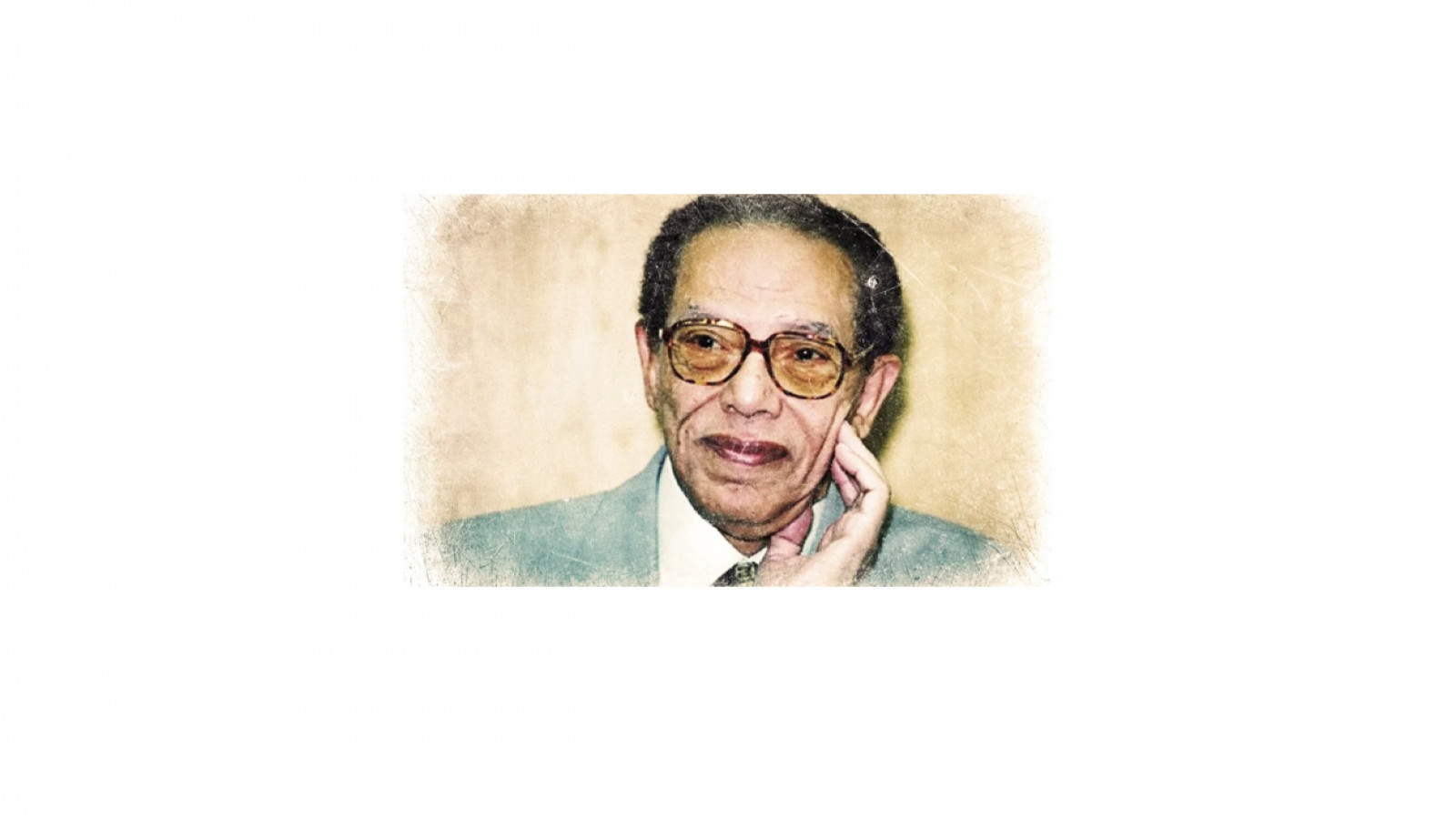
في ركن غرفة متواضعة في (شبين الكوم)، كانت الشمس تودّع النهار بخجل، تتسلل خلف البيوت الطينية المتلاصقة في قرية (ميت خاقان). هناك، انزوى الطفل مصطفى، يتفحص زجاجة دواء أفرغتها الأيام، ويتأمل جناح فراشة ميتة، رقصت ذات يوم في حقول القرية. كان يحلم، وهو طفل، بكولومبوس، وباستير، وإديسون، ونابليون؛ أبطالٌ يرسمون في مخيلته عوالم بعيدة، يصنعون المستحيل، ويغيرون مجرى التاريخ. كان يعيش برئة واحدة، إذ تعطلت الأخرى بسبب الدرن الذي أنهكه. الجدار يئن تحت وطأة الرطوبة. خلف الباب الخشبي العتيق، كانت ضحكات الأطفال تتراقص كالأنغام، تتقافز على إيقاع الحياة البسيطة؛ حبلٌ مشدود بين شجرتين، صبي يركض، وآخر يتعثر، فيضحك الجميع. كان قلبه تواقًا للانضمام إليهم، لكنه أسير جسد نحيل أنهكته نوبات الحمى، فبقي حبيس الجدران، حبيس الأسئلة التي لا تنام. في (المدرسة الخيرية الإسلامية بطنطا)، كان هناك حوشٌ كبير، يتجمع فيه الماء أيام الشتاء، فيصنع مصطفى سفنًا ورقية، ينفخها، متخيلًا أنها تبحر إلى الهند وبلدان بعيدة، تحمل أحلامه إلى أفق لا يراه سواه. بعد الغروب، وعلى طاولة خشبية متآكلة، فوقها قطعة قماش بالية، رصّ مصطفى أنابيب زجاجية، بعضها من أدويته التي فرغت، وبعضها من قوارير المربى الخاوية. في زاوية الغرفة، أسس معملاً صغيرًا يعبق برائحة الصابون والمبيدات الحشرية. يجلس ساعات طويلة يشرّح أجسادها الدقيقة تحت وهج مصباح زيتي، يتأمل تركيبها. ويكتب ملاحظاته على قصاصة ورق: «العينة الأولى... توقفت الحركة بعد 4 دقائق و17 ثانية». كما أحب اقتناء الفراشات، يحتفظ بها في الزجاجات كأنها كنوز صغيرة تحمل أسرار الطبيعة. منذ الثامنة من عمره، أحب العلوم والفنون؛ كتب الزجل، عزف على الفلوت، والرسم بالألوان، وتدرب على النحت. الحشرات لم تكن وحدها من شغلت مصطفى؛ ففي الليالي الهادئة، كان يتسلل إلى حلقات الذكر الصوفية قرب مسجد «المحطة»، ذلك المزار الروحي الذي يتنفس التصوف. وسط أناشيد الموالد وأنفاس الذاكرين، كان يغوص في لغز آخر: لغز الروح. كيف لإنسان أن يتأرجح بين تشريح جناح حشرة، وبين السباحة في بحار التصوف العميقة؟ كان هذا التناقض نواة شخصيته، التي ستظل تسعى لربط خيوط العقل بأنوار الروح! وحين يرهقه التفكير، كان يمد يده إلى نايه الصغير، ينفخ فيه أنفاسًا رقيقة تحمل همهمات الروح، فتصعد به إلى سماوات لا حدود لها. ذلك الناي كان بوابته من ضيق الجسد إلى اتساع النفس؛ يعزف، فيغرق في بحر من الرؤى، يرى ما لا يُرى، ويسمع همسات الكون التي لا تُقال. في المساء، كان يزور والده على سريره، مبتسمًا رغم هزيمة الشلل، ويقول: — «النهارده شفت جناح ناموسة تحت المجهر... شكله زي خريطة مرسومة بدقة. يا بابا، هو ممكن ربنا يكون راسم كل حاجة كده بالتمام؟» يضحك الأب، ثم يسعل طويلًا، ويهمس: — «لما تكبر... يمكن تكون أنت اللي بتعرف السبب». في بدايات حياته، وُلد مصطفى مع شقيق توأم يُدعى سعد، لكنه رحل رضيعًا. لم يُسجل والده ميلادهما إلا بعد أسبوعين من الولادة، خوفًا من فقدانهما؛ وهكذا، أصبح تاريخ ميلاده الرسمي (27 ديسمبر 1921) مجرد ظل للحقيقة، إذ وُلد قبل ذلك بأسبوعين. هذا الغموض حول بداية حياته، ووجود توأم لم يعش، أضاف لمسة غريبة إلى طفولته، كأن القدر يُعده لرحلة مليئة بالأسئلة العميقة! طفل لا يركض مثل أقرانه، لكنه يعدو في أعماق المعنى. لا يلهو بالطين، بل ينقب عن أسرار الوجود. طفل صغير، على سرير متهالك، في قرية بعيدة... لكنه كان يُجري أولى تجاربه، لا على الحشرات فقط، بل في تأمل الكون كله. في سنوات دراسته الأولى، لم تكن الأمور سهلة؛ فقد رسب ثلاث مرات في السنة الأولى بسبب ضرب المدرس، لكنه لم يستسلم عاد للدراسة بعد نقل المعلم. وفي الثانوية، كان يغوص في كتب الجامعة، يدرس الكيمياء والفيزياء والأحياء بنهمٍ لا يشبع، وببجاماته المخرّمة من الأحماض والمركبات الكيميائية التي كان يجربها بنفسه. مرت السنوات كضوء خفيف يمر فوق سطح الماء، لا يترك أثرًا ظاهرًا، لكن الأعماق تتشكل في صمت. أصبح مصطفى شابًا، بعينين لا تزالان تحتفظان بذات الوميض المتقد، لكنه الآن يرتدي معطفًا أبيض ويحمل سماعة طبيب حول عنقه. نصحه أخوه مختار بالالتحاق بالكلية الحربية بمساعدة واسطة قوية، لكنه لم يفرح بالقبول، فاقترح عليه مختار الطب، وكأن القدر يوجهه إلى طريقه الحقيقي. القاهرة ليست طنطا، والجامعة ليست تلك الغرفة القديمة، لكنه ظل هو؛ يسأل أكثر مما يجيب، ويتأمل أكثر مما يتكلم. كان يرسم أجهزة مبتكرة، ينفذها صديقه فرج في مدرسة الصنائع؛ ابتكارات صغيرة وبسيطة تحمل بصمة عبقريته المبكرة. في بداية السنة الثالثة بالجامعة، عاد المرض ليضربه بقسوة، فأمضى ثلاث سنوات حبيس غرفته، بينما تخرج زملاؤه. في عزلته، غاص في الأدب العالمي بكل تنوعاته، قرأ وتأمل، فصنعت تلك السنوات الثلاث من محنته منحة، وشكلت عقله وروحه بشكل مختلف. عاد للدراسة متغيرًا، مزودًا برؤية أعمق، الأدب زرع فيه بذور الفلسفة والتأمل. ابتكر جهازًا لقياس النبض بتكاليف زهيدة، أذهل به أساتذة الجامعة، ففتحوا له أبواب المعمل ليواصل تجاربه. في أحد أيام الدراسة، وقف مصطفى داخل قاعة المشرحة؛ الهواء كثيف، مزيج من رائحة المطهرات وهيبة الموت. جسد ممدد على الطاولة المعدنية، طلاب يتجمهرون، وأستاذ يُلقي التعليمات: — «اليوم سنتعامل مع الرئتين، لاحظوا كيف يتمدد النسيج... انتبهوا لتركيب القصبة الهوائية». اقترب مصطفى، وضع قفازيه؛ الجثة لا تُخيفه، فقد رأى الموت في عيني أبيه، وسكنه طويلًا في طفولته المريضة. كان مهووسًا بالتشريح إلى درجة غريبة. في غرفته الصغيرة، تحت سريره، كان يحتفظ بنصف جثة بشرية اشتراها وحفظها في مادة الفورمالين، مما تسبب له بأمراض تنفسية صعبة فاقمت مرضه، لكنه لم يتوقف. كان عمال النظافة ينتظرونه حتى وقت متأخر، لأنه كان ينسى نفسه في المعمل. في امتحان مع البروفيسور (بيري)، أذهل الجميع بمعرفته الهائلة بمناطق الدماغ، ثقافته سبقت المناهج بسنوات. أطلق عليه زملاؤه لقب «المشرحجي» ضاحكين. الموت بالنسبة له لم يكن نهاية، بل لغزًا يحتاج إلى فهم. تخزين نصف جثة تحت سرير غرفته كان يعكس شغفه العلمي الاستثنائي، وجرأته في مواجهة الموت كسؤال، لا كخوف. أمام الجثة في المشرحة، توقّف لثوانٍ، نظر في وجهها؛ كان الوجه ساكنًا، بلا حياة، بلا روح. سأل نفسه، بصوتٍ داخلي يهزّه: — «أين ذهبت الروح؟ هذه القصبة الهوائية أمامي، وهذه الرئتان... لكن أين هو؟» ذلك «الهُو» الذي كان يمشي ويتكلم ويحب ويكره... أين ذهب؟ ما الذي غادر؟ ولماذا لا نستطيع رؤيته؟ أمام هذا الجسد، شعر لأول مرة بأن الطب يشرح الجسد، لكنه لا يشرح الحياة. خرج مصطفى مُثقلًا، لا بالخوف، بل بالأفكار. وقف في ردهة الكلية، وحده، بينما يمر الطلاب حوله، وهو يسأل: — «هل الروح مادة؟ هل يمكن أن نضعها تحت المجهر؟ أم أنها تفرّ إذا حاولنا لمسها؟» رفع عينيه نحو السماء الواسعة، كأنها تُجاري حيرته. لتوفير المصروف وهو يدرس الطب، عمل عازف ناي مع الراقصة (فتحية سوست)، دون أن يخبر أحدًا. وذات مرة، لم يحضر مع الفرقة، فقررت الفرقة زيارته للاطمئنان عليه، فحضروا إلى بيته، لتنكشف القصة أمام أمه، التي غضبت وطلبت منه التوقف عن العزف مع الفرقة. ثم بدأ الكتابة، وأهدى العقاد ثلاثين قصة؛ كان العقاد يقرأها لضيوفه بفخر، ثم قدمه إلى الزيات، رئيس تحرير مجلة «الرسالة»، فنشرت له قصصًا عام 1947. تعرف على كامل الشناوي، فدخل أسرة «أخبار اليوم»، وبدأ يكتب في «روز اليوسف» وهو لا يزال طالبًا. أول كتاب له، «الله والإنسان»، أثار جدلًا كبيرًا، فاحتج الأزهر، وأمر عبد الناصر بمصادرته عام 1956، وخضع مصطفى لمحاكمة سرية في أمن الدولة، لكنه خرج براءة بعد أن دافع محاميه بأن الكثير مما ورد في الكتاب له نظائر في كتب الأئمة والفقهاء. قال كامل الشناوي عنه: «هذا مصطفى، يُلحد على سجادة الصلاة»، بينما كتب محمود أمين العالم ثلاث صفحات يمتدحه، لكن زملاء العالم سخروا منه، قائلين إنه «درويش مغفل سينهي حياته على رصيف السيدة زينب». كان جمال عبد الناصر يبغضه، وكان محمد حسنين هيكل أحد أسباب هذا البغض، مما زاد من التحديات التي واجهها. ألّف رواية «المستحيل» عام 1960، التي تحولت إلى فيلم بطولة كمال الشناوي ونادية لطفي عام 1965، وكتب مسرحيات تم تمثيلها، وفيلمًا سينمائيًا آخر. لكن إحسان عبد القدوس أخبره بأمر من جمال عبد الناصر بالتوقف عن الكتابة، في محاولة لكبح أفكاره الجريئة. كتبت بنت الشاطئ ثلاثمائة مقال لنقد تفسيره العصري للدين، لكنه رد بكتاب «حوار مع صديقي الملحد»، ثم «رحلتي من الشك إلى الإيمان»، وبعدها «سقوط اليسار»، مهاجمًا الأفكار الاشتراكية واليسارية. تزوج عام 1961 من سامية، بعد قصة حب بدأت عبر الهاتف؛ حيث كانت تتصل به كقارئة للمجلة التي يعمل بها، تشتكي من حبيبها، ليكتشف لاحقًا أنه هو الحبيب المقصود، فتزوجها في قصة حب طريفة. ذات ليلة، استيقظ مصطفى من حلم غريب؛ رأى فيه صديقه الصحفي جلال العشري، الذي كان يكتب معه في مجلتي «صباح الخير» و«روز اليوسف»، يتناقش مع أشخاص في وسط البلد حول مصطلحات علمية. عندما اتصل بجلال ليخبره بالحلم، صُدم جلال وقال إن هذا الحدث وقع بالفعل في ذلك اليوم، وكأن مصطفى كان موجودًا معه. هذا الحلم تسبب في توتر شديد لمصطفى، فقاده إلى البحث في الفلسفات والتصوف والبوذية والهندوسية والزرادشتية، ثم إلى دراسة الدين بعمق أكبر. كانت تلك الحادثة غريبة؛ قدرته على رؤية حدث حقيقي في منامه دون علمه المسبق دفعته إلى استكشاف أبعاد روحية وفلسفية جديدة، عززت إيمانه بأن النفس البشرية ليست مجرد جسد، وأن هناك وجودًا روحيًا يتجاوز المادة. لم يكن يعلم أنه بدأ منذ الآن رحلته الكبرى... من الشك إلى الإيمان. في إحدى أمسيات القاهرة الثقيلة، قبل الشهرة بسنوات، كان مصطفى يسير في شارع القصر العيني، وحده، تتبع خطواته ظلالٌ من الأفكار والأسئلة. مرّ بواجهة مكتبة صغيرة، فيها عناوين متناقضة: «نقد الفكر الديني»، «العقل والإيمان»، «أصول الشيوعية»، «التصوف الإسلامي»... توقّف، تأمل، ثم دخل. أمسك بنسخة قديمة من «الوجود والعدم»، ونسخة أخرى من «الله يتجلى في عصر العلم»، ثم سأل البائع: — «ألاقي عندك كتاب لا ينكر الدين... ولا يُنكر العقل؟» ضحك البائع وقال: — «يبقى تدوّر عليه في قلبك، مش على الرفّ». خرج مصطفى وهو يحمل الكتب، لكن ما حمله أثقل كان ذلك الرد: «في قلبك». كأن العبارة طُعنت في لبّ تساؤله. في المساء، جلس في حجرته، محاطًا بالكتب، لكنه لم يقرأ. أطفأ النور، وفي الظلام، همس لنفسه: — «هل أنا ملحد؟» ثم قال: — «لا... لكنني لست مؤمنًا أيضًا. أنا... تائه». وكان ذلك التيه أولى خطوات اليقين. لكنه لم يكن تيهًا هادئًا دائمًا؛ فقد كان مصطفى يكتب في تلك الفترة باستمرار، ويناقش أفكارًا جريئة، ويطرح أسئلة تتحدى المألوف. اتهمه البعض بالتناقض، بأن أفكاره تتأرجح بين الإيمان والشك، بين العلم والدين، لكنه دافع عن نفسه بقوة، قائلًا إن اعترافه بأخطائه يعكس شجاعته في نقد الذات، وهو موقف نادر بين المفكرين. كان يرى أن البحث عن الحقيقة ليس خطًا مستقيمًا، بل طريقًا متعرجًا يتطلب التواضع والجرأة معًا. تزوج مرة ثانية عام 1983 في المدينة المنورة، في يوم المولد النبوي، حيث تبرعت زوجته زينب حمدي بمهرها لدعم مشروعه الخيري، في لفتة تعكس روح العطاء التي سادت حياته. قبل ذلك بعشر أعوام، في زاوية من مبنى ماسبيرو، جلس مصطفى محمود أمام ميكروفون قديم. على الطاولة ورقة واحدة، فيها نقاط معدودة. قال للمهندس الصوتي: — «ابدأ بموسيقى الناي اللي اخترناها». كان نايه، الذي أصبح من أشهر النايات في الوطن العربي، يحمل توقيعه الخاص، يعزف أنغامًا تملأ القلوب تأملًا وسكينة. ثم اقترب من الميكروفون، وهمس كما لو كان يحادث وجدانًا نائمًا: — «أهلاً بيكم». ثم بدأ أولى حلقات برنامجه «العلم والإيمان». كل يوم اثنين الساعة التاسعة مساءً على القناة الثانية المصرية، كان صوته يصدح، يحمل إلى الملايين أفكارًا تجمع بين العقل والروح. بدأ البرنامج بطلب من الرئيس السادات، بأجر زهيد لم يتجاوز 350 قرشًا للحلقة الأولى، لكن هذا العمل المتواضع تحول إلى ظاهرة، حقق أرباحًا للتلفزيون المصري، في تناقض غريب بين بساطة بداياته وتأثيره الهائل. استمر حتى عام 1994، عندما أوقفه (صفوت الشريف) بناءً على توجيهات (حسني مبارك)، بسبب انتقادات مصطفى للكيان الصهيوني. تحدث مصطفى عن الخلايا، وتكبير الزمن، والفيروسات، والليزر، ونظرية التطور، والجهاز العصبي، والعالم الخفي، وعن النسبة الذهبية التي ترسمها الطبيعة في صمت، والكثير من المواضيع العلمية الصعبة. قال: — «نحن أمام تصميم، لا مصادفة». ومنذ تلك الحلقة، لم تعد «الخلية» مجرد مادة في كتاب الأحياء، بل أصبحت دليلًا على الخالق. توسّعت الحلقات، وامتد الجمهور من الأكاديميين إلى البسطاء، ومن أطفال القرى إلى المثقفين في العواصم. حتى الملكة فريدة، ملكة مصر السابقة، كانت من متابعي البرنامج. ذات يوم، جاءه عرض من الرئيس السادات لمنصب سياسي رفيع، ربما مرتبط بتشكيل الحكومة أو منصب وزاري، لكن مصطفى رفض، مفضلًا الاستقلالية والتركيز على رسالته الفكرية والخيرية. كان هذا القرار غريبًا في سياق عصره، حيث نادرًا ما يرفض أحد فرصة سياسية كبيرة، لكنه اختار أن يظل صوتًا للعقل والروح، لا للسلطة. كما كان له موقف آخر مع الفنان محمد عبد الوهاب، الذي دعاه للتعاون في أعمال فنية، لكن مصطفى، بتواضعه المعهود، اقترح أن يوجه عبد الوهاب موهبته لدعم الأعمال الخيرية. قال له يومًا: — «حقابل ربنا بشوية كلام؟ لا... بدأت رحلة الأعمال بعد رحلة الأقوال». في مساءٍ هادئ من عام 2000، جلس مصطفى محمود إلى مكتبه، يحمل بين يديه مسوّدة كتاب طال تأجيله... كتاب يناقش واحدة من أكثر القضايا حساسية في العقل الديني: الشفاعة. لم يكتبه ليهاجم، بل ليسأل، ولم يطرحه لينكر، بل ليفهم. كان يرى في بعض التصورات الشائعة عن الشفاعة فهمًا سطحيًا أو ساذجًا، يجعل منها بطاقة عبور، لا علاقة قلبية. أراد أن يعيد السؤال: «هل ننتظر الشفاعة كتذكرة مجانية؟ أم نعيشها كعلاقة ومسؤولية؟» صدر الكتاب بعنوانه البسيط: «الشفاعة»، ولم يمض وقت طويل حتى تحولت صفحاته إلى شرارة نقاش. كُتبت الردود، وعُقدت الندوات، وأصدر بعض علماء الدين كتبًا تفنّد ما جاء فيه. لم تكن الضجة سهلة، ولم تكن عادلة دائمًا، لكنه لم يردّ، ولم يهاجم، بل آثر الصمت. جلس في عزلته الفكرية، وأعاد قراءة ما كتب؛ لا خوفًا، بل احترامًا لما أثارته كلماته. ثم، في نبلٍ لا يعرفه كثير من الكتّاب، تراجع عن بعض ما أورده، لا تحت ضغط خارجي، بل عن قناعة داخلية بأن الكلمة مسؤولية، وأن البحث لا يعني الجزم، بل التجرؤ على السؤال. قال في أحد تعليقاته لاحقًا: «لم أكتب الشفاعة لأُنكر، بل لأفهم... وأحيانًا، الفهم لا يكتمل إلا بعد أن تُنصت لصوت الآخر». وقال يومًا: «السعادة الحقة هي حالة عميقة من حالات السكينة، تقل فيها الحاجة إلى الكلام وتنعدم الرغبة في الثرثرة. هي حالة رؤية داخلية مبهجة، وإحساس بالصلح مع النفس والدنيا والله، واقتناع عميق بالعدالة الكامنة في الوجود كله، وقبول لجميع الآلام في رضا وابتسام». خرج مصطفى من تلك العاصفة أقل صخبًا، وأكثر تواضعًا، وأشد إيمانًا بأن ما يُكتب عن الدين يجب أن يُغلف بالمحبة والتقوى، لا بالثقة المفرطة. قبل ذلك بربع قرن، في حي المهندسين، وقف مصطفى محمود فوق أرضٍ ترابية، وقال: — «هنا... لن نبني مسجدًا فقط... بل سنبني فكرة». كانت الشمس تغرب، كما اعتادت أن تفعل في حياته كلما بدأ مشروعًا كبيرًا، لكنه هذه المرة لم يكن يكتب كتابًا، ولا يحضّر حلقة، بل يزرع معنى. أوصى أن يُبنى المسجد باسم والده، وكان يقيم صرحًا للفكر والرحمة، للعلم والإيمان، للروح والجسد. بُني المسجد، لكنه لم يكن مجرد قِبلة للصلاة؛ كان هناك مستشفى للفقراء، وعيادات للمرضى، ومراصد فلكية، ومتحف جيولوجي. فراشات محنطة بجوار تلسكوب، ومرضى ينتظرون الدواء ببطاقات صدقة، وأطباء شباب يسيرون في صمت، كأنهم يُكملون حلمًا لشخص لم يعد يُجيد سوى المراقبة من بعيد. مصطفى، الذي ترك الطب منذ عقود، عاد إلى الطب... بطريقته؛ عاد لا ليسمع نبض القلب، بل ليُعيد للقلوب نبضها بمعنى. عاد لا ليصف العلاج، بل ليجعل من العطاء شفاءً. كان يرتدي معطفًا رماديًا بسيطًا، يمر بين المرضى، يضع يده على كتف طفل، ينحني لامرأة عجوز. ومع كل مريض يُشفى، كان يشعر أنه شفى جزءًا من طفولته، من جسده، من قلبه. كان يُرمم الإنسان... بنفسه. في السنوات الأخيرة من حياته، اختفى مصطفى محمود في عزلة غامضة بشقته في القاهرة. كتب على باب غرفته «التابوت»؛ ليمنع الآخرين من طرق الباب ومقاطعة خلوته الفكرية والبحثية. بعيدًا عن الأضواء التي أحاطت به طوال عقود، أصبح وحيدًا في عالم كان يملؤه بأفكاره. أصدقاؤه قالوا إنه كان يعاني من نزيف في المخ أدى إلى فقدان جزئي للذاكرة، مما جعله يتذكر الأشخاص بصعوبة، حتى أصدقاءه المقربين. كان يرفض استقبال الزوار، ولم يكن يسمح إلا لابنته أمل بزيارته. هذا الاختفاء أثار تساؤلات الإعلام، خاصة أن برنامجه «العلم والإيمان» كان يحظى بشعبية هائلة. بدا وكأنه «مات مرتين»؛ مرة بانسحابه من الحياة العامة، ومرة بوفاته الفعلية. كان هذا التحول غريبًا؛ من مفكر يملأ الدنيا بصوته إلى شخص منعزل تمامًا، محاطًا بشائعات عن فقدان ذاكرته، مما أضاف إحساسًا بالغموض إلى نهايته. في 31 أكتوبر 2009، رحل مصطفى محمود، بعد أن أمضى 255 يومًا في المستشفى. في صمت، دون مراسم، دون مسؤولين، دون وفود ولا أكاليل ورد. كانت الجنازة باردة، إلا من حرارة دموع من قرأوه، من شفَتهم كلماته، من أنارت ظلمة نفوسهم حلقاته، ومن بُعث فيهم الإيمان على يد «العلم». رجل عاش خفيفًا، فمات كما عاش. ترك 89 كتابًا، و400 حلقة، ومؤسسة طبية، ومسجدًا، ومتحفًا... لكن ترك قبل كل هذا سؤالًا حيًّا: هل يمكن للعقل أن يسجد؟ هذه ليست قصة رجلٍ عاش، ثم مات، بل حكاية سؤالٍ وُلد، وما زال يطرق أبواب العقول التي لم تجد في الكتب وحدها سكينة، ولا في المواعظ الجاهزة يقينًا. مصطفى محمود لم يُقدّم إجاباتٍ قاطعة، بل أسئلة ذكية. لم يتحدث من فوق منبر، بل جلس إلى جوار القارئ، وسأله: — «هل ترى ما أرى؟» وها نحن نرى... نرى في إرثه ذلك النور الذي لا يُطفأ، ذلك الجسر الذي بناه بين المعمل والمحراب، بين الجسد والروح، بين الحيرة والإيمان. هو لم يكن معصومًا، لكنه كان صادقًا في بحثه، نقيًا في معاناته، نبيلًا في تراجعه، وواسعًا في عطائه. واليوم، إذ نقرأه، نشاهده، ونقتدي بعطائه... فكأنّه يقول لنا من هناك: «ابحث... لا تتوقف... فالله يحب السائلين، الله لا يُعبد بالجهل». واليوم، كلما همس ناي في الليل، أو سُمعت ضحكة طفل في مستشفاه، أو اشتعل سؤال في عقل قارئ... عاد صوته يتردد: «أهلاً بيكم...»
