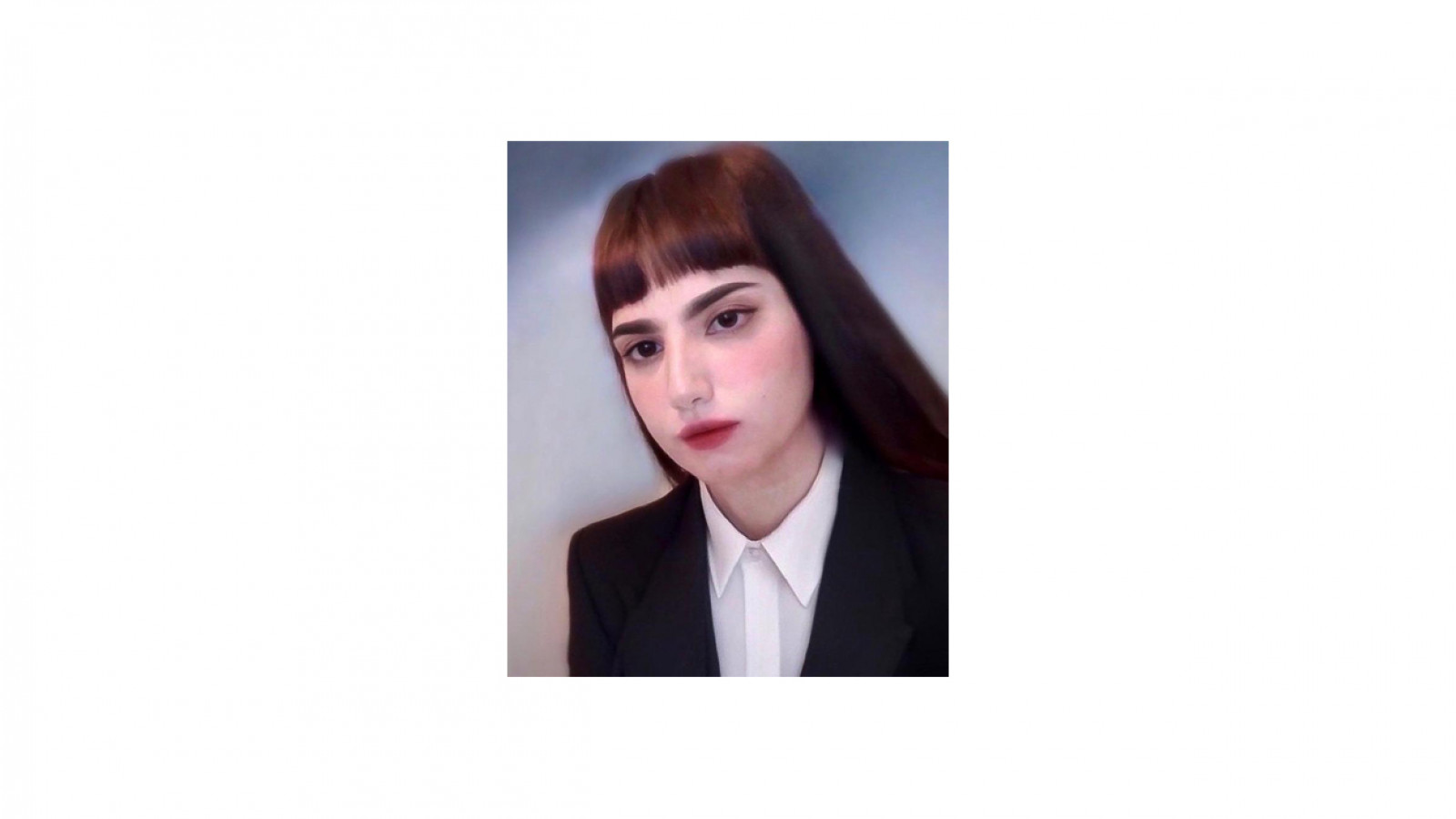
(اللغة التي لا تتألم لن تشفى) كانت هذه العبارة التي دونتها منذ سنوات طويلة في دفتر المحاضرات الصغير الذي يلتقط مشاهد خارج السياق للحاضر تلهمني في وسط واقعي جداً، وبدت كمفتاح مجهري لكتابة هذه المقالة، حيث أعادتني لمشهد لا يتطور فيه الزمن بين مفارقات الماضي والحاضر فيما تؤوله التساؤلات تجاه الموقف، وهو ما حدث معي في منتصف محاضرتي الجامعية سابقاً، إذ كان النقاش يدور حول تمثيل الألم في روايات ما بعد الحرب كحالة عضوية عقلية مريضة، محاضرة بدت بديهية أكاديمية تخصصية جداً، المتحدث كان محاضراً اكاديمياً بارع السرد والشرائح البصرية تظهر مراجع طبية دقيقة عن الخلل العقلي ما بعد اضطراب الصدمة الأكثر وحشية والأثر الرجعي، ولكن في منتصف العرض انطفأت الشاشة فجأة وظهر نص لعبارة وحيدة (اللغة التي لا تتألم لن تشفى) ثم عم الصمت! المكان يبث شعوراً مظلماً بالتقوقع وبالتوجيه المفاجئ للجميع دون حراك، إلى أن ظهر صوت من بيننا لأحدهم يقول: «هل هذه محاضرة أم نوبة؟» وأيضا لم يعلق أحد لا على الشخص أو حتى على الموقف ككل، و كما هو متوقع كفارق بين عنصر المفاجأة والتفكير النمطي بفوارقه المختلفة لكل شخص منا حيث أن الجميع التقط التفسير الموجه من المحاضر بطريقته (غير المتشافية) بمفارقات متعددة وان لم تكن حاضرة حتى في الوعي، وهو الشيء الذي مزق التصنيف المعتاد بين الطب واللغة الأكاديمية والتقنية البصرية المعتادة حين استشعرناها ذلك الوقت، كان المحاضر يقدم توجيها معنويا عبقريا وغيبيا عن اضطراب اللغة بمعناها الفضفاض جداً، في حالة انكسار الاضطرابات العقلية كشكل من أشكال الحياة العبقرية. ليتساءل بعد ذلك: هل من الممكن ان الوجود اللغوي في أساسه نابعا من ظاهرة مريضة؟ الجملة الافتتاحية هنا وما جاء في سياقها الشعوري في التاريخ الأدبي السردي لا يتضمن القول إن الأدب يعاني من المبالغة، لو أمعنا قليلاً، بدون أحكام، لرأينا أن النص يتضخم حين يتجرد كنص مريض في تصديق أن معاناته قابلة للقياس وفق معايير نقدية. لهذا حين نصف مفهوم المرض الأدبي على أنه يُرصد في بنية النصوص فقط وأن قابليته في الذهانية سوف تستقبل أيضا، نجد أن الأدب حين يُصاب لا يتقيح داخل الجملة كنتيجة ظاهرية ومع ذلك ينمو بشكل فردي داخل العقل الذي أنتجه. وهذا ما يجعل من السؤال حول (الاستشفاء الأدبي) يطرح كضرورة خالية من الترف البلاغي. عبر التاريخ كان المرض ملازماً للكتابة، متشكلاً كمنبه أو خلل أو حتى طقس إبداعي. لكن التحول الأهم لم يكن في المرض وعمقه، بل في نوع الاستجابة له: من الإدمان عليه إلى محاولة علاجه. هنا يبدأ الأدب يلتفت إلى نفسه كمرآة للعالم أو ككائن معطوب يريد أن يُشفى، والاستشفاء بهذا المعنى، ان لم نصنفه كمفهوم طبي مستعار، فإننا سنلبسه وعيا وظيفيا معرفيا يسعى إلى إعادة الأدب إلى توازنه أو على الأقل إلى إعادته إلى وعيه باضطرابه. في هذا السياق تُقرأ أعمال مثل رواية (الطاعون) لألبير كامو على أنها لم تتخذ السرد عن وباء فقط، بل هي حالة نمطية فردية ترى كمحاولة لاستعادة الاستكشاف المعنوي المبطن وسط انهيار المنطق الشعوري، ولو تتبعنا سياق السرد المبطن، لم يكن الراوي يحكي عن المرض كحدث خارجي، بل رأى اللاجدوى كعدوى داخلية، وكان «الطبيب ريو» يمثل بطلاً نبيلاً شيدت شخصيته كاستعارة عقلية لإنسان يحاول استعادة سلطته على العبث. لهذا فإن الأدب المريض غالباً ما يُنتج صوراً مرتفعة التوتر في المشهد وعالية التهتك، خالية من الإدراك نحو الخلاص؛ فحين يفقد النص قدرته على خلق انفعال مركب ويكتفي بالإثارة أو التنميط أو المحاكاة، يصبح حالة سريرية لا تنتج سوى ضجيج أجوف يمثل الألم الفردي. ومن هنا يمكن فهم ظواهر متكررة في نصوص اليوم، مثل التضخم الوصفي والشعرية الزائفة، والوعي المستعار، على أنها أعراض اضطراب حقيقية في السرد، بين المفهوم العميق وفرضية النص السليم المتعافي بلا قفزات أسلوبية. لكن هل يُشفى الأدب؟ وما آلية هذا الاستشفاء؟ في المجمل الاستشفاء في المجال الأدبي لم يكن علاجا سطحيا عبر الطرح المباشر أو اللغة الشفافة. التمييز النقدي كنوع من الشفاء يحدث حين يتسرب الى النص إدراك بأن ما كُتب لا يكتفي بالتوصيف، بل يتجاوزه الى التحويل، بمعنى أن ينتقل الأدب من كونه انعكاسا للخلل إلى كونه محاولة لتفكيكه بتجرد. في هذا المعنى تصبح أعمال مثل مدام بوفاري لفلوبير، أو الجبل السحري لتوماس مان مناطق أدبية معنية بالخلل الذهني، لكنها لم تتشكل كعنصر من عناصر الحبكة فحسب، بل ثبتت كأرضية للتأمل الوجودي في عطب الحياة الحديثة. وحين نفهم أن الاستشفاء لا يكون في الشخصيات وحدها، بل ينمو كحقيقة ويتجلى بالمسافة التي يخلقها النص بين القارئ وبين التورط في الجزء الفارغ من النص الشعوري، لندرك أن الحاجة اليوم ملحة لفهم الأدب الحديث كمجال منهك ويتطلب «عيادة نقدية» لا تمارس عليه سلطة التصنيف أو تصغي لعطب النصوص دون تهوين. وما يهم في هذا النموذج أن النقد لا يتعامل مع النص ككائن مكتمل، بل يجب أن يُرى كمريض يخضع للملاحظة، وهنا تستعيد أدوات مثل علم النفس المرضي والأنثروبولوجيا وحتى علوم الأعصاب مشروعيتها كمحاولات تفكيك تعبر من خلاله إلى عمق التجربة دون الاكتفاء بشرح ما هو ظاهر. في الشعر مثلاً، تظهر علامات المرض في التكرار اللاواعي، وفي التمركز حول الأنا المتضخمة نحو المحسوسات ولأن هذا تجسيد للشاعر العاطفي، يظهر عبوره في الانقطاع المفاجئ عن الإيقاع الداخلي، وأيضا في الجمل التي تقف دون بنية احتياج ظاهرية. بينما في العمق تتجلى محاولات الاستشفاء في التواضع اللغوي أمام التجربة، وفي حالة التمزق النحوي المقصود، إذ يعمل الصمت مثل خيار بلاغي. ما يطلبه الأدب في زمنه الحالي جسارة فكرية تمكنه من مراجعة آليات إنتاجه وتجنب تكرار البكاء عليه. فليس كافياً أن نقول إن الرمزية التجارية السهلة قتلت الشعر، أو أن الصورة أضعفت السرد في الرواية أو النص. الأعمق من ذلك أن الكاتب بدأ يفقد قدرته على الإصغاء لنداءات العقل المتعب واكتفى بإنتاج الأعراض. ولأن الكتابة في أصلها فعل شفاء، فإنها حتى إن لم تعد كذلك بشكلها الظاهر، تصبح إعادة إنتاج للضرر. الأدب لا يُشفى حين يعترف بألمه، وسوف نراه يشفى حين يرفض أن يتحول إلى آلية ترويج لألمه. والناقد هنا بالتأكيد لا يتجسد كطبيب بتشخيصه التخصصي، بل ان تداخل المنطق اللامشروط على النص يشبه النظر الى المرض، ليس بوصفه حالة فردية، وإنما التعامل معه بوصفه تركيبا اجتماعيا كاملا يحتاج إلى مساءلة. في النهاية لا يُشفى الأدب إلا حين يخرج من عباءته العاطفية وينظر الى نفسه كمجال مصاب ويعترف بذلك كخطوة نجاة عبقرية، كلغة متشافية تطلب إعادة هندسة للعقل الذي يكتبه. فالأزمة ليست في اللغة وحدها، بل في الذهنية الصادمة التي تستسهل استخدامها كجسر للنجاة، ولا تريد معاملتها كجسد سردي للفهم. وحين يعتمد السرد الأدبي على وصفة مخدرة توصف للجميع، فلن تنجو خيالية الفكرة في النص، ولن يكسرها أحد كنمط متشاف يخلق لغة جديدة تؤرخ وتدرس محورا من مدرسة سردية مبتكرة. وهذا ما يتطلبه الأدب: ألا يكرر نفسه. *كاتبة ومترجمة- الرياض.
