بستان الموت
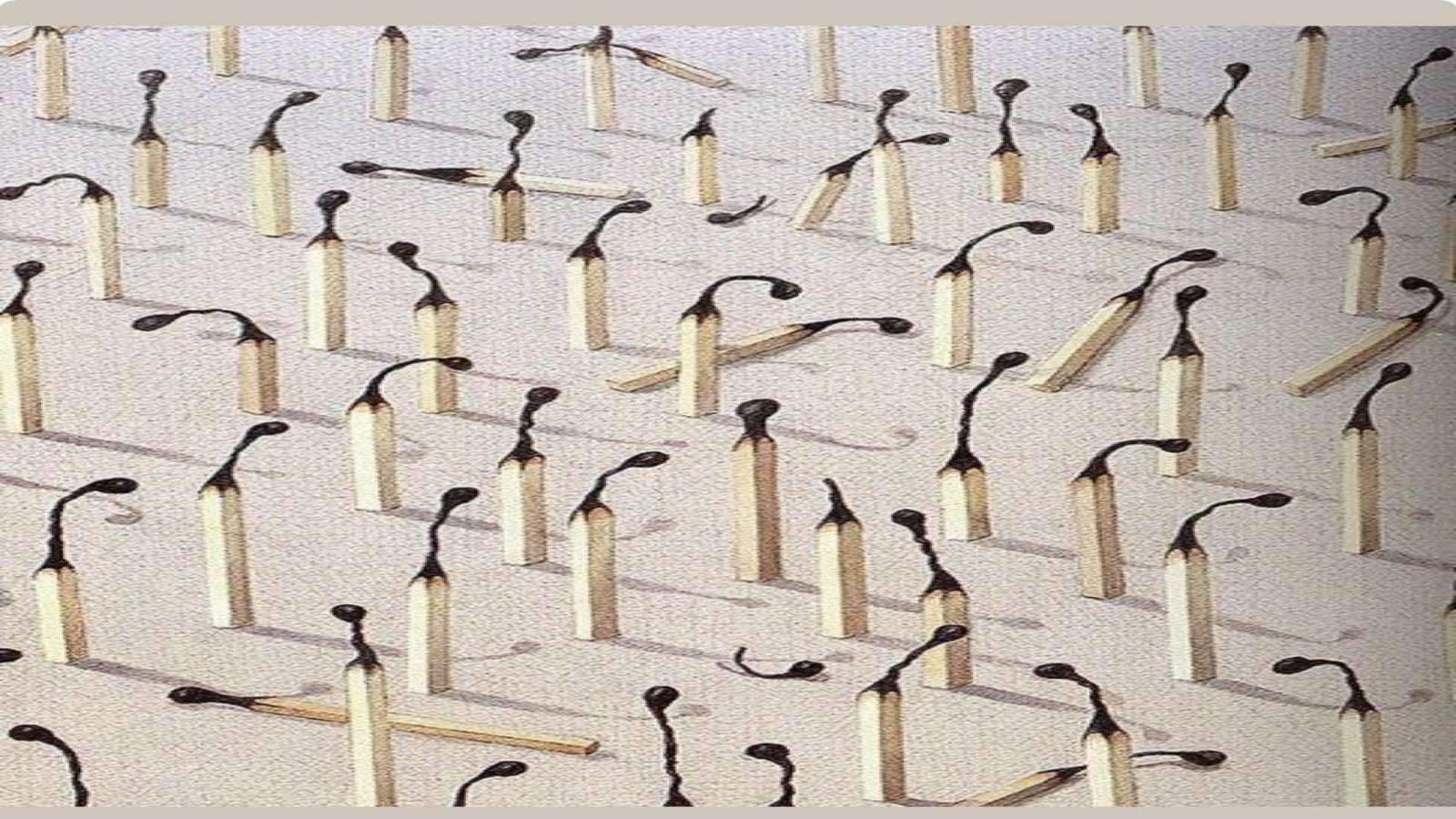
كانت تطوفُ بستان أبيها بغنجٍ وتتنقّل في أعطافهِ بخفرٍ لذيذٍ ما بين زهرة وأخرى ها هنا وها هنا، من الفل إلى الياسمين ومن الجوري إلى دوار الشمس ومن الكادي إلى التوليب بينما تسحب نفسًا عميقًا ذا مغزى وغاية وهي واقفة مائلةٌ للأمامِ إلاّ قليلاً عاقدةً يديها من وراء أسفل ظهرها قبيل أن تُسرِّبَ إلى جيوبها الأنفية كميات عطرٍ فاتنة ترشّها قنينات هوائية شفافة من أفئدة الورود وأزواجها، فتلتذُّ وتلعقُ بلسانها البريء الهادئ الوردي شفاهها وكأنّ ما شمّته من الأريج قد جرى مجراه الذي لا يعلمه إلاّ اللّه وطفِق يفترِشُ ثغرها وملكات تذوّقها، فتروح بغتة - دون أدنى مقدمات - مُغمضة العينين، مُحّمرة الوجنتين، نابضة الخفّاق، عاقفة الحاجبين، باسمة الثغر، مرجرجة الساقين، وتظلّ على حالها هذه لساعات طوِالٍ حتى أنّه ليخُيّل لناظريها أنّها تستحضِرُ أرواحًا شيطانية رجيمة، أو أنّها قد أصيبت بلوثةٍ من جنونٍ هادئ - في أكثر الحالات حُسبانًا- أوردتها لهذا الوضع البائس في هذا الموضع العادي، وما هو بعادي - بطبيعة الحال - وإنّما تتفاوت عدسات العيون وعيون القلوب في تحسّسِ مكامنِ الجمال، وموقع الجلالِ، ولكثر ما مرّت بها السابلة ونادى فيها من نادى، واستهزأ بها من استهزأ، ورجمها بمؤذيات الكلام من رجم، ولطالما تزاحمت عليها النظرات ونهشتها من رأسها لأخمص قدميها وتناوبت عليها، وكم من بطونِ أيدٍ دسّت تحتها شفاهٍ نمّامة مغتابة وقّاحة لا تتفاوت سرعتها في إطلاق هجر القول وبذيئه عن سرعة مدفعية شهر الصيام التي تطلق ما في بطنها وقت الفطر وعند السحور على أن البون في طهر الطوية وشتّان ما بين هذا وذاك، فكانت تشد عينيها مع احتدام الأصوات تشدّها، تشدّها، تشدّها، بإحكامٍ وكأنّها تتشبّث بأهدابها في عالمها العجيب الذي رسمته في خاطرها ولا يدري أنّى يكون إلا اللّه، فلا تبدي ردًّا ولا نصف التفاتةٍ حتّى بينما تتعالى من حولها النداءات التي لم تنبجس من حلوق أصحابها إلا فضولاً وتسلية ولهوًا : «كريمة، كريمة، كريمة، لمَ لا تردين ما أصمّكِ يا بنت؟ يا للمسكينة لقد أصيبت من حزنها بصمم! وما شأن الصمم بالمآسي يا امرأة؟ خير لكِ أن تصمتي، دعوها إنها ممسوسة ستصابون من مسها إن أنتم بقيتم تحومون حولها، سأذهب لتقطيع الخضار لإعداد غداء زوجي قبل أن يجيء ويجدني قد أضحيتُ خرقاء بلهاء مجنونة أبسم من العدم»، لتنفجرُ بواريد الضحكات على نكات البدينة السمجة، وفجأة وعلى غير توقع تضطرب السماء فيلطّخ السواد المنفّرِ احمرار غسقها، أصوات قاسية لا يُدركُ مصدرها، لكنها حتمًا مهوّلة مدوية يبزغ من بينها صوت بشري أشبه بفحيح أفعى يقول : لابدّ أنّها الحرب، قد عادت من جديدٍ، يا ويح أمي، في حين كان الصوت الثقيل المريع في طريقه إليهم بما يحمل من مآس، إلتوت الأقدام وتعثّرت الأفئدة في الخطوات، وهمّوا بالفرار ولكن ما لبثوا أن سمِعوا صوت اصطدام مهيب يليه انبتار عنيف مخلتط بدوي انفجار وغرغرات دماء؛ فاستداروا بغريزة الإنسان الفضولي بغير ما إرادة، لقد كان رأس الفتاة، رأس كريمة معلّقة على شجرة الشمّام وجسدها يسبح في دمائه على الرغام، بينما فاءت الأفعى لفحيحها الحار : يا للتعاسة، لقد ماتت كميتة أبيها من قبل هذا، في نفس البقعة مع شمس الغروب بنفس السكون وصمت الجنون !
