قراءة في مختارات القاص جبير المليحان* (قصص من السعودية ( مختارات من الصوت الجديد)..
مقاربات نقدية لعدد من أعلام كتاب القصة القصيرة من المؤصلين والمجددين.
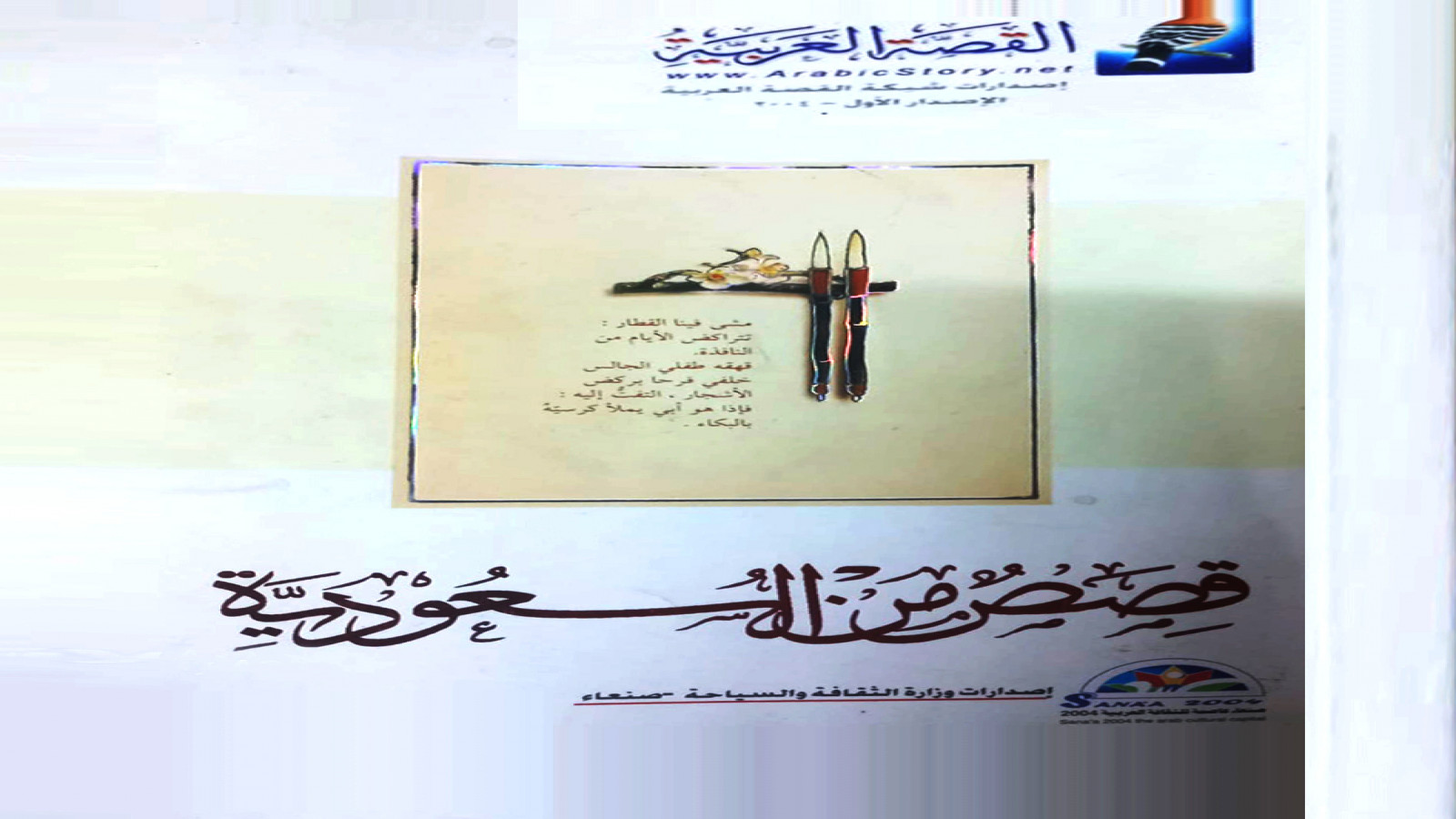
عثرت بين كتبي على كتاب كان قد أهداه إلي الصديق جبير المليحان كاتب القصة المرموق، ويضم جملة متميّزة من القصص القصيرة لكتّاب من جيل المؤصّلين والرواد لهذا الفن في المملكة العربية السعودية ؛ منهم جبير المليحان وعبد العزيز الصقعبي وهيام المفلح وعبد الرحمن الدرعان وعبد الحفيظ الشمري وسعود الجراد وإبراهيم النملة ويوسف المحيميد وفهد العتيق وعبد الله التعزي وعبده خال وخالد اليوسف ومحمد علوان وأميمة الخميس وأحمد الدويخي وأحمد بوقري وحسن حجاب ومحمد الشقحاء وعبد العزيز مشري وصالح الأشقر، وكوكبة أخرى لم يسعفني المجال لذكر أسمائهم فقد بلغ عددهم سبعين كاتباً، ورأيت من الوفاء لهم أن أتوقف عند بعض نتاجاتهم بين الحين والآخر ما وسعني الجهود وسنحت لي الفرصة. وأبدأ بقصة قصيرة جدًا لصاحب هذه المختارات (جبير المليحان) تحمل عنوان (ثلاثة) وتتألف من سطر ونصف في جمل قصيرة قليلة: “ مش فينا القطار .. تتراكض الأيام من النافذة، قهقه طفلي الجالس خلفي فرحا بركض الأشجار ‘ التفتُ إليه فإذا هو أبي يملأ كرسيه بالبكاء” وهذه القصة القصيرة جداً كتبت في وقت مبكر قبل صدور هذه المختارات عام،2004 أي في وقت لم يكن فيه هذا النوع من السرد قد انتشر عل نطاق واسع، وقد حمل جلّ خصائصه الفنية : اختزال الشريط اللغوي في أقل مستوياته النصّية من حيث الطول، ثم كثافته الدلاليّة (كلما ضاقت العبارة اتّسع المعنى) ومفرداته الثرية حدّ الرمز، وسياقه السردي المركّز والمجرّد من التفاصيل والزوائد، ووحدة الرؤية وانسجامها وعمقها : فلعله قصد ب(القطار) رحلة العمر ومُضيّ الزمن السريع (تراكضه) كما تتراءى الأشجار من نافذة القطار وفرحة الطفل واندهاشه، تعبيراً عن مرحلة الطفولة التي مضت وانقضت كما في قوله (الجالس خلفي) وتمثُّله لذاته بشخصية الأب وهو يبكي، حيث المصير والنهاية الواحدة (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو) والجميع ماضون إلى النهاية المنتظرة، لا مناص من ذلك. في قصته (الدهن) يذهب عبد العزيز الصقعبي مذهبا آخر جديد يبني قصته على النمط المشهدي الي يتراوح فيه الإيقاع بين الحركة والسكون والثرثرة والصمت، مشهد يستبطن فيه الكاتب أغوار النفس ويرصد الاستجابات الداخلية للحضور، تترجمها أقوالهم وفي الوقت ذاته، يستقرئ السياق الزمني للحدث ويلمّ بأبعاده الاجتماعيّة ويغوص في تحوّلاته التاريخية عبر جملة مركزيّة يردّدها “ من الأفضل أن تذهب معي إل الهند” وما توميء إليه من بعد ثقافي وسلوكي وحضاري لدى جيل بكامله، وهو يلتقط أدق الدقائق النفسية حين يبحر في نفس المتحدث (السارد بضمير الأنا) الذي يبدي اعتزازه بأبنائه (لاعب كرة القدم و المضيف) وإلى لجوئه للتمويه ومراوغهم عن حقيقة مهنة المضيف، وجعلهم يعتقدون أنه يعمل طياراً ؛ وهنا يلتقط بحساسية فائقة ما يدور في أعماقه. لقد بدأ من نقطة ارتكاز مألوفة في القصة القصيرة التي تبتعد عن المقدمات استنادا إل مقولة نقدية معروفة “ القصة القصيرة الجيدة محذوفة المقدمة “ فهو يدخل إلى ميدان السرد مباشرة فيروي ويصف، ثم يمضي إل ذروة الحدث مردّداً العبارة المركزيّة الرئيسة التي تتردّد في القصة “ القهوة اللي ما تتبهر من الهيل مثل ...” ولعله قصد هنا الحديث الي يحتوي عل التنميق والزيادة كما فعل السارد في حديثه عن ابنيه” ومبالغاته في الرفع من قيمتهما، وهذا بعدٌ نفسيٌّ خفيٌّ.، لقد جعل الكاتب الحوار موحياَ بمعانٍ ودلالات كثيرة، وكان العنوان الذي هو العتبة الأولى للنص (الدهن) محتشداً بالمغزى فالدهن غني بالدسم ولذيذ يجعل للطعام نكهة ؛ كما الأمر بالنسبة للكلام الحافل بالمبالغات، وجاءت النهاية كاشفة (بوصفها لحظة التنوير ) حيث مضى بحمولته (العمّة وصويحباتها) موغلا في عباب الرياض. في قصة هيام المفلح(رجل) رؤية نسوية تتمحور حول المفارقة بين الائتلاف و الاختلاف في المسألة (الجندرية) الثراء المادي والضعف الجنسي ؛ وثورة الطبيعة الأنثوية على سلطان المال والجاه الخاوي من مذخور الرجولة : حوار يقف عل التخوم الفاصلة بين خطاب الآخر وخطاب الذات (حديث النفس) تُعمل فيه الكاتب مخيالها الأنثوي فتتصور ما يدور في داخل نمط من الرجال يمتلك المال ولا يتّصف بصفات الذكورة، ويظن أنه قادر على استعاضة بالمال والجاه عن الطبيعة الرجولية والأصح (الذكورية)، وتقدم نموذجاً لما يتصف به ها النوع من صفات أخلاقية فظّة، وما يدور في داخله من هواجس، وترسم بالكلمات لغة الجسد الانفعالية، وتبدو القصة أقرب إل أن تكون مشهدا انفعاليا نموذجيا للفشل والسقوط ثري بالحركة وملتزما بالمثلث الأرسطي البنائي المعروف : البداية والذروة والنهاية. وفي قصة عبد الرحمن الدرعان (رسالة) ينحو كاتبها منحى آخر يتمحور حول بطلبتها (أطلال أنثى تائهة مشرّدة تبدو في شكل لوحة (بورتريه) تشكّلت وفق رؤية الفنان فبدت تمثالاً مجهول الهوية في ذمّة النهاية، تحمل على كاهلها أعباء الشيخوخة وقسمات الموت، يرصد حركتها عبر لقطات يصور فيها أحوالها وأطوارها ومآلاتها في سياقات، عبر الزمن الطبيعي والمنعطفات الاجتماعية الكبرى (زمن الطفرة) والبيئات المختلفة : تجمعات الأطفال وحارات العمال ان، ثم ما انتهت إليه على هامش الوجود، كمّا مهملاً تحمل رسالة مفعمة في نقدٍ وجوديٍّ مثقل، معبّّرا عن الالتزام بوصفه تياراً أدبياً يحمل رسالة واقعيّة ، يساير ما عرف عن القصة القصيرة بأنها فن اللحظات المتوترة و الأزمة وفن الجماعات المقهورة. والمصير الذي لاقته المرأة العجوز بطلة القصة تحمل رسالة اجتماعية واضحة . وفي قصته (أحلام مائية) يميط سعود الجراد اللثام عن خيبات الواقع ويحلم في إشباع شهوة إصلاح العالم كما كان يحلم الشاعر العربي الكبير صلاح عبد الصبور، فعمد إلى سرد أمنيات الإصلاح عبر ما كان يحلم به بطل القصة في لحظات الصفو والخلوّ بالذات منفرداً بها، واستعراض الآمال والطموحات : حلم الغنى والثراء في رغبة عروبية سامية لتحقيق الاستقلال التام عن النفوذ الأجنبي، والرغبة في التمتع ببكارة الطبيعة والنجاة من التلوّث ومعانقة الصفاء والنقاء، وحلم العطاء والوفاء للأرض والحب، حيث يحلم أن يكون فلّاحاً، ويستكمل أحلامه في أن يكون طبيباً يستأصل غرغرينا النفاق والفساد، وأن يكون فناناً ومعلماً وساحراً في تجليات لإصلاح العالم، يفضح الزيف والتآمر و الفساد، وهو نهج متجاوز في بناء القصة القصيرة يمسُ سقف الحداثة ويحافظ عل الصلة مع الأصول الجمالية. وفي قصة عبد الله التعزي ( حواف المرآة) وهي قصة قصيرة تتجاوز في شريطها اللغوي السطور العشرة تحمل رؤية فلسفية للوجود الإنساني في تمثل للحياة وطموحاتها وأحلامها وأزماتها يتمثل المرآة ة وفضاء للحياة محاصرا بإطارها يسترجع عبرها آماله وما اختزنته ذاكرته وكأنها بما تنطوي عليه علبة من العطور قذف بها زجاج المرآة فكان أن تخّطت الحواف وانتشرت خارج الإطار، وذلك ينطوي عل فكرة رئيسة مفادها أن أعمال الفرد لا تنحصر في ذاته بل تصيب ما حوله وينتشر عبقها في المكان كله . أما قصة أميمة الخميس ( الفتاة الصغيرة) رؤية فلسفية أيضاً تنطوي على حكمة بالغة ؛ اختارت لقصتها فتاة صغيرة ساحرة، وما السحر هنا سوى البراءة والبكارة ؛ فكلماتها تتجاوز المعنى الحرفي لتفترش دلالة حقيقية مجسدة بالشكل الطبيعي وحيزه المكاني، صدقاً وبراءةً : النخلة والشمس والبيت، وهي مفردات ثلاث تومئ إلى معان رمزية صادقة، يتّسع لها الحيز الذي يحيط بها، وفي ذلك نقد قاس لضيق الحياة بالحقائق وجمال الكون والكائنات ؛ وأنه لكي يتم تلافي العجز لا بدمن المرور عل العقل وإطفاء شعلة الخيال والعودة إلى مربع الأبجدية الأول بمعانيها الضيقة لأن ها العالم لم يعد يتسع لمساحة الكون ويضيق بالأحياء والأشياء وهو عالم تتراجع فيه المعاني وتنحسر الدلالات. وفي قصة محمد منصور الشقحاء (الأرض) ما يمكن أن يطلق عليها القصة القضيّة، ولكن هذه التسمية قد لا تفي بالغرض ولا تلامس المحور الرئيس في القصة ؛ فالقارئ في مواجهة ثلاثة فضاءات فيها، كلّها محاصرة تضيق بأصحابها : السجن ومبنى المدرسة والسيارة ؛ وهي - بدلالة الانغلاق فيها- تومئ إلى أجواء الأزمة و التوتّر، وهما السّمتان الرئيستان اللتان تتّصف بهما القصة القصيرة فضلاً عن البنية الدائرية للحدث ؛ فالسّرد يبدأ من إطباق الأزمة (لم يبق للسلام باب وانتهاء العام الدراسي وكف اليد عن العمل والوالدة الأرملة والطفل المولود أثناء وجود الشخصية في السجن) هذا التراكم الكمّي للمآزق يحدث تحوّلاَ كيفيّا انتهى إلى دخول السيارة إلى مأزق المكان المحاصر الحرف (يو ) وإحكام تداخل أصابع اليد اليسرى وأصابع اليد اليمنى للزوجين، حيث استحكمت دائرة الأزمة . هناك العديد من القصص التي تضمها هذه المختارات ولعل فرصة سانحة تتاح لأستكمل فيها ما بدأت. *مسؤول ومؤسّس شبكة القصة العربية.
