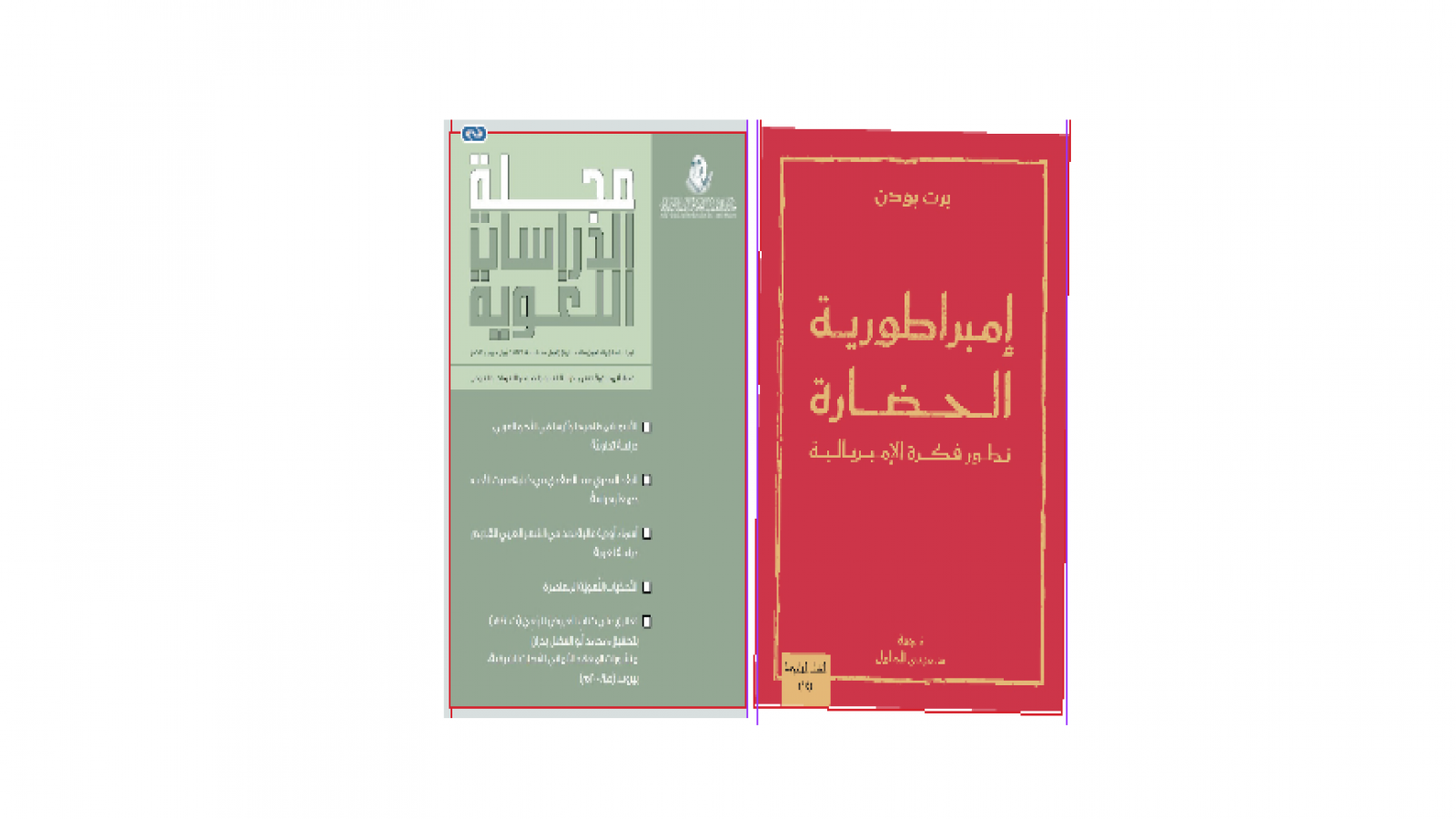
أصدر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ترجمة عربية جديدة لكتاب المفكر الأسترالي برت بودن المعنون بـ «إمبراطورية الحضارة: تطور فكرة الإمبريالية»، ضمن سلسلة الكتب المترجمة (رقم 14) التي يواصل المركز إصدارها، وجاءت الطبعة الصادرة في 1447هـ/ 2025م بترجمة من الدكتور موسى الحالول. ويُعَدُّ هذا العمل واحدًا من الإصدارات الفكرية البارزة التي تفتح أفقًا نقديًّا لفهم الاستخدام السياسي والثقافي لمفهوم «الحضارة» في العالم الحديث. وتأتي هذه الترجمة ضمن مشروع نوعي يتبناه المركز لإصدار ترجمات رصينة لمؤلفات عالمية تتناول المفاهيم الكبرى في الخطاب المعرفي المعاصر. ويهدف المشروع إلى رفد المكتبة العربية بنصوص تُمكّن القارئ من تفكيك البنى الأيديولوجية للمفاهيم المتداولة، مثل «الحضارة» و»الهوية» و»الحداثة»، خصوصًا حين تُستخدم لتسويغ السيطرة الثقافية أو السياسية. ويشكّل كتاب بودن مثالًا حيًّا لهذا التوجّه؛ إذ يعرض رؤية تحليلية متعمقة لنشأة فكرة «الحضارة» وتحوّلاتها، وارتباطها بالسرديات الإمبراطورية التي لا تزال تؤثر في تشكيل الوعي العالمي حتى اليوم. يستعرض الكتاب فكرة «الحضارة» بوصفها مفهومًا مشحونًا بمعاني التفوق والتراتب والهيمنة، لا بوصفها مصطلحًا ثقافيًّا بريئًا أو توصيفيًّا محايدًا. ومن خلال تحليل عابر للزمن والجغرافيا، يُظهِر المؤلف كيف تَحَوَّلَت «الحضارة» من فكرة فلسفية وأخلاقية إلى أداة أيديولوجية تُسخَّر لخدمة الاستعمار الكلاسيكي، ثم السياسات الإمبريالية المعاصرة. ويُركِّز على أن الخطابات الغربية، منذ عصر الأنوار حتى الحرب على الإرهاب، تُرسِّخ نموذجًا أحاديًّا يتعامل مع بقية العالم من منطلق التفوُّق الثقافي والمعرفي. الكتاب يَتتبّع كيف استُخدِمَت «الحضارة» بوصفها معيارًا حاسمًا في تصنيف الشعوب والدول، وتحديد من يملك أهلية الانضمام إلى النظام العالمي وفق النموذج الغربي، الذي يتضمن الديمقراطية الليبرالية، والرأسمالية، واحترام حقوق الإنسان. ويستعرض الكيفية التي سُوِّغَتْ بها مشاريع الاستعمار والتدخلات الغربية باسم «نشر الحضارة»، مستعرضًا مصطلحات، مثل: «عبء الرجل الأبيض»، و»تمدين الشعوب الأصلية» بوصفها واجهات خطابية لفرض الهيمنة. ويُظهر الكتاب أن النماذج المعرفية التي يقوم عليها مفهوم «الحضارة» لا تزال تُستخدم حتى اليوم بصياغات محدثة، بوساطة تعبيرات، مثل: «الدول المارقة»، و»محور الشر»، التي تُعيد إنتاج منطق التمييز بين «متحضّرين» و»برابرة»، وتُسهِم في فرض نمط حضاري معيّن باسم الديمقراطية، أو بناء الدولة. وتُشير أيضًا إلى أن هذه الديناميكيات تترافق غالبًا مع تحرّكات عسكرية، وتدخلات خارجية، وتدابير قانونية واقتصادية تؤطرها المؤسسات الدولية الكبرى. في خلفية هذا العمل يكمن حافز تأملي مُهِمّ: كيف تتحوّل الأفكار إلى أدوات سلطة؟ وكيف يمكن لمفاهيم مثل الحضارة والتقدم أن تكون، في بعض الأحيان، مصادر للظلم أو الإقصاء، لا التنوير والتحرر؟ هذا السؤال لم يكن نظريًّا فحسب بالنسبة للمؤلف، بل نبع من مشاهدات معاصرة، مثل: خطاب ما بعد أحداث 11 سبتمبر، وتصريحات القادة السياسيين عن «الحرب من أجل الحضارة»، وما تبعها من عمليات غزو وتدخل عسكري وثقافي في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا. ينطلق الكتاب من قناعة بأن المفاهيم ليست محايدة، وأن اللغة السياسية والفكرية تُعيد تشكيل الواقع. ويتبنّى منهجية متعددة التخصصات، تتقاطع فيها الفلسفة، وتاريخ الأفكار، والأنثروبولوجيا، والسياسة الدولية. ويعتمد على نحو خاص على تقاليد مدرسة كامبريدج في تحليل الخطاب السياسي، التي ترى أن فهم المفاهيم يتطلب دائمًا فحص سياقاتها وأدوارها العملية، وليس الاكتفاء بتعريفاتها النظرية. ما يميز هذا العمل هو ربطه بين تطور المفاهيم الكبرى وتطبيقاتها السياسية؛ إذ لا يكتفي بودن بتحليل خطاب الحضارة، بل يبيّن كيف أثّر هذا الخطاب فعليًا في رسم خرائط العالم وتقسيم الشعوب، كما يتتبع صدى مفاهيم مثل «نهاية التاريخ» لفوكوياما، و»صدام الحضارات» لهنتنغتون، مؤكدًا أنهما –رغم ما بينهما من اختلاف ظاهري– وجهان لنفس المشروع الهيمني الذي يسعى لترسيخ النموذج الغربي بوصفه ذروة التقدم الإنساني. الكتاب كثيف نظريًّا، زاخر بالمراجع والنصوص الغربية التأسيسية، من غيزو وكانط، إلى كينز وسكنر، ويغطي مساحة زمنية تبدأ من الحروب الصليبية إلى الإمبريالية الليبرالية في العصر الراهن. لكنه، في الوقت ذاته، يُنذر بأن كثيرًا من السياسات المأساوية لم تكن ثمرة نيات شريرة، بل نتيجة مباشرة لتطبيق أفكار خاطئة أو مغرورة. ومن هنا، يخلص الكتاب إلى أهمية مساءلة «سلطان المفاهيم»، ولا سيما عندما تُستخدم لتوجيه مصاير الشعوب باسم العقل والتقدم. «إمبراطورية الحضارة» ليس كتابًا تاريخيًّا تقليديًّا، بل مشروع فكري يُعَرِّي القوة الكامنة في اللغة، ويدعو القارئ العربي إلى إعادة النظر في المفاهيم التي يتلقّاها بوصفها بديهيات، بينما هي في واقع الأمر أدوات صراع ناعم يُدار بأكثر العبارات تهذيبًا. تسويةٌ نحوية وأوديةٌ شعرية وتحدياتٌ رقمية.. عدد جديد من «الدراسات اللغوية» يربط التراث بالتحليل اللساني الحديث. أصدر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية العدد الرابع من المجلد السابع والعشرين من مجلة الدراسات اللغوية. وقد حمل العدد، الصادر في شوال – ذي الحجة 1446هـ (إبريل – يونيو 2025م)، تنوعًا لافتًا في الموضوعات والمعالجات، عاكسًا انفتاح المجلة على المقاربات الحديثة من جهة، ووفاءها للتراث العربي من جهة أخرى. افتتحت المجلة عددها بدراسة تداولية قدّمتها الباحثة أفراح بنت علي المرشد، بعنوان: «التسوية مظاهرها وأثرها في النحو العربي»، وقد تناولت فيها ظاهرة لغوية دقيقة هي «التسوية» من منظور نحوي تداولي، محلِّلة بنيتها التركيبية ومدى تأثرها بسياقات القول وحروف العطف، مع العودة إلى تنظيرات سيبويه والمحدثين. أما الدكتور أحمد بن عبدالله القشعمي، فقدّم دراسة توثيقية نقدية، بعنوان: «النقد النحوي عند الصفدي في كتابه: غيث الأدب»، جمع فيها نصوص الصفدي النحوية، محلِّلًا رؤيته في قضايا الخلاف النحوي، ومبرزًا منهجه وأدواته البلاغية واللغوية في نقد النحاة السابقين. وفي حقل اللغة والبيئة الجغرافية، جاءت دراسة لمياء بنت حمد العقيل، بعنوان: «أسماء أودية عالية نجد في الشعر العربي القديم»، حيث كشفت عن أصول هذه الأسماء في الذاكرة الشعرية، ودرست علاقتها بطبيعة المكان وتاريخ القبائل، واستعارتها من لغات غير عربية، ثم تحولها إلى أعلامٍ وصفية في النصوص الشعرية الجاهلية والإسلامية. وفي مواكبة للعصر، ناقشت الباحثة سمر روحي الفيصل أبرز «التحديات اللغوية المعاصرة»، منبهة إلى التحولات التي طرأت على العربية في ظل البيئة الرقمية الحديثة، ومقترحة أدوات عملية؛ لإعادة تمكينها في المجالات الإعلامية والتعليمية والتواصلية الجديدة. واختُتم العدد بدراسة عروضية مميزة للباحث عمر خَلّوف، بعنوان: «تعاليق على كتاب العروض للربعي (ت: 420هـ)»، بتحقيق محمد أبي الفضل بدران، قدّم فيها قراءة تحليلية للتعاليق النادرة التي دوّنها الربعي على متن العروض، وهو ما أضاء جوانب مهملة من تاريخ الدرس العروضي العربي. يُذكر أن مجلة الدراسات اللغوية تصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وهي فصلية محكَّمة تُعنَى بدراسة النحو والصرف واللغويات والعروض، وتحرص على نشر البحوث الأصيلة التي تتسم بالجدّة والمنهجية.
