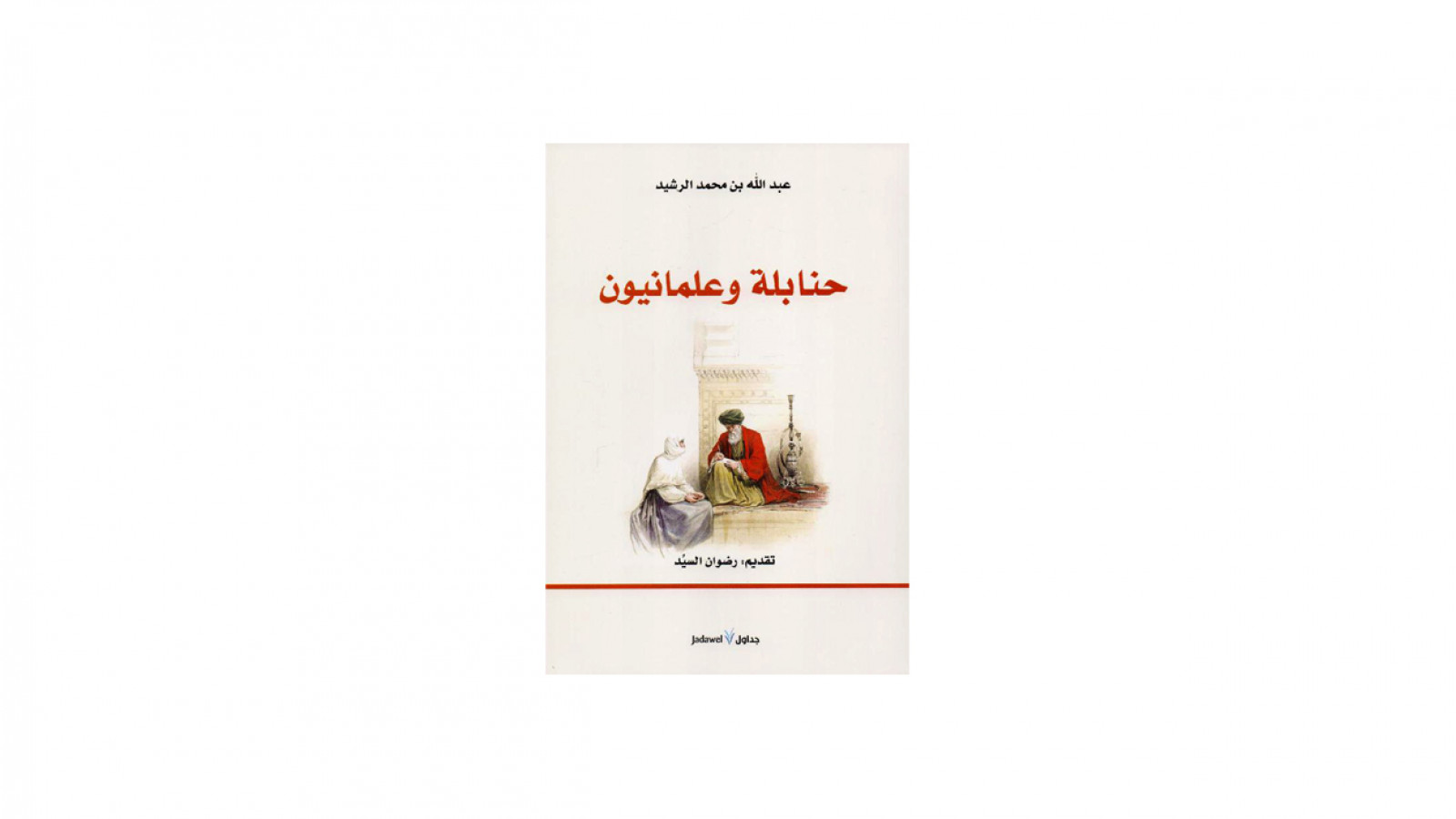
كتاب من تأليف عبدالله بن محمد الرشيد، وهو كما في ترجمته أستاذ بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، أما رسالته للدكتوراة “ المدينة الفاضلة في الفكر الغربي الحديث”، وبالتالي فإن ثقافته واسعة الطيف مع أساس شرعي إسلامي، وهذا ما يكسب كتابته قوة، وتحليله ذكاء ومصداقية. كما أن نشاطه ككاتب صحفي انعكس في رشاقة مقالاته وقدرتها على قدح الأذهان بما فيها من إثارة. عنوان الكتاب صادم، كما أشار إلى ذلك رضوان السيد الذي كتب تقديما للكتاب، وفسر لنا العنوان بأنه يشير إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في العلاقة مع السياسة والحاكم، وهو مذهب فاجأني باعتبار أن ابن تيمية تلميذ ابن حنبل من الذين يشار إلى فكرهم كثيرا عند الحديث عن الحكام. هنالك أربعة أقوال لابن حنبل تشير إلى اعتزال الشأن السياسي، وبطاعة السلطان وإن جار، وبالصلاة وراء كل إمام والجهاد مع أي أمير. ويتابع رضوان السيد أنه يعرف من سيرة الإمام أحمد أنه رغم محنته فقد ظل شديد الولاء لأمراء المؤمنين، وقد نصح أحمد بن نصر الخزاعي بعدم التمرد، كما أنه بعد انتهاء المحنة رفض محاولة السلطة التقرب منه، وغضب على أولاده الذين قبلوا عطايا السلطان ومناصبه، ويستنتج السيد على حق أن منطقه كان الفصل بين الشأن الديني والشأن السياسي، وليس بين الدين والدولة، كما هو مبنى العلمانية ومعناها الحديث. مقالات الكتاب تظهر في العنوان نوعين من المفارقة، الحنابلة بعد الإمام أحمد تدخلوا كثيرا في السياسة، وعلى الجهة الأخرى هناك حنابلة عديدون عبر التاريخ كانت لهم مواقف يمكن اعتبارها ليبرالية أو تحررية في مقاربة الشأن الديني. وفي مقدمته للكتاب يشير الرشيد إلى ضرورة تقريب قضايا التراث و تفكيكها، وطرح إشكالياته القائمة على أرض الواقع بصيغة تبحث عن المعرفة، وتنشد الحقيقة بحد ذاتها دون مآرب أو غايات فئوية أو طائفية، وهو أمر يعزز قيمة البحث العلمي، ويساعد على جلاء الصورة والنظر الموضوعي، ويدفع نحو فهم أشمل للتراث، وحيث أنه لا يملك أحد احتكار التراث فهو فضاء مفتوح، قد يجد فيه المتطرفون شواهد تدعم موقفهم، ويجد المتسامحون كذلك شواهد تدعمهم، وفي نظري فإن مقاربة الكاتب لقضايا التراث تساعد القارئ على تكوين رأيه بعيدا عن الانحيازات المسبقة. في الفصل الأول عن الحنبلية الأولى ينقل عن مايكل كوك، وهو مستشرق متخصص في تراث الإمام أحمد، إلى أن ابن حنبل أبقى نفسه على مسافة واحدة من الخلفاء سواء من أكرموه أو من ناصبوه العداء، بقي بعيدا كل البعد عن السياسة، رجل مدني بامتياز، لا يري استخدام السلاح، ولا القوة في المواجهة وتغيير المنكر. يعقب الرشيد بأن أحمد كان حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه وضع شروطا متشددة تتسق مع نهجه النابذ للانخراط السياسي، أو إثارة الفتنة والجلبة، بل وصل به الحال إلى القول أن ظروف الزمان ومراعاة الأحوال تستدعي التخفيف على الناس في إنكار المنكرات، ومن المتفق عليه تقريره الواضح لحالات يسقط فيها وجوب النهي عن المنكر، كممارساتٍ من قِبل اقتحام بيوت الناس عنوة، أو انتهاك حياة الناس الخاصة. من جاء من الحنابلة بعد الإمام أحمد لم يبق على تعليمات المؤسس الأول، وقد أسس أتباع البربهاري - أحد رموز الحنابلة - حركة شعبية لإنكار المنكرات بالقوة، وقد وُصفوا في بعض كتب التاريخ بمثيري الشغب والفتنة. ويعزو الرشيد ذلك إلى الاحتقان الناشئ عن الصراع المذهبي آنذاك، السنة - الشيعة، والحنبلي- الشافعي، والحنبلي- الأشعري- المعتزلي. وفي فصل عن الوعظ بعنوان (الوعظ: تلك المهنة المحتقرة في التراث الإسلامي) يحاول المؤلف تحليل ظاهرة انتشار الخطاب الوعظي الذي لا يقوم به علماء على علم كاف بالشريعة، خاصة في ظرف تعددت فيه وسائل التواصل الجماهيري، و أصبحت تستوعب كل من يعظ، خاصة إذا أجاد أساليب التواصل دونما إجادة للعلوم الدينية، ويزيد من المشكلة أن الظروف المستجدة أتاحت للتنظيمات السياسية قدرا من الشعبية عبر الخطاب الديني، فتصدر له من يحسن الوصول للناس دون أن يكون مؤهلا للحديث الشرعي، وترافق ذلك مع الازدراء بعلماء انعزلوا من أجل العلم أو عزلتهم الجماعات التي لم تجد منهم الكثير من التفاعل، خاصة وأن ميكانيكيات التجمعات السياسية لا تضع علماء الشريعة على رأس هذه التجمعات، ويشير الكاتب إلى أن مهنة الوعظ كانت مهنة محتقره في التراث الإسلامي، رغم أن أصلها غير مذموم فقد أشارت الأحاديث إلى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة، ونشأت على يد بعض العلماء كتب عظيمة في الوعظ مثل كتاب ابن القيم (إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان) وكتاب الغزالي (إحياء علوم الدين), ثم تحول الوعظ إلى فن قائم بذاته ومهنة اقتحمها الجهلة وضعاف العلم ممن أُطلق عليهم وصف (القًصاص) تمييزا لهم عن العلماء المعتبرين، وهنا بدأ هجوم العلماء الأوائل ونقدهم اللاذع للوعاظ، وخُصصت لنقدهم كتب مهمة مثل كتاب (تلبيس إبليس) لابن الجوزي. وكتاب (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) للسيوطي. ويعتقد المؤلف أن أنشطة الصحوة قد ساهمت في ترويج هذا النوع من الوعاظ، فقد كانت مشاريعها تُبنى على الأنشطة الدعوية التي تعنى بالضرورة عدم الانكفاء على المسجد، بل الخروج إلى أماكن الناس و تجمعاتهم، واستجلابهم بخطاب تشويقي ترغيبي ترهيبي، ومن هنا انتعش الخطاب الوعظي القريب من حديث القُصاص في الماضي. أحد فصول الكتاب تحدث عن تراث الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، الذي عًرف عند الناس بعمله في قطر، ولكنه كان أحد علماء السلفية في نجد، تتلمذ على أيدى أبرز فقهائها ومنهم المفتى الشيخ محمد بن إبراهيم، الذي أرسله ضمن مجموعة من أبرز تلامذته للوعظ والتدريس بمكة، وبناء على طلب أمير قطر الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني، انتدبه الملك عبد العزيز ليصبح قاضيا ومفتيا ومعلما ومؤسسا للمؤسسة الدينية والقضائية الحديثة في قطر. أولى القضايا التي تبناها الشيخ آل محمود وأثارت جدلا هي” لا مهدي يًنتظر بعد الرسول محمد خير البشر” ويعقب أن العجيب في أمر المهدية أنه رغم شيوعها كعقيدة إسلامية، إلا أن جميع العلماء والعوام في كل زمان ومكان يقاتلون كل من يدعي أنه الإمام المهدي، لاعتقادهم أنه دجال كذاب، يرى الشيخ أن مسألة المهدي ليست من أصل عقائد أهل السنة، ولم يقع لها ذكر بين الصحابة في القرن الأول، وأن أول من تبنى هذه الفكرة هم الشيعة ثم سرت منهم إلى أهل السنة. وقد أثار موقفه جدلا كبيرا وتوالت الردود عليه من علماء المدرسة السلفية في السعودية، وبقي الرجل على رأيه. الفتوى الثانية التي أغضبت علماء الرياض كانت عندما أفتى بجواز الرمي قبل الزوال، نظرا لحاجة الناس وشدة الزحام ورفع المشقة. وقد أثارت هذه الفتوى ردة فعل كبيرة لدرجة أن الشيخ ابن إبراهيم قال إنه كتب يذكر هذه الزلة لولى الأمر، رجاء أن يقوم مقام الرادع لهذا الإنسان. وعليه قام الملك سعود بن عبدالعزيز بمراسلة حاكم قطر طالبا إيفاد ابن محمود لمناظرة علماء الرياض. وفي المناظرة طلب المشايخ منه التراجع عن فتواه وأن يصدر كتابا توضيحيا بهذا الشأن، و نًقل عن الشيخ ابن إبراهيم أن الشيخ آل محمود قد أظهر الندم وصرح بالتوبة، وقد قُبل منه ذلك، وطًلب منه تأليف رسالة تتضمن رجوعه عن فتواه السابقة، ووعد بأنه إذا ما عاد إلى بلده قطر فعل ذلك. لكن مرت الأيام والشهور ولم يصدر عن الشيخ آل محمود شيء، وكتب الشيخ ابن إبراهيم منددا بهذا الموقف. على أن الرشيد يورد رواية أخرى لما حدث منسوبة للشيخ زهير الشاويش، صاحب المكتب الإسلامي في بيروت، وهو ناشر الكثير مما مولته دولة قطر من كتب اسلامية، قال الشيخ زهير أن آل محمود قد جاء بما يعزز رأيه بالآيات والأحاديث وآراء بعض العلماء، وكان رد علماء الرياض معتمدا على أقوال متأخري الحنابلة، ولكن تكاثر المشايخ عليه وهو يقول: ردوا عليِّ، وبعد إلحاح وإحراج سكت الشيخ، وقام من قال إنه تراجع وأنه سيكتب رسالة برجوعه، وخرج الشيخ ابن إبراهيم منهيا الجلسة. وإنما سكت الشيخ ال محمود عن المجادلة احتراما لأستاذه ابن إبراهيم ولم يزد على أن قال: سأنظر في أمري. اليوم نلاحظ أن فتوى الشيخ قد أصبحت متبعةً عند الكثير من الحجاج. والمسألة الثالثة في الاختلافات الفقهية بين الشيخ آل محمود وشيوخه هو ما كتبه بعنوان (الجهاد المشروع في الإسلام) دافع فيه عن رأي ابن تيمية الذي يقول أن القتال في الإسلام إنما شُرع دفاعا عن الدين، ودفع المعتدين، وأن قتال الكفار إنما هو لأجل عدوانهم لا لأجل كفرهم، وقد ساق ابن تيمية و آل محمود الكثير مما يدلل على كلامهم. الطريف أن رأي ابن تيمية قد ورد في رسالة له بعنوان (قاعدة في قتال الكفار ومهادنتهم، وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم) وقد ظن كثيرون أنها مزورة شاذة عن فكر شيخ الإسلام، واضطر الشيخ عبدالرحمن بن قاسم الذي أوكل إليه الملك سعود مهمة جمع فتاوى ابن تيمية إلى إسقاط هذه الرسالة من مجموعه. ولكن الشيخ عبدالعزيز ال حمد في عام ٢٠٠٤ قام بتحقيق الرسالة وإعادة طباعتها وكتب في مقدمة تحقيقه “إن رسالة ابن تيمية المختصرة أبلغ رد على من يتهم هذه الدولة المباركة، أو دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية أو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالإرهاب أو الحصول عليه. وقد أورد الكتاب مسألة أخرى حول إباحة الغناء، وكانت مما خالف فيه الشيخ آل محمود شيوخه في نجد، ولا شك أن مرور الزمان يبين الكثير من الظروف التي تنعكس على فهم الشريعة وطريقة إيقاع أحكامها، وهذا من اليسر، إذ لا يستطيع أحد احتكار تفسير أحكام الشريعة، رحم الله الجميع أحياء وأمواتا.
