لحظة بين القصيدة والحياة.
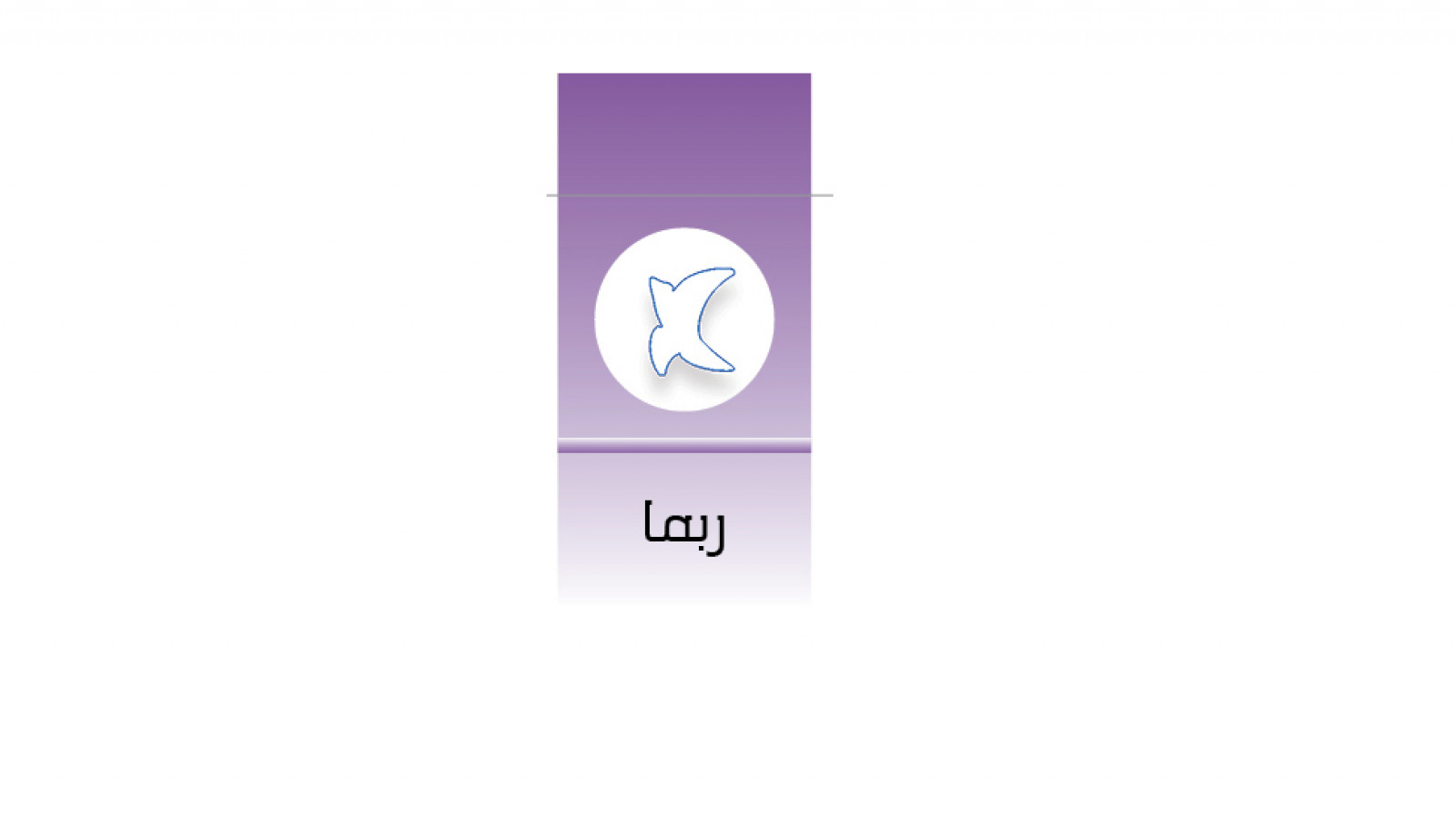
أقرأ هذه الأيام “أنا قادم أيها الضوء” لمحمد أبو الغيط، كتابٌ يغرق بالألم ويفيض بالأمل، تناوبت الأضداد بين سطوره حتى حارت اللغة نفسها وبكثافة المعنى. توقفت طويلًا عند حديثه عن محمود درويش في أواخر حياته، حين قال: “توقف محمود عن كتابة القصائد الخطابية، بل رفض إلقاء سجل أنا عربي رغم إلحاح الجمهور، لأنه كان يرى أنه تجاوزها، وبدأ يكتب عن معانٍ أبسط… وأعمق في آن واحد”. ثم أشار إلى آخر قصيدة كتبها درويش قبل رحيله، والتي احتفت بحلم عشاء بسيط بين ثلاثة أصدقاء: “إن كان لا بُدَّ من حُلُمٍ، فليكُنْ مثلنا… وبسيطاً كأنْ: نَتَعَشَّى معاً بعد يَوْمَيْنِ نحن الثلاثة، مُحْتَفلين بصدق النبوءة في حُلْمنا وبأنَّ الثلاثة لم ينقصوا واحداً منذ يومين…” تأملت هذه القصيدة طويلًا… هل كل المعاني التي نطاردها، كانت بحوزتنا منذ البدء؟ وهل كل هذا الضجيج والوجع لندرك أن لا قواعد للحياة سوى أن نحتضنها كما هي؟ نركض خلف الأجوبة، ثم نكتشف أنها كانت بقربنا، تجلس في صمتٍ، تلوّح لنا وسط محادثة مع طفل وديع، أو من ضوءٍ يتسلّل بين أوراق شجرة، من قمرٍ مكتمل خلف نافذة، من طريق سفرٍ طويل، أو شجرة وحيدة في منتصف الصحراء، من ضحكة الوالدين، واكتمال العائلة، ومن صدق الأصدقاء، ومن متعة العطاء، من لطف الغرباء، وحنو الاقرباء، من كرم الحضور… وحكمة الغياب. تأملت في وجوه أولئك الذين شابت رؤوسهم ولحاهم، ممن عاشوا انقلابات فكرية واقتصادية واجتماعية تفوق ما نعيشه اليوم، وما زالوا يحرسون الدهشة كما يهدهدها الأطفال. إذن هل الحياة تصغر في أعيننا كلما كبرنا؟ أم أن معناها لا يُكشف إلا عندما نُعجز عن الإمساك به؟ هل كل هذا السعي والتخبط والمقاومة، إلا طريقٌ طويل، نعود في نهايته إلى أنفسنا؟ هل نحن في سجالٍ مع الحياة، فقط لنكتشف في آخر الجولة أننا كنّا نحاول احتضان ذواتنا الأولى؟ أن تنظر إلى السماء فتلقى فيها الحكمة، أن تطأ الأرض فتفهم سر الطين، أن تسند ظهرك إلى جذع شجرة فتولد في روحك الأسئلة، أن تراقب طائرًا… فيحملك إلى خيالٍ لا يُعاش، أن تعيش في نفسك ألف قصة دون أن تنبس بكلمة، أن تبقى الأسرة، ألا يطول غياب الوالدين، أن تنام بعد أن تذكر كل من تحب ومن أحبك. أننا لا نشيخ بالعمر، بل بمقدار ما تأخذه الحياة منا، وما تلزمنا به. نشيب حين تتناقص الأسرة، حين يغيب الوالدان، حين تتبدل القيم الكبرى، حين تغلبنا الفوضى، حين تستنكرنا الحقيقة، حين تتشوه الذكرى، حين نشهد غربة الروح ووحدة الشعور، وحين تقلّصنا الحياة، وتدفعنا بعيدًا، لنستفيق. لأننا ببساطة، كما قال درويش في لاعب النرد: “ومشى الخوفُ بي ومشيتُ به حافياً، ناسياً ذكرياتي الصغيرة عمّا أريدُ من الغد… لا وقت للغد” نركض ونسقط، ننسى ونتذكّر، نحاول وننهار، ثم ننهض من جديد. لا دور لنا أحيانًا، سوى أن نتناغم مع طَروب الحياة، أن نكمل الطريق بحفاوةٍ رغم التردد، والخوف، والوحدة والوجع… أن نحتضن الحياة حين تضحك وحين تقسو، لأنها – في حقيقتها – لم تكن يومًا علينا، بل كانت لنا، غاضبةً أننا لم نحبها كما هي، ولم نرها كما علينا أن نرى.
