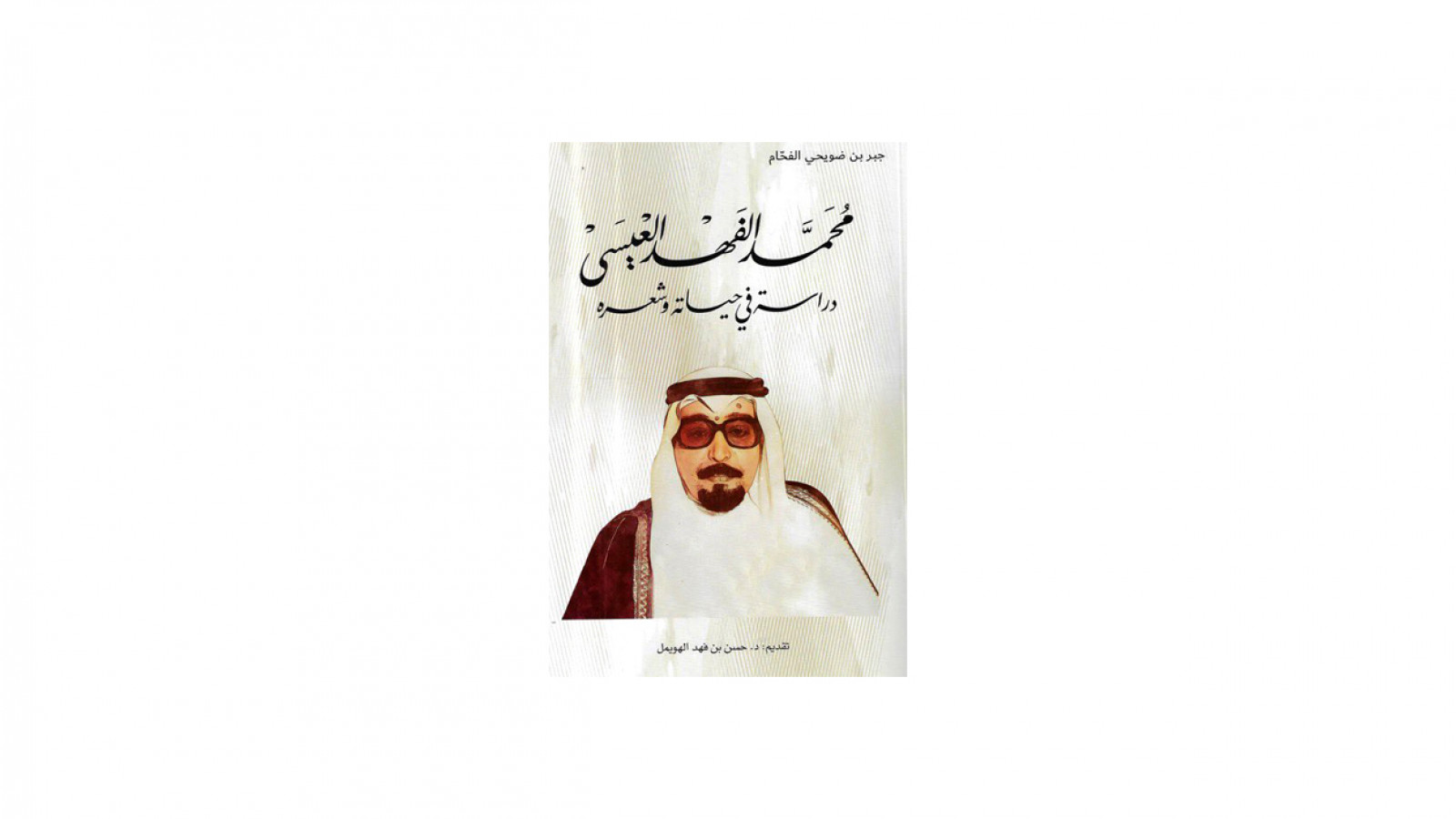
لم اقرأ منذ فترة كتابا عن الشعر، لكن هذا الكتاب بسهولته وإحاطته بالموضوع الذي يتحدث عنه أعاد إلي اهتماما قديما بالشعر. والكتاب في الأصل رسالة ماجستير للمؤلف، جبر بن ضويحي الفحام، وقد لفت نظري عنوانه الفرعي، دراسة في حياته وشعره، وقد عني الكاتب أنه حاول أن يكشف عن تأثير حياة الشاعر محمد الفهد العيسى في شعره، أكثر منه كتابة نوع من السيرة الغيرية عن الشاعر. الدكتور حسن بن فهد الهويمل في تقديمه الكتاب ذكر أن “ميزة هذه الرسالة أنها لم تنطلق من النص لتبحث في عوالم الشاعر، ولكنها انطلقت من عوالم الشاعر لتضيئ عتمة النص…، وقد يكون هم الدارس اكتشاف حياة الشاعر من شعره، أو اكتشاف شاعريته من خلال حياته، والدارس عول على الهمين معا، فكان أن قدم الشاعر والشاعرية”. أما طباعة الرسالة في كتاب وتقديمها للقارئ فجاء استجابة لطلب الدكتورة إيمان العيسى، المهتمة بجمع آثار والدها، وهو سعيٌ محمود. الشاعر العيسى غزير الإنتاج، ورغم أن مادة شعره الأساسية كانت رومانسية، إلا أنه لم يدع غرضا من أغراض الشعر لم يطرقه استجابة لحالته الوجدانية، فقد كتب ديوانين عن الثورة الجزائرية، لكنهما لم يطبعهما، وله ديوان كامل عن فلسطين (حداء البنادق) وكتب في الرثاء وفي الإخوانيات، وله أشعار مغناة لعل أشهرها قصيدة “ أسمر عبر” ذائعة الصيت والتي تغنى بها مطربون ومطربات من داخل السعودية وخارجها. كما أنه كتب برنامجا مهما للتلفاز عن الفنون الشعبية في الجزيرة العربية، أعتقد أن مادته ستبقى مرجعا للباحثين في هذا المجال. الكتاب الذي بين أيدينا درس انتاج الشاعر وشرح قصائده، فصل في موضوعاتها، وبحورها، وصورها البلاغية، وجملها الإنشائية والخبرية، كما تتبع الكسور في بعض أوزانها، والتجاوزات اللغوية، والألفاظ الغريبة سواء تلك التي أضاءت السياق أو الأخرى التي أرهقته، والصور البسيطة أو المركبة، والاستعارات التصريحية والمكنية. وإذاً فإن الكتاب يصلح مرجعا يأخذ بأيدي محبي الشعر إلى التذوق الممتع لهذا الفن قديمه وحديثه. أسرة الشاعر أسرة نجدية من العقيلات، التحق والده في سلك الدولة السعودية الناشئة خلال مرحلة التأسيس وعمل مرافقا لأمير الشرقية ابن جلوي، ومرافق يعنى أنه رجل كل المهام التي ينتدبه لها الأمير، انتقل بعدها ليعمل مع الأمير (الملك) فيصل في الحجاز ورافقه في حرب اليمن ثم استقر به المقام في الطائف مع أسرته. قبل استقرار الأسرة في الطائف أقامت في المدينة بجوار أهل الأم نظرا لطبيعة مهمات الوالد وتنقلاته، أتاح هذا للطفل الانتظام في كتاتيب المسجد النبوي، ثم الدراسة النظامية، وأخذ من كليهما. بينما كان يلقي إحدى القصائد لاحظ أستاذه أنه استبدل عجز أحد الابيات بجملة من عنده على نفس الوزن والقافية، وتبين للأستاذ أن تلميذه قد نسي أصل البيت واستبدل به كلمات من تأليفه دون وعي، فبشره الأستاذ بالشاعرية، وحين بدأ يكتب الشعر نصحه أستاذ آخر بالكتابة باسم مستعار، إذ أن من يعرف أن الشعر لشاعر لم يتجاوز الخامسة عشرة قد ينتقص من شعره، وبالفعل فقد بدأ الكتابة والنشر بأسماء مستعارة، وتعاهده خاله بالتوجيه، وكان خاله أمينا لمكتبة الحرم، فأتاح له ذلك قراءة الكثير من الكتب، وقد قاده حب القراءة إلى الصحافة المصرية التي اطلع عبرها على الشعر الحديث، واجتذبه الشعر الرومانسي، وكان تأثير الشاعر أبو القاسم الشابي عليه عظيما، أغرق الشاعر الناشئ في الرومانسية وخيالاتها، وتعمق في القراءة عن الثقافات الحديثة والعالم الجديد بكل جاذبيته ومناهجه وتفوقه، مع ما يحمله من نُذر التمزق الإنساني أمام الآلة، وكذلك الحساسيات تجاه هذه التوجهات الحديثة من سدنة القيم والتقاليد التي هابت هذا المستجد في حياتها بسطوته، كل ذلك ظهر في قاموس الشاعر شعورا بالغربة و حنينا للطبيعة. خلق ذلك في مبدأ حياته نوعا من الابتعاد عن هموم مجتمعه، مما جعل الشاعر “محمد حسن عواد” يكتب مقالا يدعو فيه الفهد التائه (أحد الألقاب التي تخفى خلفها الشاعر) إلى العودة إلى مجتمعه. ولاحقا جعله قاموسه الرومانسي عرضة للنقد والاتهام الديني، مما أدى ذلك إلى إيقافه عن وظيفته في وزارة العمل، والتزامه بيته الذي أصبح مقرا لندوة ثقافية في الرياض، وبعد هدوء الزوبعة عمل في سلك السفراء، قضى سفيرا ثلاثين عاما، وقادته السفارة إلى كل دول الخليج باستثناء الإمارات، وإلى الأردن وموريتانيا، كما أصبح عضوا في مجلس الشورى. كل هذا يعنى أن الشاعر عاش في طبقة النخبة واليسار، وكان مستقرا في حياته العائلية، مما يجعل المراقب يستغرب كثرة الوجدانيات في شعره وحديثه عن الحرمان والمشاعر الشبيهة، ولكنه جموح خيال الشاعر، كذلك نراه لم يحفل بشعر المناسبات الذي كان له حضوره عند كثيرين أيامه. يخلص الباحث أن سمات مشواره الشعري في مراحل البدايات تجلت في: أولا: الجرأة في التناول؛ إذ لم يكن معهودا قبله تقديس الحب، ووصفه بأنه سر الوجود و حياة القلوب، فقد أعلن العيسى عن حبه الملتاع، وشوقه الملتهب وولعه المضطرم المصحوب بالبكاء والأنين والألم والدموع، وقرن ذلك بأشعار الضياع والهروب والاغتراب، ودخل في قاموسه الشعري مفردات الانتحار والعيش بين القبور، والعزلة في المتاهات، ومصاحبة الوحوش، والسير إلى ما وراء الغيوب. ثانيا: توهج العاطفة وحرارة البوح، الشاعر يطلق العنان لعواطفه تبوح بما تشاء، وهذا يزيد تفاعل القارئ مع الشعر، ثالثا: التجديد في الموسيقى، تجد عنده التنويع الموسيقى والمراوحة بين القوافي وتوزيع التفعيلات بشكل منتظم، ومن سمات شعره رقة الألفاظ وسلاستها، والبعد عن التكلف والتعقيد، ويظهر أن تأثره بالثقافات الوافدة كان أقوى من تأثره بالتراث. بعد ثمانية عشر عاما من المرحلة الأولى التي انتهت بقصيدته “الطبيعة الخرساء” عاد الشاعر بتجربة أخري فقد تجاوز مرحلة التقليد واستقل بتجربته، وأصبحت عواطفه كما تبدو في شعره أكثر اتزانا ، وأهل الأدب ما زالوا يعدونه الجسر المتين الذي عبرت من خلاله الحركة الشعرية في السعودية من التقليد إلى التجديد، ورغم استمرار سيره في الاتجاه الوجداني إلا أنه خرج عن ذلك في ديوان “حداء البنادق”، تلك تجربته في التفاعل مع ما يحدث في فلسطين وقد برزت أصالة شاعريته، وقد وصفه د. الحامد في كتابه الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن “ لا يُبارى في الصدق والقوة والعمق، إذا تحدث عن القيود والسجن والأغلال، التي يشعر بها شعورا قويا، تحد من انطلاقه، وتوثق رجليه إلى الأرض، ويداه مغلولتان إلى صدره، وأحسبه أقدر شاعر في البلاد تحدث عن آلام الحياة وتبرم بها”. ويختم بالقول: إن للأدب رسالة إنسانية ووظيفة سامية في الحياة، يجب أن يؤديها الأديب بعد شرط الإبداع. ورغم كل ما يقال عن شيوع مشاعر الغربة في شعره فإن حنينه لمغاني الطائف، ومغاني نجد تلك التي تنتعش بنزول المطر، لا يفوقه أي حنين، وكثيرا ما يذكرها في شعره محتفيا ومشتاقا. وأكثر موضوعات شعره الغزل، وبالتالي يدور حول المرأة، والتعلق بالمرأة عنده وعند الكثير من الرومانسيين حب لذات الحب، نقى لا تدنسه المعاصي، حب عفيف طاهر، وإن لم يخل شعره من غزل حسي إلا أنه قليل، ليس فيه التبذل الذي اشتهر عند البعض مثل نزار قباني، ومحمد حسن قرشي. وهو كأكثر الشعراء العرب قليل الالتفات إلى مشاعر المرأة وأفكارها وآلامها وآمالها، مشاعره ورغباته هي المسيطرة، وهو صاحب الحديث والكلمة وليس للمرأة حق المشاركة. يقول الناقد رجاء النقاش أنه “رغم الطابع العصري للتجديد في الأداء الفني عند الشاعر العيسى، إلا أننا نحس ونحن نمضي في عالمه الشعري بيتا بعد بيت وقصيدة بعد قصيدة، أن هذا الشاعر يجسد أمامنا الروح العربية في أصالتها وتجددها معا” وقد زاوج العيسى بين الغموض الشفاف والوضوح المباشر في قصائده. راوح العيسى بين خمسة أنماط من الموسيقى الخارجية: القصيدة الخليلية، والقصيدة ذات القوافي المقطعية (موحدة البحر مختلفة القوافي) , نظام التوشيح، القصيدة التفعيلية، والقصيدة النثرية، ولكن الطابع العام هو أن اهتمامه بالموسيقى الداخلية يفوق اهتمامه بالموسيقى الخارجية. استوقفتني الكثير من أشعار العيسى، ولعلي أشارك القارئ في قراءة هذه الأبيات الطافحة بالشجن: أين يا حفار قبري هو من تلك القبور؟ أهو في أفناء دوح أم تُرى بين الصخور؟ ليكن في بطن وادٍ حوله ماء غدير حولها أغصان أيك فوقها تشدو الطيور. وهذه الأبيات تذكرني بأبيات عبدالله بن إدريس: أأرْحَلُ قَبْلكِ أمْ تَرْحَلين؟ وتَغرُبُ شَمْسي أمْ تَغرُبين؟ ويَنْبَتُّ ما بيننا من وجود ونسلك درب الفراق الحزين. الرحيل حق علينا جميعا، رحم الله الشاعرين وجعلهما في روح وريحان وجنة رضوان.
