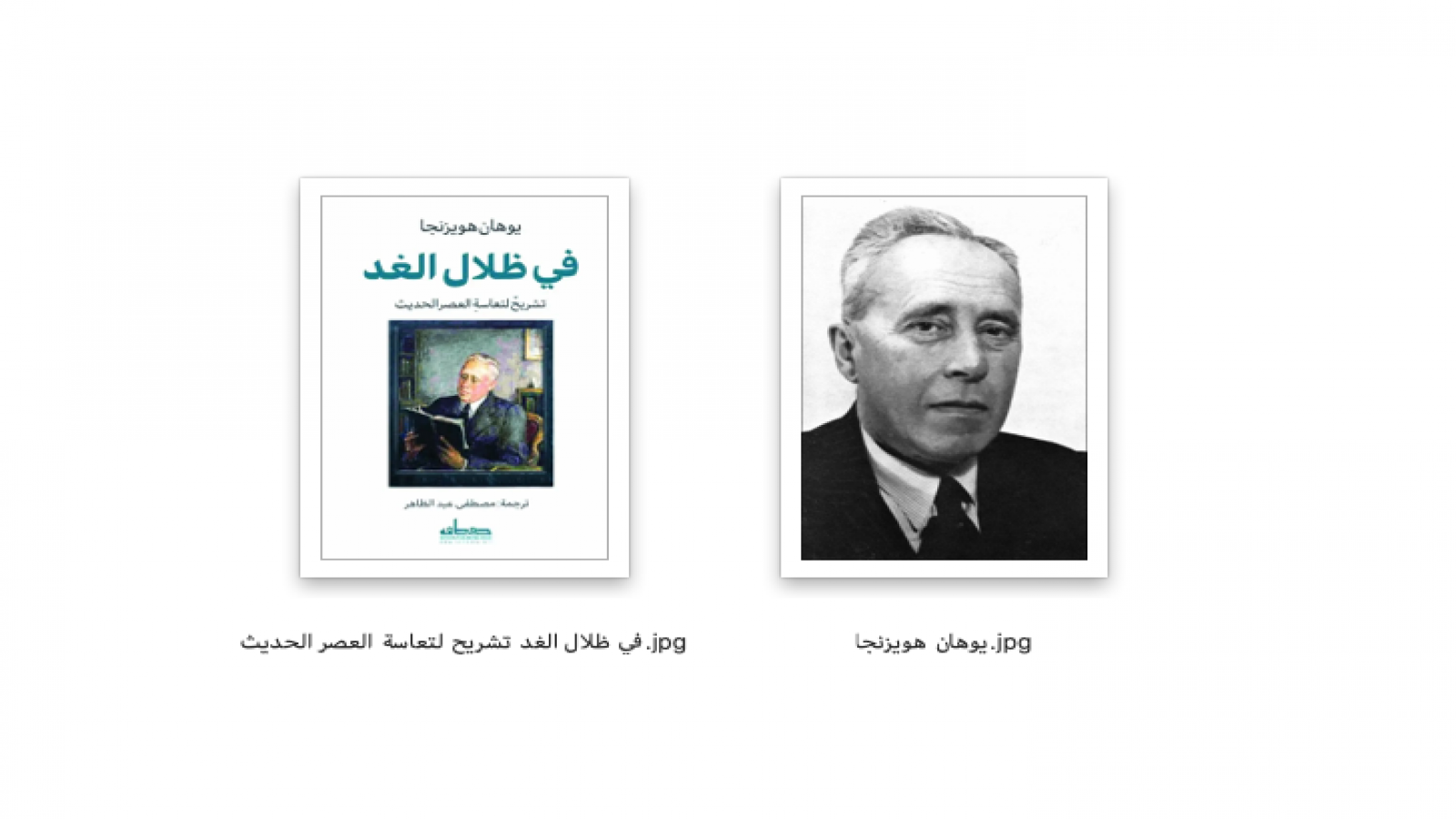
“إننا نحيا في عالم فقد عقله، ونحن نعلم ذلك. لن يكون من المفاجئ لأحد، إذا ما أفسح الجنون غداً الطريق لسعار قد يترك قارتنا الأوروبية مشدوهة مذهولة، أمام مُحرّكات لا تَكُف عن الطنين، وأعلام لم تزل تخفق، ولكن بلا روح”. بهذه العبارات التشاؤمية القاتمة، يفتتح المؤرخ والفيلسوف الهولندي يوهان هويزنجا كتابه “في ظلال الغد: تشريح لتعاسة العصر الحديث”، الصادر في ترجمة عربية عن دار “صفصافة” بالقاهرة، والذي يمكن اعتباره بمثابة “مرثية” لعصرنا الراهن، حيث يواجه هويزنجا آلام العصر، ودمار الحروب ومآسيها، وظهور اللامبالاة في عالم يعتبر المؤلف أنه قد “سئم نفسه”! يناقش الكتاب عدة قضايا مازالت صالحة لتشريح أزمة عالمنا المعاصر، في اللحظة الراهنة، منها على سبيل المثال الطبيعة الإشكالية للتقدم الإنساني، وإساءة استخدام العلم والتكنولوجيا، وتراجع الروح النقدية، وعبادة الحياة المادية، والخواء الروحي، واضمحلال الأصالة في الفن والأدب. وترجع أهمية هذا الكتاب لكونه، كما يقول المترجم مصطفى عبد الظاهر في مقدمته، استشرافاً نقدياً للأسس الفكرية التي تقوم عليها مرحلة “ما بعد الحداثة” في الحضارة الغربية المعاصرة. إعادة تشكيل العالم في الفصل الأول من الكتاب تحت عنوان “ترقّب الكارثة”، يقول الكاتب “لم يمض وقت طويل منذ أن أصبح الخوف من الكارثة الوشيكة، والتدهور التدريجي للحضارة، أمراً عاماً. إننا نشهد اليوم، على أوسع نطاق، انتشار الشعور بأننا نحيا وسط أزمة حضارية عنيفة، تُنذر بالانهيار التام. لقد كان كتاب أوزوالد شبنغلر “تدهور الحضارة الغربية” جرس إنذار لأعداد لا حصر لها حول العالم”. إن تقدّم المعرفة والعلوم التطبيقية مهما كانت حتميته وإلهامه لن ينقذ الحضارة الحديثة، والعلم والتكنولوجيا لا يكفيان كأساس للحياة الثقافية، فأصول الانحطاط الروحي تكمن في عمق أبعد مما يستطيع الفكر النقدي وقوة الإبداع التقني علاجه، وهذا يقودنا إلى السؤال الذي تجنبناه حتى الآن: ما العلاقة بين الأزمة الثقافية والظروف الاجتماعية والاقتصادية؟ ويضيف “لقد كان تأثير الفكر الاقتصادي على عصرنا قويا إلى درجة أن الكثيرين، دون قبول المذاهب بالضرورة، يعتبرون أنه مما لا جدال فيه، أن الأساس النهائي للمرض الروحي كامن في العيوب الاجتماعية والاقتصادية. هذا الاقتناع غالبا ما يرتبط بأن التحولات والاضطرابات البعيدة المدى ذات الطبيعة الاجتماعية- الاقتصادية التي نشهدها، تقدّم دليلا ًعلى أننا نعيش في فترة تغيّر هيكلي أساسي في المجتمعات الإنسانية، أو بتعبير آخر، فترة “إعادة تشكيل العالم”. ويعتبر الكاتب، أن المؤشرات على مثل هذا التغيير مثيرة للإعجاب بالفعل. فبعد قرون من العلاقات الثابتة نسبياً، يبدو أن عملية الاضطراب التدريجي قد هاجمت كل ما كان من قبل ثابتاً وصلباً، في مجال الإنتاج الثقافي والتبادل الاقتصادي، وحتى مستوى القيمة والعمل. على شفير الهاوية يعتبر المؤلف، في فصل عنوانه “العلم عند حدود قوة الفكر”، أنه إذا كان الفكر العلمي المعاصر على نطاقه الواسع واقع في أزمة، فهي أزمة من داخله، وليست أزمة ناجمة عن التلوث بأمراض مجتمع مضطرب، مشيرا إلى أن جذور هذه الأزمة كامنة في “عقل التقدم” نفسه، وأنه في أزمة الفكر لا تلعب الحماقة البشرية أو الانحلال الروحي أي دور، بل إن بيت الداء واقع في التنقيح المُطرد لوسائل المعرفة، وتكثيف إرادة المعرفة من أجل ذاتها. إلى ذلك، يتساءل هويزنجا: كيف ننكر أن جُل الأشياء التي بدت يوماً ما في أعين البشر مقدسةً وغير قابلة للتغيير، باتت الآن محلاً للتنازع والصراع؛ الحقيقة والإنسانية والعدالة والعقل؟ إننا نرى أشكالاً من الحكومات عاجزة عن أداء وظائفها، وأنظمة إنتاج على شفير الهاوية، وقوى اجتماعية جُن جنونها بالسلطة والنفوذ. غير أن القوى المناقضة لذلك تفرض ذاتها على أذهاننا فوراً، كما يرى الكاتب، فلم يكن ثمة زمن سبق كان البشر فيه أكثر وعياً وأوضح رؤيةً بضرورة التعاون، في مهمة جسيمة للحفاظ على العالم والحضارة الإنسانية، ولم يكن الإنسان أبداً في أي وقت سبق مستعداً لتكريس كل جسارته وقواه، من أجل قضية مشتركة؛ على الأقل، لم ينعدم الأمل بعد. من جهة ثانية، وفي فصل آخر، يتطرق الكاتب إلى ما يعتبره “أزمة الثقافة الغربية”، قائلاً: “سيستطيع جيلنا بحساسيته الجمالية، من خلال الاطلاع على مسار تطور الآداب والفنون، أن يتعرّف بشكل أفضل على ظهور الاتجاهات التي أوصلت ثقافتنا إلى حالة من الأزمة. ويسمح التطور الجمالي، إذا جاز التعبير، بالتفرّس في ملامح العملية الثقافية ككل؛ إذ يكشف عن وحدتها ويُظهر مسار تطور الأزمة الحالية على مدار قرنيّن من عمر الثقافة الأوروبية. “بركات” الحضارة المنتظرة! يؤكد المؤلف، في موضع آخر من الكتاب، أن الملاحظة المهيمنة على الفكر السياسي والثقافي الغربي، تمثلّت في الاعتقاد الراسخ بأنه في ظل سيادة “العرق الأبيض”، كان العالم على الطريق الصحيح للتوافق والازدهار، محمياً بمعرفة ومعطيات حضارية وصلت إلى الذروة. ولكن، على النقيض من هذا الاعتقاد المتوهم، باتت حضارتنا تتأرجح بين أقصى درجات التشاؤم اليائس والإيمان بالنجاة الوشيك. وإذا أردنا الحفاظ على قيم الحضارة الإنسانية، فيجب أن نستمر في مراعاة أن الثقافة تتطلّب - في المقام الأول- توازناً معيناً بين القيم المادية والروحية، ويشير إلى أن “الخلاص” لا يمكن أن يكمن في انتصار دولة واحدة، أو شعب واحد، أو عرق واحد، أو فئة واحدة، على البشرية جمعاء. وأن إخضاع معايير الموافقة والإدانة لهدف يقوم على الأنانية الحضارية، إنما هو تشويه لكل المشاعر الحقيقية للمسؤولية الإنسانية. على أن التفاؤل المطمئن في الوقت الحاضر، ممكن فقط لأولئك الذين أضلّهم ضعف بصيرتهم عن إدراك ما في الحضارة من سقم، فقد أصابهم هم أنفسهم نفس السقم، ولأولئك الذين تمدهم عقيدتهم في الخلاص بفكرة أنهم حازوا مفاتيح “خزائن السعادة” في الدنيا، ومنها سينثرون على البشرية “بركات” الحضارة المنتظرة! في هذا الصدد، وحسب الكاتب، يتجلى غياب التوازن في عدة مشاكل خطيرة، من بينها الاختلال بين الإتقان وقدرة الجهاز الإنتاجي، وعدم القدرة على جلب المنافع، ومعاناة بعض الشعوب من الفقر، رغم الوفرة التي يعيش فيها الغرب. ويلفت هويزنجا، إلى أن الثقافة كوضع اجتماعي توجد عندما تحافظ السيطرة الطبيعية في المجال المادي والروحي، على حالة أسمى وأفضل مما يمكن أن تنتجه شروط الطبيعة المُعطاة، وأن من خصائص الثقافة، التوازن المتناغم بين القيم المادية والروحية، مع وجود مثل أعلى، بشكل أو بآخر، تلتقي أنشطة المجتمعات البشرية كافة عند السعي إلى تحقيقه على أرض الواقع. والآن، يتساءل المؤلف، هل يمكن لعالم اليوم بما فيه من حروب صغيرة وصراعات دامية في كل مكان، أن يدّعي وجود نوع من التوازن بين القيم الروحية والمادية، وهو التوازن الذي يعتبره شرطاً أساسيا لدور وتأثير الثقافة؟ الإجابة على الأرجح هي النفي. فهناك إنتاج كثيف في كلا المجالين، لكن ليس هناك توازن وانسجام وتكافؤ بين القوى المادية والروحية على الإطلاق. ضباب “الكلمات الجوفاء” تبعاً لذلك، فإن كافة مظاهر عصرنا من حولنا تستبعد كل فكرة وجود توازن حقيقي. إن نظامنا الاقتصادي عالي الدقة ينتج يومياً كماً كبيراً من المنتجات، ويحرك قوى لا يريدها أحد، ولا تعود بالنفع على أحد، ويخشاها كل أحد، بل إن الكثيرين يعدونها غير جديرة، ناهيك كونها “عبثية ولا عقلانية”، في تقدير الكاتب. في المقابل، هناك أيضاً إفراط في الإنتاج الفكري، ووفرة دائمة في الكلمة المكتوبة والمسموعة والمرئية، لكن ثمة - بالتوازي مع هذا- اختلافاً فكرياً ميؤوساً من إصلاحه تقريباً. أمّا الفن، كما يقول، فقد وقع في حلقة مُفرغة ومُزعة تُقيّد الفنان بالدعاية والموضة فحسب، وكلاهما يعتمد بدوره على المصالح التجارية. خطر هذه اللاعقلانية يكمن في أنها مصحوبة بأعلى تطور للقوى الفنية. ومن الواضح أن عبادة الحياة التي أدت إلى نشوء اللاعقلانية للثقافة، لا يمكن إلاّ أن تعززّ عبادة الذات. رغم ذلك، فإن عبادة الذات تعني السخط من الرغبة في متاع الدنيا. أمّا إذا وقع تحت تصرف هذا الشغف إمكانيات تقنية هائلة التطور، فإن الخطر على المجتمع المتأصل في أي عبادة للذات، يزداد بشكل كبير، لأن إشباع هذه الرغبة في الرفاهية، قد يؤدى إلى تدمير رفاهية الآخرين. ومع انتشار الموقف اللاعقلاني في أنحاء الكوكب الأرضي، يتسع هامش سوء التفاهم في كل مجال بشكل مُطرد. وتتطلب أفكار اليوم نتائج فورية، بينما تغلغل الأفكار العظيمة دائمًا ببطء شديد. مثل الدخان وأبخرة النفط فوق المدن، هناك ضباب من “الكلمات الجوفاء” يحوم حول العالم. •الكتاب: “في ظلال الغد: تشريح لتعاسة العصر الحديث”. •المؤلف: يوهان هويزنجا. •المترجم: مصطفى عبد الظاهر. •الناشر: دار “صفصافة”، القاهرة. •تاريخ النشر: فبراير/ شباط 2023.
