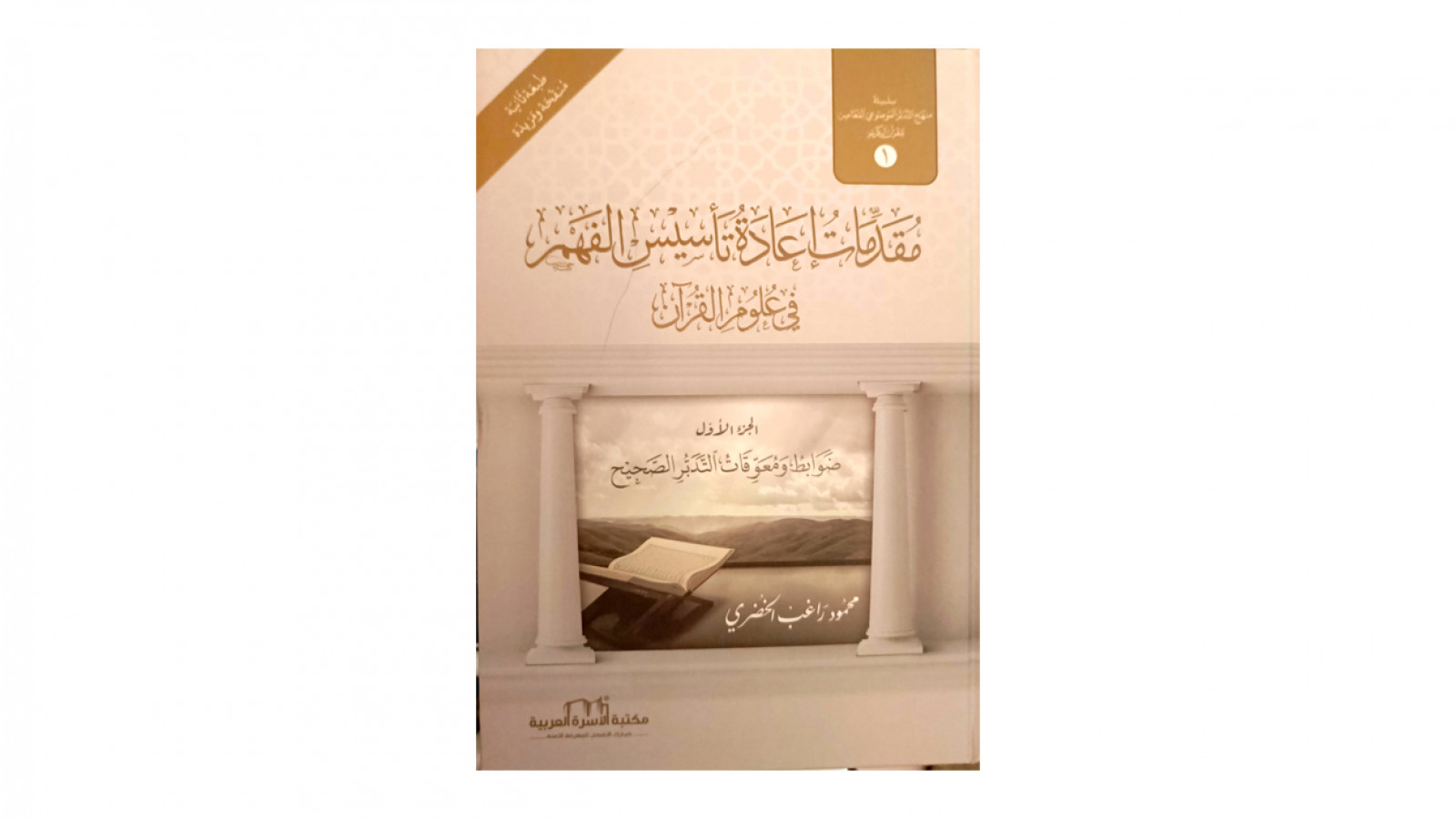
هذه هو الجزء الأول من سلسلة منهج التدبر الموضوعي المعاصر للقرآن الكريم، للكاتب المهندس محمود راغب الخضري، وقد نشأ اهتمامه بهذا المنهج من قراءاته لكتاب الله الكريم في رمضان وشعوره بأن ما يعمد إليه البعض من ختمة القرآن في خلال الشهر، تجعل القراءة أسرع ولكنها لا تعطي القارئ وقتا للتدبر المطلوب، وقد ساقه هذا الشعور للتعمق في موضوع تدبر كتاب الله تعالى، وبذل الجهد في محاولة الفهم، والقرآن ميسر للذكر لا صعوبة فيه، يستطيع العربي العامي قراءته أو سماعه والتفاعل مع معانيه دون حاجة لتفسير، إلا في عدد قليل من الآيات. وهنا نحتاج إلى مراجعة كتب التفسير لتحقيق التدبر الكامل، ومن خلال البحث وجد الكاتب أن هناك معوقات للتدبر الصحيح موجودة في كتب التفسير. التفسير بالمأثور يعنى الاعتماد على ما جاء من أقوال الرسول وحديثه كما وصلتنا من خلال الصحابة، بعد اجتياز روايتها مسألة الجرح والتعديل، كما وصل مأثور عن طريق التابعين، ولكن ليس كل ما وصل عن طريق التابعين ذا سند متصل، ولذا فلا يستوفي من الشروط ما يجعله موثوقا، والأهم من ذلك أن إيراده في كتب التفاسير مع الوقت جعل بعض المفسرين يتساهلون في أخذ روايات دون سند حقيقي، ومع الوقت تسرب إلي كتاباتهم الكثير من الإسرائيليات فأثقلت التفسير بما يعيق التدبر، وهنا نري أن ما اتصل سنده بالرسول هو ما يؤخذ به أما غيره فهو يعيق الفهم، مثال على هذا ما ورد في بعض التفاسير من أن الأرض محمولة على قرني ثور، وأن الزلازل تحدث إذا نقلت من قرن إلى آخر، يتتبع المؤلف هذه الحكاية فلا يجد لها أثرا فيما رواه الصحابة عن النبي ولا في كتب التوراة، ولكن أصلها من التراث اليوناني الذي دخل في الإسرائيليات، والإسرائيليات أغلبها تحريف لما نزل على موسى وأنبياء بنى إسرائيل، وقد طرأ عليها التحريف بسبب تعدد الرواة قبل تدوينها الذي لم يحدث إلا بعد ثلاثمائة سنة من نزولها على موسى، وأصابتها تغيرات مقصودة وغير مقصودة، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم ، ونهى في كثير من الآيات عن الأخذ عنها، وقال الرسول صلى الله عليه و سلم معترضا على عمر وهو يقرأ التوراة أنه “ لو كان موسى حيا ما كان له إلا أن يتبعني”. وهنا يعرض الكاتب لكل الآيات التي حذرت من الروايات الإسرائيلية، ثم يذكر أن الذين قبلوا أن يكتبوا الاسرائيليات فهموا على نحو غير صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم (بلغوا عنى و لو آية، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليأخذ مقعده من النار) . الحديث يحذر تحذيرا شديدا من الكذب فكيف يجيز عدم الحرج في نقل الإسرائيليات وقد ذكرت أكثر من آية في القرآن أن فيها الكثير من الأكاذيب، وإذن فإن المقصود بالتحديث عن بنى إسرائيل هو ما جاء عن خبرهم من كلام الرسول أو روي عنهم في القرآن، إذ قد يقوم الحرج بسبب المحاماة في مجتمع ذي إثنيات متعددة، ولكن التلطف مع أهل الكتاب لا يعني التحرج من ذكر ما جاء عن كتبهم وأحاديثهم في كتاب الله تعالى. أما الآية الكريمة (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين)، وهي التي فهم البعض منها جواز الاستدلال بالتوراة فقد عزلوا العبارة ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين) عن سياقها، مع أن فهمها من خلال الآية: قل لهم -أيها الرسول-: هاتوا التوراة، واقرؤوا ما فيها إن كنتم محقين في دعواكم أن الله أنزل فيها تحريم ما حرَّمه يعقوب على نفسه، حتى تعلموا صدق ما جاء في القرآن من أن الله لم يحرم على بني إسرائيل شيئًا من قبل نزول التوراة، إلا ما حرَّمه يعقوب على نفسه. وعندما نزلت التوراة حرم الله عليهم اشياء عقوبة لهم، ولذا فالحديث عن الأخذ بالتوراة إنما هو محاججة عند هذا الموضع فقط. النوع الثاني من كتب التفسير هي كتب التفسير بالرأي، وقد اتفق الممانعون مع المجيزين للرأي في أن الصواب أن يفسر كلام الله تعالى من القرآن، فإن لم نجد فمن سنة نبيه، فإن لم نجد ففي أقوال الصحابة و التابعين، وزاد على ذلك المجيزون ما فهموه من دعاء رسول الله لابن عباس (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل لما كان هناك فائدة من تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء، فدل ذلك على أن التأويل أمر آخر وراء النقل و السماع، وذلكم هو الرأي والاجتهاد إذا كان محررا من أي غرض سوى الوصول إلى الحقيقة من مراد الله من النص، فتصبح غلبة الظن منهجا شرعيا معتبرا وكافيا ولا بد منه لفهم النصوص والأدلة في غياب المأثور الصحيح، وهذا منهج معتبر عند العلماء بغير خلاف. وعلى هذا فإن الرأي قسمان: قسم جارٍ على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة ومراعاة سائر شروط التفسير، وهذا القسم جائز لا شك فيه، وقسم لم يجر على قوانين العربية ولا وافق الأدلة الشرعية ولم يستوف شرائط التفسير، وهذا منهي عنه مذموم بلا جدال. والكاتب عند درسه لهذا النوع من التفسير لاحظ أن بعض الرأي قد ابتعد عن منهج الاجتهاد، الذي يطلب معرفة الصواب عندما تتعارض الأدلة والأمارات، فقد أخذ بعضهم بحشد ما يبرعون فيه من لغة ونحو وعلوم وفلسفات وفقه وتاريخ وتصوف وبدع ومذاهب مختلفة بين ثنايا التفسير. وقد أسرف البعض في ذلك حتى ابتعد عن المقاصد وخرج عن المعقول، ولا شك أن في هذا تشتيت لعقل وقلب المتلقي عن التدبر الصحيح في آيات كتاب الله الكريم. التأويل الذي دعا رسول الله أن يعلمه الله لابن عباس هو وسيلة لمعرفة الحقيقة وهو ليس الحقيقة ذاتها أو مآلاتها أو زمن حدوثها، ومهمة التأويل هو معرفة المقصد من الكلام من سياق النص عندما تعجز اللفظة عن الإفصاح عن المعنى المقصود والمتوارث خلف الألفاظ التي لا ينبئ ظاهرها عن المراد. إن تفسير القرآن بالمعنى المطلوب لفهم مراد الله يوجب تحرير التأويل من عبء بحور العلوم المضافة عليه، والتركيز على مقاصد الخطاب وغاياته، وعلى ضوء الفهم الكامل للرسالة وقيمها ومقاصد الشريعة فيها، ولا يتحقق ذلك إلا بإبراز قطار المعاني الذي يربط بين السابق واللاحق في سياق الآيات. وقد فهم البعض أنه لا يمكن معرفة التأويل إلا يوم القيامة، وبالتالي فهو في الدنيا من الغيب الذي لا يصل إليه أحد، وهذا فهمهم للآية الكريمة ( هَل يَنظُرُونَ إِلَّا تَأوِيلَهُ يَومَ يَأتِي تَأوِيلُهُ يَقُولُ لَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبلُ قَد جَآءَت رُسُلُ رَبِّنَا بِالحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشفَعُواْ لَنَآ أَو نُرَدُّ فَنَعمَلَ غَيرَ الَّذِي كُنَّا نَعمَلُ قَد خَسِرُواْ أَنفُسَهُم وَضَلَّ عَنهُم مَّا كَانُواْ يَفتَرُونَ) ولكن الفهم الصحيح لا يأتى إلا بمعرفة سياق الايات فإن الاية السابقة على هذه الاية تقول (وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) نفهم من السياق أنهم لم يؤمنوا بالكتاب الذي فصل الله فيه الهدى و الرحمة، و هنا يأتى التساؤل هل سيستمرون في التكذيب حتى ياتيهم الوعيد يوم القيامة، أى تأويل ما حذرناهم منه. من اللافت في سورة الرحمن قول الله (الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان)، فإن الله قدم علم القرآن على خلق الإنسان، وكأنما إمكانية تعلم القران مركزة في جينات الإنسان قبل الخلق، ثم ذكرت الآيات البيان بعد الخلق، يعني أن الله خلق الإنسان وفي جيناته علم القرآن ثم علمه البيان بعد الخلق، والبيان هو محصلة تدبر كلام الله تعالى. يفصل الكاتب في الحديث عن المحكم والمتشابه من القرآن فالمحكم ما ذكرته الآية الكريمة فوصفته بأنه أم الكتاب أي أغلب الكتاب، الآية (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات) والمتشابهات قليل، كلمة المتشابهات في القرآن جاءت أحيانا بمعنى المتماثلات (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها) كما جاءت بمعنى ملتبسات أي اختلف المفسرون في تفسيرها (قالوا ادع ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا) والملاحظ أن القرآن عندما يستخدم المتشابه تأتي الآيات محكمات واضحات لا خلاف على معناها، أما عندما يستخدم التشابه بمعنى الالتباس فلا ينبئ ظاهر الآيات عن المعنى بشكل صريح ومباشر. ويمضى الكتاب في مناقشة مستفيضة لمصطلح المتشابه أي الملتبس في القرآن حسب الآيات (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) يعنى تفسيره بما يخرجه عن مراد الله وتختتم الآية (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) ، والنقاش هنا: هل يعلم الراسخون في العلم تأويل المتشابه، وما نوع الواو السابقة لكلمة والراسخون في العلم، ويخلص الكاتب إلى أن من المتشابه ما لا يعلمه إلا الله كموعد يوم القيامة ولكن أكثر المتشابه مما يمكن للراسخين في العام تأويله بشكل صحيح اعتمادا على فهمهم للمحكم من القرآن، عندما يردونها إلى السياق الذي وردت فيه بما يتوافق مع الأدلة الأخرى من كتاب الله وما ثبت صحته عن رسول الله. ويرد المؤلف بالعقل والدليل ما نُسب خطأ للإمام علي رضي الله عنه أن القرآن حمال أوجه، فكيف يكون مرجع هذه الأمة مصدرا للاضطراب بدل أن يكون فيه البيان والحق والبرهان. والكتاب يحفز العقل على التفكير ولا شك انه يحقق مراد المؤلف في تسهيل تدبر القرآن بإزالة المعيقات عنها، ولكثرة إيراد الأدلة والبحث في المراجع فإن الكتاب شابه بعض التكرار ولكنه تكرار مقبول يعزز المعنى.
