من تأليف د. فواز بن علي الدهاس ود محمد بن هزاع الشهري..
المسجد الحرام : التاريخ و العمارة.
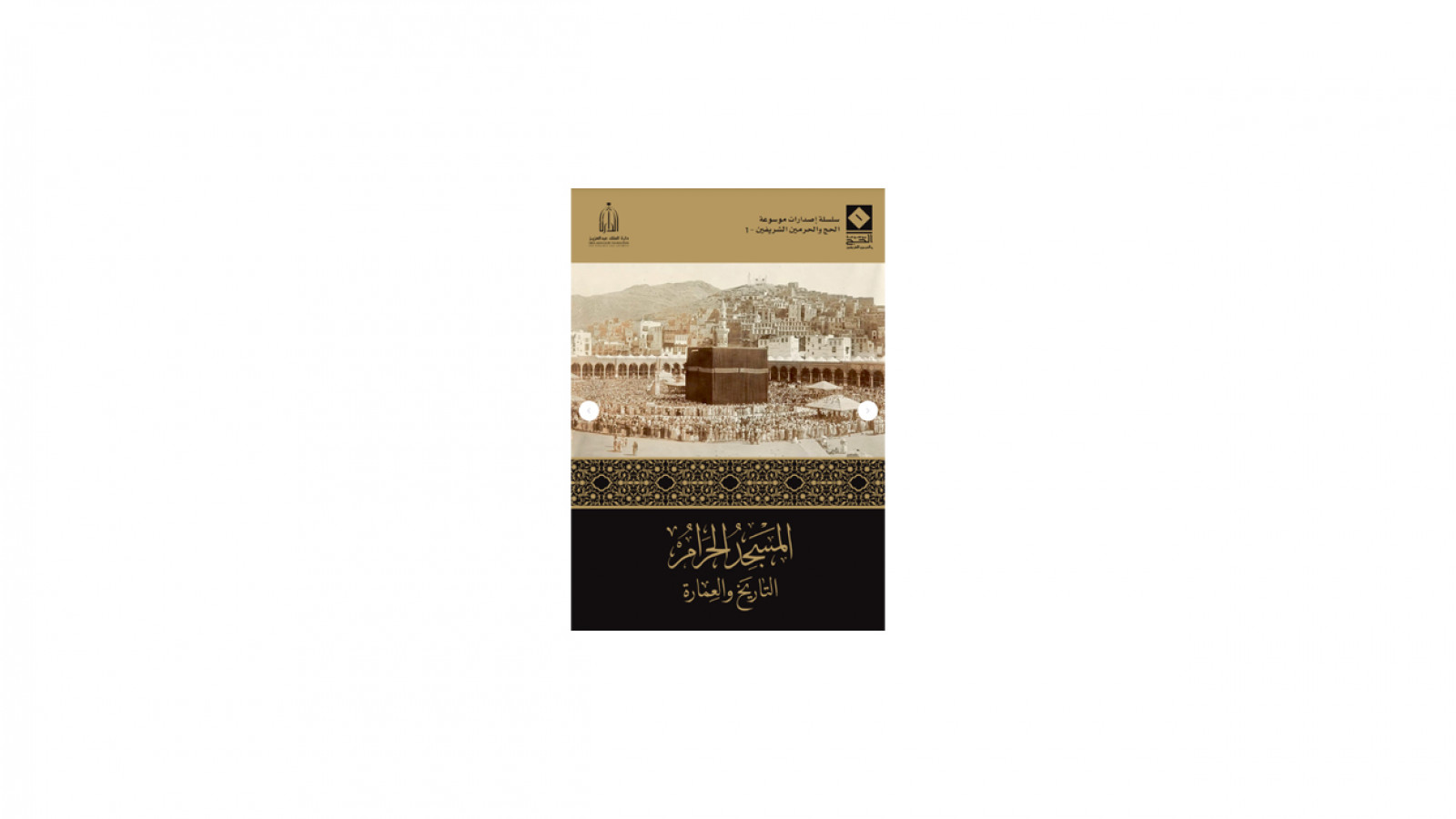
كتاب مهم يشبع فضول زائر المسجد الحرام ليتعرف على هذه التحفة التي تجمع التاريخ والجغرافيا، والقداسة والإبداع البشري في تناغم مثير، ألفه د فواز بن علي الدهاس و د محمد هزاع الشهري، ونُشر ضمن سلسلة موسوعة الحج والحرمين الشريفين التي تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز. تكثر الروايات الظنية عن إقامة الكعبة، لكن ما ذكره القران يبقى كافيا (وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِي شَيۡـٔٗا وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (26) ، نفهم من هذه الٱية أن مكان البيت معروف من قبل ابراهيم عليه السلام، ( وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ (127) وأن قواعد البيت كانت موجودة وكأنما هي جزء من تضاريس الأرض كالجبال. قام ابراهيم بدعوة البشر إلى الحج، (وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ (27) . وتفجرت بئر زمزم معجزة إلهية عند أقدام الطفل إسماعيل عليه السلام، و مع الوقت اجتذب الماء قبائل من اليمن، كانت تبحث عن الماء بعد أن عاقبها الله على عصيانها بانهيار سد مأرب، وتداولت على حكم مكة قبائل ثم وصل الأمر إلى خزاعة، وأدخل عمرو بن لحي الانحراف، فعبد الناس الأصنام. استعاد قصي بن كلاب رئاسة مكة، و ظهرت عبقريته التنظيمية في تخطيط مكة، وترتيب بناء بيوت أهل مكة حول الكعبة، ووزع وظائف القيادة بين أبنائه، وهذه تشمل السقاية والرفادة، وهو ترتيب لإعاشة الحجاج خلال إقامتهم بمكة، والسدانة وتعني الحفاظ على الكعبة، وأقام دار الندوة، التي شابهت دور البرلمانات الحديثة. وأصبحت مكة مركز النشاط الاقتصادي في الجزيرة العربية. وفرضت قريش امتيازاتها، فكان أبناؤها لا يذهبون إلى عرفات مثل باقي الحجاج، وفرضوا على الحجاج أن يطوفوا عراة إلا إن اشتروا ملابس من أهل مكة. ثم جاء الإسلام فأعاد إقرار المساواة بين البشر وألغى هذه الفوارق الظالمة، وهدم الأصنام، وأكد على قدسية البيت الحرام، وهنا نجد أن تعببر “المسجد الحرام” جاء في القرآن دالا على الكعبة في آية (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) ، وجاء دالا على الكعبة والمطاف حولها في آية أخرى (لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم)، وجاء دالا على حدود مكة الشرعية التي وقف عند طرفها الشرقي فيل أبرهة، ووقفت عند طرفها الغربي ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله) . ويقرر المؤلف أن حدود الحرم معروفة منذ سكن آدم أبو البشر بمكة، وينقل عن المؤرخ الأزرقي أن آدم عليه السلام لما خاف على نفسه من الشيطان استعاذ بالله تبارك وتعالى فأرسل ملائكة حموا مكة من كل جانب، فحرم الله الحرم من حيث كانت تقف الملائكة، ولما فتح الله على نبيه مكة، خطب الناس وقال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمه الناس، وأن الله جل وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب وقال: (إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه دمًا، أو يعضد فيه شجرة، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد) أي معرف. وسع عمر بن الخطاب مساحة المطاف وأحاطها بسور يفصله عن البيوت وجعل عليه قناديل الزيت للإضاءة، وقد حدث ذلك بعد أن حصل سيل أم نهشل فاقتلع مقام إبراهيم مع أثاث الحرم، وأقيم جدار عريض في أعلى المدعى جنب الكعبة الكثير من أخطار السيول، وزاد عثمان رضي الله عنه في مساحة المطاف وظلل مؤخرته، كما أقيم رواق مسقوف حول المطاف، استمر توسيع المطاف وتطوير الإضاءة على مر العصور. ومع نهاية التوسعة السعودية الأولى وصل قطر المطاف إلى ٩٥ مترا، وألغيت الحصاوي وما بينها من الممرات، ونقل المنبر الرخامي والمكبرية، ومدخل بئر زمزم إلى موقع آخر، فأصبحت سعة المطاف ٨٥٠٠ مترا مربعا، تستوعب ثمانية وعشرين ألف مصل. يقع مقام إبراهيم في ساحة المطاف وهو آية من الآيات التي ميز بها الله المسجد، بقي حتى اليوم سليما من الضياع والتلف، رغم كونه حجرا رخوا يستطيع أضعف الرجال حمله، وكم نجا من السيول الجارفة، وهو على شكل قدم بلا أصابع عمقه عشرة سنتيمترات وطوله اثنان وعشرون سنتيمترا، و قد أحيط بإطار من الذهب أيام المتوكل العباسي لحفظ ما تشعث منه، وقد ثبته عمر رضي الله عنه بحضور عدد كبير من رجال قريش الذين اقروا بمكانه. أما بئر زمزم فكانت لها فتحة مما يلي المطاف، ورغم أن عمقها لا يزيد عن ثلاثين مترا وقطرها أقل من مترين فإنها تضخ في الساعة الواحدة أربعمائة وستة وثمانين مترا مكعبا من الماء. أول منبر أقيم في الحرم كان منبرا أمر به معاوية بن أبي سفيان سنة حجه قادما من دمشق عام ٤٤ للهجرة. وكان دقيق الصناعة صلب الأعواد، بقى أكثر من مائة سنة هجرية. ثم استقدمت عدة منابر قدمتها الدول الاسلامية المتنافسة على الزعامة، وكلها مما اجتهد في صناعتها من الخشب على أفضل ما كان متاحا، السلطان سليمان القانوني أرسل منبرا من الرخام، وتم استبداله مع التوسعة السعودية الثانية، وأصبح متحركا. رفع إبراهيم واسماعيل عليهما السلام قواعد البيت، و حيث إنها كانت في بطن واد تغمره السيول الجارفة فقد ألحقت بها أضرارا، كما أن قريشا قد ازدهرت تجارتها، وكثرت أموالها وارتقت معيشتها وتفننت في الملابس والمنازل، فتطلعت لإظهار الكعبة بمثل ما أصبح أهلها عليه من فخامة، وهكذا اختار القرشيون ما طاب من أموالهم لبناء البيت الذي تعظم العرب قريشا لأجله، فأعادوا بناء الكعبة، ولكنهم انتقصوا من قواعد إبراهيم لنقص النفقة، فنقص طول الجدارين الشرقي والغربي ستة أذرع . و كانت قريش تطوف حول المبنى الجديد، بمعنى أنها من الجهة الشمالية كانت تطوف دون قواعد إبراهيم و مع اتجاه عقارب الساعة، ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف حول قواعد إبراهيم وفي اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة وقال (يا عائشة : لولا أن قومك حديثو عهد بكفر، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم) ، ولذا فعندما حكم عبدالله بن الزبير مكة أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وعندما انتصر عبدالملك بن مروان أعاد بناء الكعبة على ما فعلت قريش، وندم على ذلك بعد أن علم بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم. كذلك زادت قريش في ارتفاع الكعبة حتى بلغت حوالي تسعة أمتار، وجعلوا لها بابا، وجعلوا للباب مصراعا يغلقه. وفي عمارة عبدالله بن الزبير جعل للكعبة سقفين أعلاهما فيه أربع فتحات للضوء، سدها برخام شفاف. كما زاد في طولها. وفي العصر العباسي استجاب الخلفاء لنصيحة الإمام مالك بن أنس الذي نصح بإبقاء الكعبة على ما جعلها عليه عبد الملك خشية اختلاف الحكام في أمرها. وتعرضت الكعبة لتشققات في القرن الحادي عشر للهجرة، فأمر السلطان أحمد الأول العثماني عام ١٠٢٠ للهجرة بعمل حزام للكعبة من النحاس المذهب، أحاطوا به جوانب الكعبة من عند منتصفها لمنع حجارتها من السقوط. و في عام ١٠٣٩ للهجرة داهم الكعبة سيل عارم أسقط الجدار الشمالي في عصر مراد الرابع الخليفة العثماني، وقد هدمت الجدران حتى ظهرت قواعد إبراهيم بضخامة أحجارها وإحكام بنائها، ثم أعيد بناؤها وما زال البناء سليما من أي عيوب حتى اليوم. بمجرد مبايعة الملك عبدالعزيز ملكا على الحجاز قام بترميم بناء الكعبة عام ١٣٤٤ هجرية وتم استبدال الباب القديم الذي كان من درفة واحدة بباب من درفتين مكسو بالذهب والفضة عام ١٣٧٠ للهجرة، و أعيد بناء سقف الكعبة بقرار من الملك سعود صدر عام ١٣٧٧ هجرية ضمن مشروع التوسعة السعودية الأولى التي اكتملت في عهد الملك فيصل، و بعد خمس وثلاثين عاما أمر الملك خالد باستبدال الباب، فجاء ٱية في الجمال. أما في عهد الملك فهد فتم تجديد السقفين، وتم بناء سوار مُحلى بالذهب لتدعيم السقف السفلي بدلا من الدعائم السابقة، وذلك ضمن التوسعة السعودية الثانية. تطلق أسماء على أجزاء من الكعبة، مثل الحجر الأسود في الزاوية الجنوبية الشرقية، و الركن اليماني على الزاوية الجنوبية الغربية، و كلاهما مبنيان على قواعد ابراهيم بخلاف الزاويتين الشماليتين.و لذا فإن الطائفين يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الٱخرين لأنهما من عمل قريش، و ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام. أما الملتزم فهو جزء الكعبة القائم بين الحجر الأسود وباب الكعبة. الشاذروان كلمة فارسية تطلق على ما برز من أساسات الكعبة خارجة عن البناء من الجدران الشرقية والغربية والجنوبية، وقد استحدثت في بناء عبدالله بن الزبير لمنع الطائفين من السير على ما برز من قواعد إبراهيم. وأما الحطيم أو حجر اسماعيل فاسمان يطلقان على السور المقوس المكسو بالرخام و يزيد طوله قليلا على المتر و طرفاه ينتهيان عند الزاوية الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، وعلى الطائف أن يطوف من خارجه، أما داخله فقد اتخذته قريش مجلسا لوجهائها. كان العرب حريصين على كسوة الكعبة، كساها ملوك اليمن التبابعة مرتين قبل الإسلام، ثم كستها قريش قبل البعثة بخمس سنين، وكُسيت في العصور الاسلامية بأفخر المنسوجات، وخلال العصر العثماني كانت تأتى ضمن المحمل المصري والمحمل الشامي، ثم أصبحت تُصنع في مكة المكرمة. بعد توسعة الخلفاء الراشدين قام عبدالله بن الزبير بتوسعة أخري، واللافت للنظر أن أصحاب البيوت التي أدخلت في الحرم لم يبدوا اعتراضا كما فعلوا من قبل، ويعزوا المؤلفان ذلك إلى أن حكم ابن الزبير كان يعنى عودة عاصمة الإسلام إلى مكة بعد أن انتقلت للكوفة ثم إلى دمشق. وفي عهد الوليد بن عبدالملك أدخلت زخارف وتحسينات على الرواق المحيط بالمطاف، وقد أقيمت أول مئذنة في عصر المنصور العباسي، أما الخليفة المهدى فقد كان جوهر توسعته الكبرى للحرم هادفة إلى توسيط الكعبة، وأنشأ مجرى يأخذ مياه السيول بعيدا عن الكعبة، وكذلك تم نقل اسطوانات الرخام من الشام لتدخل في تدعيم وتجميل عمارة البيت الحرام. وفي النصف الثاني من العصر العباسي أضيف ملحقان من الجهتين الشمالية والغربية كما زيد في مساحة الحرم حوالى ألفين من الأمتار المربعة. دار الندوة تضاءلت أهميتها بعد أن أصبح لمكة أمير يعين من قبل الخليفة، وانتقل مجلس أهل الحل والعقد ليكون في العاصمة، ولكن معاوية بن أبي سفيان اشتراها أيام خلافته وكان ينزل فيها إذا زار مكة ونزل بها كثير من خلفاء الدولتين الأموية والعباسية، حتى عهد هارون الرشيد الذي ابتنى منزلا للخليفة، ومع الوقت تحولت دار الندوة إلى خراب وأصبحت مصدرا للحيوانات المؤذية، كتب صاحب البريد (يشبه رجل المخابرات في عهدنا) إلى الخليفة المعتضد، فأعيد بناؤها على شكل مسجد أُلحق بالحرم. واستمر كل من حكم مكة من المسلمين في تعهد الحرمين بالترميم والتجديد، حتى حصل الحريق الكبير عام ٨٠٢ الهجرة الذي أتى على الجانب الغربي فتولى السلطان المملوكي فرج بن برقوق أمر إعادة البنيان وحملت إليها اسطوانات إضافية من مصر فأكملت ما لم يكن قد اكتمل أيام الهادي العباسي، وجلبت أفخر أنواع الخشب لبناء السقوف. قدم سليمان القانوني منبرا رخاميا للبيت الحرام، وأنشأ مئذنة سابعة، وجدد سطح الكعبة، وصفح بابها وميزابها بالفضة المموهة بالذهب، وجدد منارة باب العمرة ومنارة باب علي. تكررت الأضرار التي تحدث للحرم بسبب السيول. وقد رمم السلطان سليم الثاني كل ما دمر بسبب السيل الذي حدث عام ٩٧٩هجرية، اكتمل بناء الرواق العثماني بقبابه المميزة في عهد مراد الرابع بن سليم الثاني. في عام 1039 هطلت أمطار غزيرة ففاضت مكة بسيل عارم عمَّ منطقة الكعبة ووصل ارتفاعه إلى طوق القناديل المعلقة، وسقط على أثره الجدار الشامي للكعبة، وأجزاء من الجدارين الشرقي والغربي، فأمر السلطان العثماني مراد الرابع بإعادة بنائها، واستعان على ذلك بمهندسين من مصر. استغرقت عملية إصلاح الكعبة وتقوية دعائمها مدة ستة أشهر. وفي سنة 1334هـ/1915م، أمر السلطان محمد الخامس بعمارة وإصلاح جميع الأضرار التي تعرض لها المسجد بسبب السيل المعروف باسم سيل الخديوي، نسبةٌ إلى خديوي مصر عباس حلمي الثاني الذي حج في سنة ١٩٠٩ م وهي نفس السنة التي حدث فيها السيل. وبسبب الحرب العالمية الأولى وقيام الثورة العربية الكبرى تم وقف العمل بترميم المسجد الحرام. في عهد الملك عبد العزيز تم فرش أرض المسعى بحجر الصوان بعد أن كانت ترابية مليئة بالحجارة والحفر، وأُكمل تظليل المسعى، وخلال التوسعة السعودية الأولى تمت إزالة كل البيوت القائمة حول المسعى من الجانبين، وأضيف اليه طابق علوى. وبعد ذلك بحوالي خمسين عاما قًررت توسعةٌ جديدةٌ للمسعى في عهد الملك عبدالله ليصبح أربعة أدوار، وأصبحت مساحته اثنين وسبعين ألف متر مربع. وزود بكل الخدمات مثل الإنارة والتهوية، والتبريد والماء والعربات. وفي عهد الملك عبد العزيز تمت إضاءة الحرم بالكهرباء، وتشكلت لجنة قامت بحصر كل ما لحق بالمسجد الحرام من أضرار بسبب تعدد السيول، وتم اصلاحها جميعا في مدة قصيرة. أجريت التوسعة السعودية الأولى في عهد الملكين سعود وفيصل رحمهما الله، وامتدت على أربعة مراحل استغرقت عشرين عاما، تم فيها إزالة الكثير من المباني، وفتح الطرق، وعمل طابق تحتي للخدمات، ونفق للسيول تحت المسعى أنهى المشكلة، وأصبح المسعى جزءا من المسجد، وشارك في التخطيط مع السيد عوض بن لادن بيت خبرة هندسية مصري، واتحاد المهندسين الباكستانيين وقدمت خطة عُدلت أكثر من مرة بعد اجتماعات ومداولات كان أكثرها بحضور الملك فيصل رحمه الله. استبق الملك فهد رحمه الله التوسعة التي عزم عليها بإضافة ثلاث ساحات خارجية، مفروشة بالرخام المقاوم للحرارة، لتستوعب الأعداد المتزايدة من المصلين. ثم بدأ مشروع التوسعة في المنطقة الواقعة غرب التوسعة الأولى. ولا شك أن كل زائر يلفت نظره الأعمدة الرخامية البيضاء التي تحتوي قاعداتها على فتحات جميلة تدفع بالهواء البارد، و كذلك القباب الثلاثة فوق التوسعة، يضاف إليها الأبواب و السلالم الكهربائية وأنظمة الصوت الموحدة والإضاءة. ثم جاءت توسعة الملك عبدالله التي يصفها الكتاب بأنها الأكبر والأعظم و الأجمل في تاريخ عمارة المسجد الحرام، و مقارنة بالعمارة السابقة التى أقيمت في بطن الوادي قليل السكان، فإن هذه التوسعة امتدت في منطقة جبالِ صخرية، مأهولة بالسكان في عمارات متعددة الأدوار، أزيلت الجبال والمباني وما نتج عنها من ردم فكان عملا شاقا، ولكن إنجازه تم في وقت معقول. أضافت هذه التوسعة للحرم مساحة تساوي مساحة التوسعتين السابقتين. ووصلت إلى حوالي مليون ونصف من الأمتار المربعة. تشمل التوسعة ثلاث ساحات في جزءها الشمالى، وأربع ساحات تتوسط مبانيها، وكذلك ساحات خارجية تحيط بها، وهذه سيجري تظليلها. على جانبي التوسعة منارتان، والمبنى الرئيس يتألف من ثلاثة أدوار تعلوها خمس قباب مثمنة يطل منها جمال فاره، وفي سقف التوسعة اثنتا عشر قبة متحركة. وتحوي هذه التوسعة جسورا وأنفاقا للمشاة. ومبانٍ مركزية للخدمات، ومحطاتٍ للكهرباء ومحطاتٍ لتبريد وضخ المياه، حيث تُنتج محطة تصفية مياه زمزم خمسة ملايين ليتر يوميا تضخ منها كميات لزوار الحرم ويسمح بحمل عبوات منها لمن أراد. وفي عهد الملك سلمان شهدت كسوة الكعبة إضافة خمسة أشكال هندسية قنديلية كتب في كل منها (يا حي يا قيوم) ، وتم تجديد رخام الشاذروان ورخام حجر إسماعيل، وكذلك تم تجديد رخام قاعدة صندوق مقام إبراهيم. يًرجع التاريخ المسجل أولى مآذن الحرم إلى عهد أبى جعفر المنصور، ويستغرب المؤلفان عدم وجود مآذن تنسب للعصر الأموي، فالأمويون هم أول من بنى المآذن في المسجد النبوي والأموي وجامع عمرو بن العاص وجوامع الكوفة والبصرة، في عصر المهدى أصبح عدد مآذن الحرم أربعة، وأضيفت إليها ثلاث مآذن لاحقا، والتزم العثمانيون بالتوقف عند سبع مآذن أسوة بمرات الطواف والسعي، وفي التوسعة السعودية أضيفت ست مآذن، فأصبح المجموع ثلاث عشرة مئذنة، كلها من ذوات الشرفتين. لعلنا نستطيع القول واثقين إن معمار المسجد الحرام يشكل اليوم أهم وأجمل معمار على البسيطة، وللمعمار حكايات مثله مثل البشر.
