حاسة الضوء.
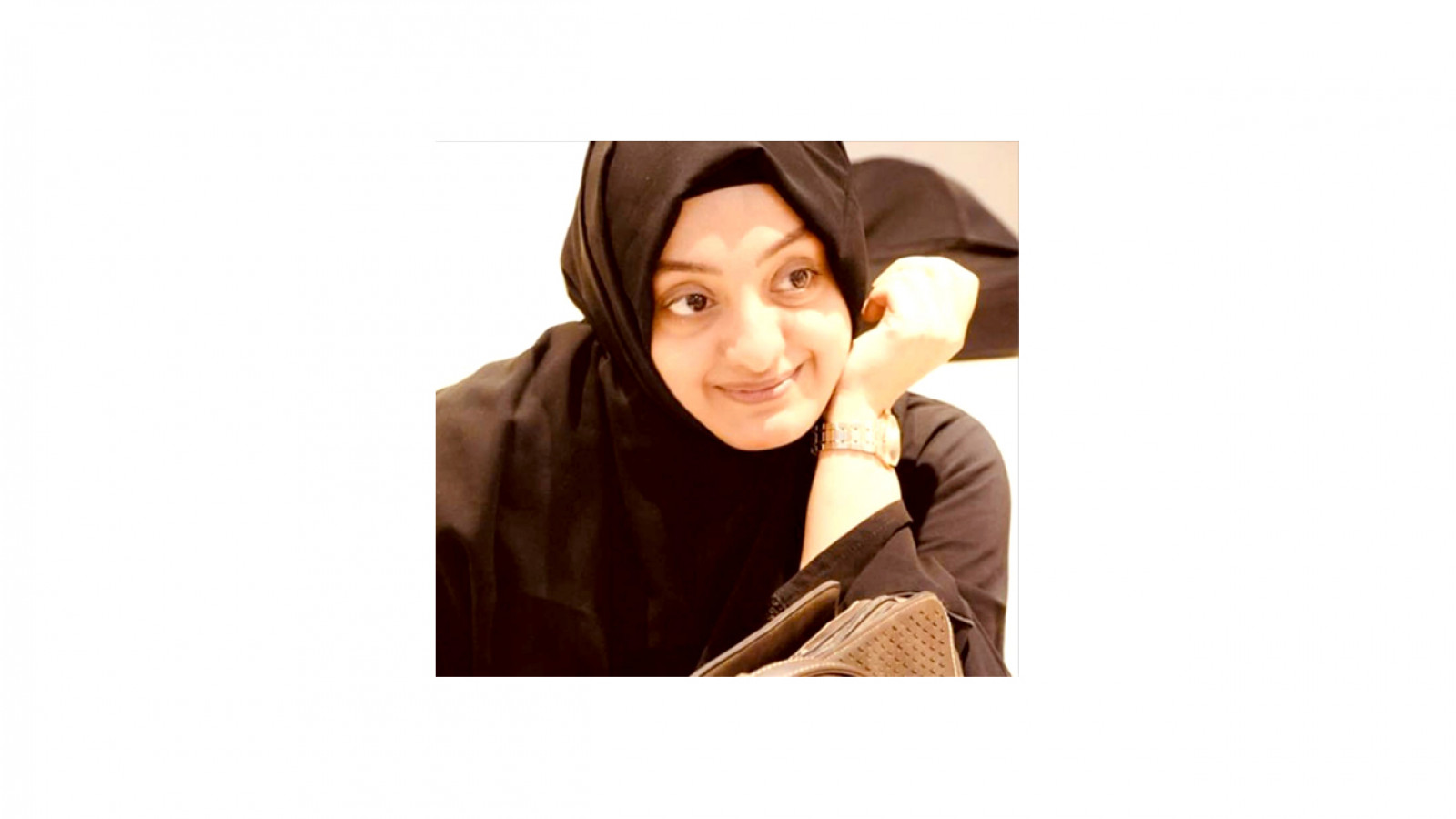
يستدعيني قول صوفي “إذا لم تكن العين مشرقة فكيف لنا أن ندرك النور؟؟!” أرتحل به نحو أنه ربما أن العين تدين بإشراقها للضوء الذي يستحضرها كحاسة تشبهه وتناسب نشاطه, فحينما تلاحق العين مصدر فضولها يصطادها. فالأشياء كما يقال تألف أشباهها وتعرف بها. ومع ذلك فإن الظلام الذي يقابله الجهل أو قصور المعرفة أو النقص بطبيعة الأمور هو ما يحفز الخيال ويزدهر في أرضه قليلة الخصوبة ومنه تنبت الأساطير وتتفرع أخيلة الاكتشاف والمعرفة في الذهاب أبعد مما تقتضيه حدود العلم المنطقية. لدهور مضت كنا قد تخيلنا أشياء كثيرة مما أسطرناه, ورسمنا بالصور تاريخ الحياة المفقود والمتخيل بالكلمات. فعلى عكس ما نتخيل ونعتقد فإن من يولد أعمى لايرى السواد ولا يعرفه ولكنه بالمقابل يحلم كثيرا ليعوض شيئه المفقود, وكذلك الأصم يسمع الأشياء بأذن خياله فلا يعرف حقيقة الأصوات وواقعها. فالأصوات كالألوان لا يمكن وصفها أو لمسها أو توثيقها بالكلمات, فبينما نستطيع تخيل الأشكال والأفكار التي تغذيها الحوادث والافعال, بالمقابل لا يمكننا تخيل لوناً غير موجود أو صوتاً جديداً دون السماع أو الرؤية فالضوء والصوت حاستان فيزيائيتان ذات حالات فسيولوجية تقتضي منا فعل المراقب والمطارد الحذر والجريء في محاولة لفهم انفسنا من خلالها لا العكس. يحضرني حوار متناظر مع هذه الفكرة عالق بذاكرتي ولا أتذكر من أي مكان بقي عالقا هناك ولعله قريب من السينما اليابانية أو ربما الكورية فالجدة التي عاصرت شابة مجاعات مابعد الحرب تتذكر رؤيتها للقهوة أول مرة ولكنها لم تكن تملك ثمنها المتضخم مع الحاجات الشديدة والنقص الذي سببته الحروب, فكانت تقول لقد تخيلت أن مذاقها حلو كالسكر, ولكنني صدمت حين تذوقته لاحقا بعد سنوات. يغدو اللون في البصر شاعرا ويتحول فيلسوفا وسيبدو دوما غامضا وعصيا على الفهم يعبر بصمت ويترك في الأحاسيس أثرا كرفرفة جناح الفراشة. يقول هايدغر في كتابه (نظرية الألوان) - (يبقى انطباع الأشياء الملونة في العين مثل تلك التي بلا لون) وهو تعبير كنغري يقفز بين العلم والخيال في اقترابه من الحقيقة وابتعاده عنها, فيبدو مثل وهم حقيقي ولنقترب أكثر من هذا المفهوم علينا أن ننظر لألوان بشرتنا على الدوام داخل فضاءات متغيرة ومختلفة لنكمن لخدعة الضوء للعين في الإشراق والظلمة وسندرك بعدها الإرتباط المضلل للضوء مع الأشياء ما حوله وهي فيزيائية الضوء للبصر التي على الفنان أن يكمن لها فتتباين ألوانه حسب إدراكه لحساسيتها وحساسيته تجاهها. فلو قسنا أمثلة للون في الأعمال ومحيطها الإنساني والفيسلوجي أستحضر لهذا مرحلتين لونيتين في حياة الفنان والنحات الإسباني (بابلو بيكاسو) كانت أولها المرحلة الزرقاء والتي شكلت أولى سنواته في باريس بين الأعوام 1900-1904 واتسمت بالأحادية الزرقاء أو المائلة أحيانا للخضرة حسب تدرجات اللون وأحتياجاته للظل والنور وتحولاته خلالها وربما سيتخللها بعض لمسات النار الدافئة وقد وصمت هذه الأعمال بصوت الكآبة ليس لأن اللون الأزرق كئيب, ولكن لأن بيكاسو رسمه بكآبة عكس بها حالته النفسية أنذاك والتي تضاربت فيها آراء المؤرخين في تحميل حزنه وكآبته لانتحار صديقه (كاسيوس) في باريس أو ربما سنقول ويقول أخرون غيرنا أن التبرير النفسي كان تجربته للفقر النسبي وعدم الاستقرار والحاجة أو زيارته لسجن النساء المسمى (سانت لازار) في باريس وظهرت تصوراته في جزء من أعماله في تلك المرحلة التي أحتوت في معظمها صورا بائسة للفقر والمتسولين والسكارى بالشوارع و الضعفاء والمكفوفين وهو ما أعطانا إحساسا بحزن الأزرق وكآبته. أما المرحلة الثانية وهي المرحلة الوردية وربما سأسميها أنا بفترة الورد المزهرة في حياة بيكاسو (1904-1906), كان قد غلب على أعماله درجات الزهر تميل للإحمرار أحيانا أو إلى الإشراق في اللون البرتقالي المشمس في تمايزه بين ملابس شخوصه وزخارفها المربعة التي تمهد لتكعيبيته أو وضعها في الظل والضوء. وسأعيد صياغة جملتي الأولى هنا أيضا حيث لم يكن اللون الوردي سعيدا أيضا ولكن بيكاسو رسمه بمرح ورومانسية وخفة ربما منحته إياهما (أوليفييه) عارضة الأزياء الفرنسية التي اعتبرت ملهمته في هذه المرحلة وجزءا من مرحلته التكعيبية التي تلت هذه الفترة وعزف فيها ذات النغمة المرحة في مجمل أعماله وعكست شخوصه المرسومة في المرحلة الوردية هذه التأثير بالفرح في داخله عبر شخوص المهرجين المرحين والأطفال السعداء وعاطفة الأمومة وفناني السيرك وهي شخصيات أنتقلت معه لمرحلته التالية التي وسمت بها شخصيته كفنان تكعيبي واشتهر بها. وكما يقال بتعبيرات كثيرة ومختلفة أنه لا يمكننا معرفة النهار إلا من خلال عبوره في ظلمة الليل فهذا هو الضوء واللون الذي يمتلكه كلُ منا ويلونه بهالته الخاصة. ويتلقاه الأخرين ليترجموه بهالاتهم الخاصة.
